اختفاءٌ مريبْ بقلم / ربيع دهام
للمرة الثالثة أرمق، عبر نافذة غرفتي، أوتوستراد وسط المدينة.
السيارات كلها متوقّفة. أبوابُ معظمِها مشرَّعة.
على الأرجح أن شيئاً قد حدث.
لا، بل من المؤكَّد أن شيئاً ما قد حدث. وشيءٌ مريب.
ما هذا؟
كأنما ذئبُ السُّكونِ قد شمَّر عن أنيابه وانقضَّ على قنِّ الإزعاج هذا.
وفي خضَّم عمليِّة الطحنِ والهضمِ، اضطجع في قيلولةٍ لطالما انتظرها.
اعتمرتِ المدينةُ طاقيَّةَ الصمتِ ونامت.
واعتمرتُ أنا حيرتي ورحت أركض نحو باب المدخل.
خرجتُ من البيتِ. قصدتُ شقَّةَ جاري فريد كَشاكِشْ. نقرتُ الجرسَ.
لا أحد يجيب.
حتَّى عمَّته التي لطالما قلتُ لها، كلما فتحتْ الباب بعد طنَّة الجرس بأقل من ثانية: “أتنامين أنتِ خلف الباب؟”، يبدو أنها لم تكن خلفه اليوم. غريب.
استللتُ هاتفي ونقرتُ رقم أختي في العملِ.
الهاتف يرنُّ لكن لا أحد ليسمعه من الجهة المقابلة.
نزلت الدرج إلى غرفة الناطور. طرقتُ الباب.
لا يوجد أحد.
مضيتُ إلى الشارع. رحتُ أبحث داخل السيَّارات عن حياة.
عن ولدٍ. عن طفلٍ. عن رضيعٍ قد لا أراه من مكاني وأنا بعيد.
السيَّارات خالية.
تفحَّصتُ الأفق يميناً ويساراً. وحدها الجرذان المتحررَّة من عبء
الإنسان كانت تعبث في براميل النفايات، وخلف الجرذان راحت القطط الجائعة تلاحقها.
أما الكلاب، الكلاب المسكينة، فلا ناقة لها ولا جمل.
ما هذا؟ هل أنا في حلمٍ؟
هل متُّ ودخلت عالماً موازياً قد بُني خصّيصاً لي؟
ولمّا لم يقوَ عقلي على الفرزِ، أجابتني قدميَّ عوضاً عنه.
فأمرتني بالركضِ. فطفقتُ أركض.
وأركضُ وأركضُ.
الشوارع فارغة. الأزقَّةُ الحزينةُ قد لبست ثياب الحدادِ وراحت تنتظر جحافل المعزِّين.
ويبدو أنها ستنتظر طويلاً.
صرتُ أحدِّق في الشرفاتِ وأصرخ:
“أين أنتم؟ أيسمعني أحدٌ؟”.
ولم يكن ليجيبني صوتٌ. ولا. ولا حتى همسٌ.
وحدها الثياب المعلَّقة على حبال الغسيل يبدو أنها سمعتني،
فأخذتْ تغرغرُ والدمع ينسكب من حرير مآقيها:
“أرجوك! أرجوك يا أخي. قُل لنا أين رحلوا؟”.
لكن كيف؟ كيف لي أن أعرف؟
وإلى قدميّ المتعبتين التجأتُ. فراحتْ تجترُّ المسافات وتركض.
وتركض وتركض.
صالات السينما خالية. البنوك. المطاعم.
محلاَّت البقالة. المتاجر. الأندية. حتى مدرسةِ الحارة.
المدرسة التي فتَّشتها صفاً صفاً، وزنكة زنكة.
ودرتُ حول مقاعدها، مقعداً مقعداً، لأبحث لي من بين الكتب والدفاتر،
وفي الأوراق والملفَّات، على جملةً، أو كلمةً، كُتِبت هنا أو هناك،
قد تفيدني بشيء عن الاختفاء المريب.
لكن لا شيء.
فجأة، أرمق من بعيدٍ، رجلاً شائب الشعر.
يتربَّع كالمتسوِّل على رصيف الطريق.
وكان يحمل بيده كتاباً.
اضحكُ. افرحُ. اقتربُ منه. وأقفُ أمامه كالمسحورِ لا ألوي على شيءٍ.
إنسان! إنسانٌ غيري موجود؟
أنحني. أكاد أضمُّه في صدري.
أتماسك. أتنحنح. وأقطِّبُ حاجبيّ معتمراً وَهرْةَ الملوك.
“سلام يا عمْ”، أقول.
يرفع رأسه من دون أن يرد السلام.
“أين الجميع اختفى؟”، اسأله مجدداً.
ومن دون كلامٍ، يستلُّ جريدةً من الأرض وراءه.
يشهرها في وجهي.
فأقرأ العنوان: ” كائنات مقدَّسة تغزو الأرض. تأخذ لها صرحاً في قمّة جبل الإيمانْ. وهرجٌ ومرجٌ في الحارة، وحجٌّ جماعيُّ للإنسانْ”.
شكرتُ الرجل الصموت الذي يبدو أنه لم يكترث لحضوري أو غيابي،
ورحتُ أركض نحو الجبل العظيم.
الجبل الذي يبعد عن وسط المدينة مسافة خمس كيلومترات.
ولما تكشّفت أمامي قمّته ، ثم منحدره، وبعدها سفحه، بانت أعداد الناس الغفيرة. ألوفٌ كأنها جيوش نملٍ تجتاح مكعّبَ سكّر.
لا بدَّ أن أهل الحارة كلهم كانوا على الجبلِ.
كلُّهم باستثناء ذاك المغفَّل غريب الأطوار. ذاك المدفون داخل كتابه.
أكملت طريقي نحو القمَّة حتى وصلتها.
وهناك، رحتُ أدفع الناس عنّي، لألقي نظرةً على تلك الكائنات.
الآلاف من الأجساد وجدتها تقف في مكانها وتصلّي.
ثم تحني رؤوسها باتجاه مكانٍ واحدٍ.
ولمّا قفزتُ بنظراتي إلى ذلك المكان، كان جُلّ اعتقادي بأنني سأشاهد لا بُدّ الكائنات، ولكنني عوض ذلك، ما رأيتُ، ويا لدهشتي، إلا قشورَ لموزٍ وتفاح. ولخيار وطماطم. ولرمّان وباذنجان. ولبصل وجزر.
خجلتُ من نفسي. ومن أهلِ ديرتي ومدينتي.
مددتُ يدي لأكلّم يد أحد الواقفين أمامي. ولّما استدار نحوي،
همستُ بخجلٍ شديدٍ:
” تعال وبسرعة نزيل القشور عن الأرض قبل أن تراها الكائنات المقدّسة، فتنعتنا بالمتخلّفين”.
ابعد الرجل بحركة محتجّة يدي وقال: “ما بك أيها العبيط؟!”،
ثم أشار بإصبعه نحو القشور، وزجرني غاضباً كأنني ارتكبتُ جريمة كفرٍ:
“تلك هي الكائنات المقدّسة!”.
وقبل أن أتفوّه بكلمة، استلمتْ قدماي عنّي دفّة الكلام،
فأرجعتني خائباً إلى مدينتي، أمتطي حيرتي، وأبحث.
أبحث عن حامل ذلك الكتاب علّني أعثر منه على نطفةِ جواب.

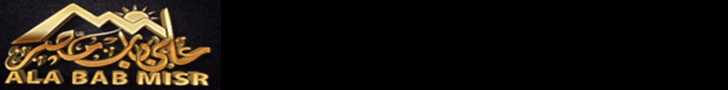

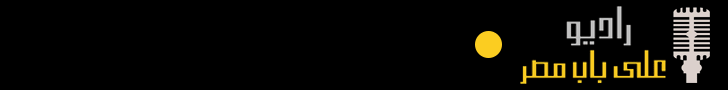

التعليقات مغلقة.