” البيت ” قصة قصيرة بقلم/ربيع دهام
هناك على ضفاف النهر حيث مشيتُ، رمقتُ بيتاً خشبيًّا صغيراً.
لو كان أمام عتبة بابه سجَّادة ترحيب، لتلفَّظت بالكلمات التالية:
” اشلح حضارتك وادخل “.
وجدْتَني أنظر إلى البيت كمن يقف على شرفة الحاضر ويشرع
بمراقبة الزمنِ المنقرض.
لكن لا. لم تكن بساطة ذاك البيت هي التي شدّتني، بل أمرٌ آخر.
كان البيتُ، ويا لغرابة الحدث، يهتزّ ويرتجفُ، كأنّ دوار برد أصابه.
في الوهلة الأولى، اعتقدت أن السببَ هزَّة أرضيَّة.
لا بُدَّ أنّها هزّة أرضيّة.
لكن حين رمقتُ النهرَ أمامي، والحجارةَ التي على ضفافه،
لم أجد شيئاً يدلُّ على حدوث هزَّة، فطار اعتقادي أدراج الرياح.
طار ولم تطر العصافير التي على الأغصان.
وهذا ما أكّد لي استحالة وقوع هزّة.
فَرَكتُ عينيّ وعدتُ وحدّقت في البيت الصغير. ما زال كما كان، يرتجف.
تمالكتُ أعصابي وبحذرٍ شديد اقتربتُ. وما إن صرت أمام عتبة
بابه حتى أسرجت قدميَّ وتوقَّفتُ. ثم رحتُ أراقبُ.
فجأة، سمعتُ صوتاً. همسٌ كأنّه هسيس. ويدخل الهسيس أذني.
ويمسي في رأسي حروفاً وكلمات.
تصيبني القشعريرة حينما سمعت الهسيسَ يقول:
اشلح حضارتَك وادخل.
من الصَّدمة لم أعرف ماذا أجيب.
أهناك أحدٌ في البيتِ؟، سألتُ نفسي. بلعتُ ريقي.
تقدّمتُ بخطوةٍ، فتحتُ الباب ودخلت. وما إن فعلتُ هذا حتى توقّف
اهتزازُ البيت.
فجأة، يُغلقُ الباب ورائي. ظننتُ أنّها الريحُ.
وفجأة، تدخل رائحة الجاز أنفي. ظننتها رائحة وقود موّلد كهربائي.
وفجأة، نورٌ من داخل البيتِ ينبثق.
لحقتُ مصدره فوجدته. وكان المصدر فتيلةٌ تحترق.
وحول الفتيلة زجاجٌ يحمي النار من صفعات الهواء المميتة.
يا إلهي! أنّه المصباح.
استغربتُ الأمر. مَن يستعمل مصباحاً في هذا الزّمان؟
تقدّمتُ خطوةً إضافيّة إلى الأمام.
” مرحبا”، همستُ. لم يجبني أحدٌ.
“مرحبا”، صرختُ. وما سمعتُ إلا قلبي يضرب رأسه بصدري.
عدتُ وناديتُ: ” أمام مِن أحدٍ هنا؟”.
ولمّا لم يجبني أحدٌ، هممتُ بالتقدُّم، مصوِّباً ناظري على لوحةٍ
لفلاحٍ مبتسمٍ يعتمر كوفيّة، ويمتطي حماراً.
ترتطم قدمي بمقعدٍ خشبيٍّ عتيقٍ. وكان أمام المقعد منضدة، وعلى
سطح المنضدة جرن خشبي لطحن القهوة. جرنٌ يسمّونه المهباج.
استغربتُ الأمر. من يقتني مهباجاً في زمن كهذا؟
وأكملت طريقي إلى حيث المطبخ.
استقبلتني وفود الأواني العتيقة. ومرطبانات الكشك والبرغل.
والتين المطبوخ ورب البندورة. واللبنة والجبنة. ودبس العنب.
وفي حجرة صغيرة، شممتُ رائحة خبز الساج والمرقوق وفطائر
البطاطا.
أحسستُ بشوقٍ. بحنينٍ. بحبٍ لهذا البيت الجميل. كادت عيني أن تدمع. سمعتُ في هذا البيت صوت جدّتي. رأيت جدّي وهو يجلس
على مقعد الخشب الصغير ويأكل البيض المقلي والبصل الأخضر.
شاهدتُ أميّ وأبي وأخوتي وعمّي وعمّتي، وخالي وخالتي،
والأصدقاء والجيران، يجلسون حول المصباح، في حلقة دائرية
ويضحكون.
كم أحب الحلقات الدائريّة، حيث لا رأس ولا قدم.
وكم أحسد صاحب البيت هذا.
وفجأة، سمعتُ صوتاً يجيبني: ” إن كنتَ تحبّني، فهذا البيت لك”.
لا أعرف السبب، لكني ما إن سمعتُ هذا، حتى تبدّلت حالتي، وتغيَّر مزاجي. وزممتُ شفتيّ علامة القرف.
أحسست بكرهٍ شديدٍ لهذا البيت.
وفوراً، ومن دون تردُّدٍ، أدرتُ ظهري، وخرجتُ منه على عجلٍ
دافعاً الباب الأمامي بقدمي.
“أين تذهب وتتركني؟”، صرخ الصوتُ الذي ما زلتُ لا أعرف
مصدره.
توقّفت قليلاً. حملتُ جوّالي. ها قد عاد الإرسال. ابتسمتُ. فرحتُ.
نظرتُ إلى الخلف. رأيتُ البيتَ يرتجف.
رأيتُ قطرات ماء تتساقط من شباكه الصغير.
بسخريةٍ قهقتُ. وأكملت طريقي إلى شقتي الفاخرة في المدينة.
دخلتُ الشقّة. أدرت المكيّف والتلفاز. وضعتُ وجبة الطعام في
الميكروويف. ثم جلستُ في غرفتي. استللت من الدرج قلماً وورقة،
ورحتُ أرسمُ ذاك البيت على لوحةٍ.
ورحتُ أكتب في ذاك البيتِ شعراً.
وفي اليوم التالي، دخلتُ الصفَّ، وصرتُ أشرح لطلابي عن مزايا
ذاك البيت. عن بساطته وعفويته. ونكهة أصالته وجماله.
ذاك البيتُ. البيتُ الذي “أحب”

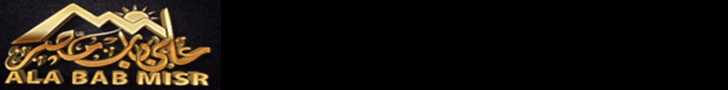

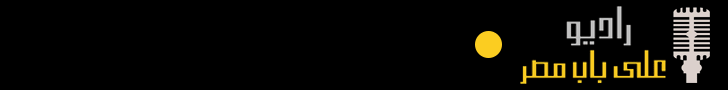

التعليقات مغلقة.