الخوف قصة قصيرة بقلم د. شادن شاهين
كانت ليلةً دهماء، غفلتُ فيها قليلًا، وتقلَّبتُ في الفراش كثيرًا، حتى شعرتُ فجأةً أني عاجز تمامًا عن تحريك نصفي الأيسر، يا له من كابوس ثقيل!
بدأتُ أجد صعوبةً في التنفُّس، حاولتُ أنْ أستيقظ من ذلك الحُلم اللعين، لكن ذراعي وساقي كانتا ثقيلتين جدًّا.
تسلَّل شعاعٌ باهِتٌ إلى الحجرة حين فَتَحَت زوجتي الباب برفق شديد خشية إزعاجي؛ فهي تعلم جيدًا ما قد يصيبها لو أيقظتني من النوم.
حاولت أنْ أناديَ عليها، لكن صوتي انحبس في حلقي ولم يخرج مني سوى تهتهات لا معنى لها.
نظرت زوجتي نحوي بفزعٍ وكأنها لاحَظَت ما أنا فيه مِن قيدٍ على ذلك البرزخ المخيف بين النوم واليقظة، هُرعتْ إلى زِرِّ الإضاءة، فأنارَتِ الحجرة.
حرَّكتُ رأسي، ورفعتُ ذراعي، لكني ما زلت عاجزًا عن الكلام، أو تحريك نصفي الأيسر.
“يبدو أنه ليس كابوسًا”؛ حدَّثْت نفسي مذهولًا!
انسابت من عيني الدموع فجأةً.
مرَّرَتْ زوجتي أصابعَها المرتعشة على خدِّي، تتأكَّد أنَّ ثمة دمعًا بلَّلَها.
صرختْ، وارتمت عند قدميَّ، تبكي وتقبِّلهما، وتقول: “فداك يا رجُلي”!
تبخَّر مِن عقلي ما أنا فيه فجأةً، لم أعُدْ أذكر سوى ما فعلتُه بها عشرين عامًا.
فإخلاصُ مَن آذيته عُمرًا، لهو أشدُّ قسوةً مِن غدر مَن أحسنتَ إليه.
مرَّ شريط ذكرياتي أمامي، رأيتُ عينَيْ أبي الصارمتين الجامدتين المحفور فيهما تاريخُ وهني، بَشَرتَه المليئةَ بالحُفَر التي كانت تشبه طريقي، أنفَه الضخم القبيح كان جبلًا يسدُّ مجرى نهري بعيدًا قبل المصبِّ.
إذا طالعتني عيناه، تجمَّدت الدماء في عروقي، خشعت روحي، كذبيحة مرَّ على عنقها للتو نصلُ جزَّار.
اقتطفني الخوف من طفولتي قبل الأوان، فدعسَتْني أقدامه.
ولم أكن وحدي مَن رآه كذلك، فأمِّي كانت ترتجف حين يزأر فجأةً ويناديها، تُهرَع إليه كجُثَّة أُلقيَت من فوق جبلٍ، فهبطت تتقلَّب بين الصخور والأشواك، لا تحيل لنفسها إمساكًا، ولا لطريقها اختيارًا، وحده الخوف كان يدفعها.
لكنها كانت مضطرةً له، أسيرة اللقمة التي يدفع بها في حلوقنا.
لم تكن أمي من النساء اللاتي تَوَّجهن الحبُّ، لكنها كانت من أولئك اللاتي أذلَّهن العَوَز، ومُتْنَ موتًا بطيئًا في ثلاجة الغربة على فراش بارد، وأُذُن صماء.
كانت العصا هي الجسر الوحيد الذي يربطني به، أو قُل: هي الهوة بين عالمينا.
تعلَّمت منذ طفولتي ألا أقف مكشوف الظَّهر، فثمة ضربة قد تأتيني فجأةً، ومضى العمر بي موليًا ظهري شطر حيطان المدينة، وإن كانت آيلةً للسُّقوط.
تعلَّمت أن أخشى الصوت الأجش العالي، وإن كنت على الحق! فمَن ليس له ظهر، يُضرب على بطنه، هكذا علَّمتني أمي، وهكذا صنعني الخوف.
وعندما فكَّرت في الزواج، اخترت عروسي فتاةً مسكينةً، لا ظهر لها هي الأخرى، لا لأكون ظهرًا لها، ولكن لأجرِّب أن أحتلَّ مرَّةً الموقع الأقوى في هذه الحياة، واثقًا أنَّ غريمي سيَعجِز عن المقاومة.
ومنذ ليلة زواجي الأولى، وأنا أتلذَّذ بتعذيبها، ما أشدَّ متعتي حين كنت أسبُّها بأقذع الألفاظ، وأتعمد إهانتها بلا أدنى سبب! بينما تطأطئ هي رأسها في ذلٍّ، وتختفي من أمامي حين أصرخ في وجهها، أو تنهال كَفِّي الضخمةُ على وجهها الصغير فجأةً.
كنت أعلم أنها لن تتركني أبدًا، فهي أسيرة الفقر – كأمِّي – ذلك المارد الذي يحني الجباه، ويقتُل الإنسانية.
ولماذا لا أكون مخيفًا؟! هل الخوف خُلِق من أجلي فقط؟!
قطع الشريطَ المارَّ برأسي صوتُ نواحها، نظرتُ إليها، كما لو كنت أراها للمرة الأولى، متى داهمت عينيها كلُّ تلك التجاعيد؟! ومتى هزل جسدها حتى صارت عجوزًا على مشارف الأربعين؟!
طالت نظرتي العاجزة لها دون أنْ أعرف ماذا أريد؟! رحمتك يا إلهي!
إلهي؟! متى آخر مرة ذكرته؟! ترى ماذا يفعل بي؟! يدي، تلك الباطشة، ترى لو عدتِ لي، ماذا أفعل بك؟!
ألم تخبريني يا أمي أنَّ الجبابرة لا يسقطون، والضعفاء لا ينتصرون!
سقطتْ قُبُلاتُها الحارة كماء النار على قلبي المفزوع، ولأول مرة أفهم المعنى الحقيقيَّ للرجولة، ذاك الذي لم أَكُنْهُ أبدًا.
وددتُ لو أستطيع أنْ أحتضنها بذراعيَّ، فأضغطها على صدري حدَّ الإيلام.
تمنَّيت أنْ أستطيع أن أرتمي تحت قدميها وأعتذر، وماذا يفيد الاعتذار وقد ابيضَّ الشَّعر، وتهاوت الجفون، وخَطَّ ظُلمي بصمتَه على وجه الفتاة، فأحالها إلى بقايا امرأة!
مضت دقائق كالدهر وهي صامتة، وأنا أداري عيني منها، ولأول مرة أعرف معنى الخجل.
حاولتُ أنْ أفكِّر في القادم، إنْ كان ثمة قادم! لكن عقلي كان معطَّلًا تمامًا، ولا شيء أراه، سوى الحُفَر في وجه أبي، وأمي المتكومة في الزاوية، والعصا… والخوف.

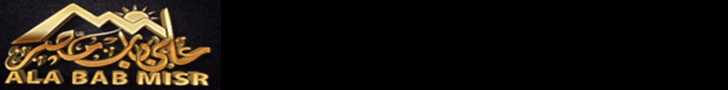

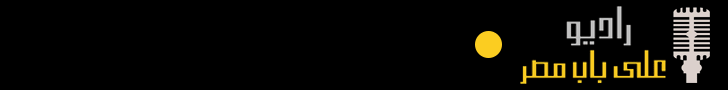

التعليقات مغلقة.