السودان رحلة قصيرة ذات معانٍ جمة_حلقات مجمعة بقلم/ حُـسام الدِّين طلعت.
انتهت بي خطواتي أمام نافذة حجز تذاكر باخرة وادي حلفا، وهو ميناء نهري على حدود السودان الحبيب الشمالية، حيث أنه يُعدُّ حلقة وصل تجارية بين القطرين ( مصر و السودان )، اللذين تفصلهما حدود المكان، حدودٌ رسمها مستعمرٌ بغيض، وتجمعهما حدودُ الزمان والآمان والاندماج والتواصل، ولم يفلح ذاك المستعمر إلا أن يفصلهما بخطٍ وهمي فوق خارطةٍ عرجاء.
……
كُنتُ أحملُ في حقيبتي ملابس وأفكار وآلام وبضع آمال، لذا لم يكترث ضابط الميناء حين ألقى عليها نظرات من التهكم والازدراء والفضول، ثم قال لي: اعب.
صعدتُ باخرة تنطلق من ميناء أسوان النهري، بعد رحلة ليلية داخل عربات قطار القاهرة – أسوان، حيث وصلتُ صباح رحلة الباخرة، وتنسمت هواء أسوان الجميلة، العروس التي تتزين كل حين، وكأنني أنهلُ من عبيرها، وأُشبِعُ روحي وعيني من سحرها الوضاء وحلاوة نيلها، فوجدتها تعجُ بالمسافرين الغادين والعائدين والكثير من الحقائب والبضائع من كل صنف وصنف، لذا لم أجد متسعا من المكان إلا جوار حقيبتي أعلى سطح الباخرة، وانطلقتُ.
أقبع جوار حقيبتي، منغلقا على ذاتي، منفتحا على عالم لا أدري خفاياه، تنطلق الباخرة متمايلة، متهادية.
تحمل قلوبا وقوالبا من بشر نثرت أحلامها هنا وهناك.
ما بين تاجر يحلم بالعودة إلى وطنه، ليبيع بضائعه ويربح ويطعم أبناءه الرزق الحلال، وطالب عائد إلى حضن أمه بعد طول غياب، وامرأة كانت تزور أهلها في مصر تنتحب من فراقهم.
وأنا وسط هؤلاء أقتحم المجهول بلا هدف، وضعت حقيبتي وبدأت أتجول في ردهات الباخرة، باحثا عن مكان أحتسي فيه قهوتي.
وها هو ذا، مكان نظيف منظم، مطعم لركاب الدرجة الفاخرة.
دلفت إلى ذلك المطعم، جالسا إلى طاولتي التي يتشاركها أخوة من السودان أو مصر، أشقاء الوطن المنقسم.
طلبت قهوتي، فسألني النادل: قهوة مصري أم سوداني؟
حقيقة الأمر، أحببت أن أحتسي القهوة السوداني، فقد كنت منبهرا ـ و لا زلت ـ بكل ما هو سوداني.
وعرفت أن القهوة السوداني تسمى ( جَبَنَة) بفتح الجيم والباء والنون.
وهي عبارة عن قهوة سودانية مغلية وبها الكثير من الإضافات كالحبهان والزنجبيل وما لذ وطاب.
……
كان مذاقها رائعا، فما أجمل الجبنة الأولى! فهي كالحب الأول، لا يُنسى.
استمرت رحلة الباخرة حوالي سبع عشرة ساعة، حتى وصلنا إلى ميناء وادي حلفا السوداني، وخلال تلك الساعات كان لابد من التواصل والتعارف والبحث عن رفقاء الطريق الذين يضفون بوجودهم يسرا لسفر طويل، وخلالها أيضا ناجيت نجوما ترافق باخرتي وقمرا سابحا في أفق عيني.
ونيلا حاضنا أمانينا، نيل حنون، يحتضنُ أحلامنا.
وادي حلفا: ميناء نهري شمال السودان الحبيب، بعد وقت مر في تفتيش حقائب الركاب، عانقت بعيوني سماء تلك المدينة الهادئة الساحرة، مدينة وادي حلفا، كان رفاق الرحلة متجهين نحو عربات جيب تحمل ركاب الباخرة إلى منطقة الفنادق،
فالتحفتُ بإحدى صناديقها القديمة، ووصلت بعد أقل من عشر دقائق.
أقف الٱن أمام فندق لكنه أشبه ببيوت النوبة الجميلة الممتلئة بالدفء وطيب الروح، طابق أرضي به الكثير من الغرف، وتصطف في كل غرفة الكثير من الأَسِرَّةِ.
قمت بحجز سريري واغتسلت من عناء السفر، كنت أتمنى ألا أضيع لحظة أمتع فيها ناظري بكل ذاك الجمال البكر، تلال وهضاب وبيوت متراصة، البساطة سمة كل تفصيلة، لذا بدأتُ جولتي الميدانية مشدوها، منسجما، ممزوجة عيني بكل طيب.
أحببت أن أتناول غدائي، وما أشد تشوقي لأن أتذوق الطعام السوداني، لذا دلفت إلى مطعم بسيط تنبعث منه روائح أشهى المأكولات، التي لا أتذكر إلا بعض أسمائها، على سبيل المثال: سلطة أسود، وهي عبارة عن- مسقعة- لكنها تختلف في الشكل والنكهة عن الطعم المصري، وأثناء بحثي عن مكان لتناول جبنتي ( قهوتي السودانية). لفت انتباهي امرأة يرسم الزمن على جبينها خطوطا من الكفاح والشقاء والرضا، هي بحق مثال المرأة العظيمة، التي يُهدَرُ حقُها في مجتمعنا الشرقي الجاني عليها، الٱكل حقها، المضيع قدرها، ويتناسى ذاك المجتمع أنها حواء، الأم والأخت، والابنة والزوجة، والحبيبة والصديقة..
إنها نعمة مهداة لٱدم وأنسه.
وهي الموصى بها من سيد الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عندما تصل إلى وادي حلفا، يتوجب عليك أن تقوم بحجز تذكرة الحافلة المتوجهة إلىٰ الخرطوم فجر اليوم التالي للوصول، وقد أرشدني بعض الأخوة السودانيين إلى ضرورة حجزها فور وصولنا.
بدأت رحلة الحافلة في الخامسة والنصف صباحا، تنهب الأرض نهبا بين البراري والمناظر الطبيعية الخلابة، وبدأتُ بالاستمتاع بجو سوداني عبق مملوء بروائح البخور المميزة، وعطور تفوح نسائمها من قلوبهم قبل الثياب.
تعرفت على شاب سوداني، تكسو ملامح وجهه أصالة شعب، وعيونًا مُحِبَّةً تتمنى الخير للجميع، يُدعَى عبدالرحمن، حقا إن للإنسان نصيبا من اسمه، فقلبه مملوء بالرحمة والود.
تعارفنا أكثر خلال وصولنا إلىٰ استراحة الحافلة، وعرف أنني أتيت إلى السودان لأبحث عن ذاتي التائهة في طرقات الحياة البائسة، وأنني سأبحث عن عمل وسألته عن السكن، فقال لي: لا تحمل هما للمسكن، فهو موجود وميسر بإذن الله.
وصلنا حوالي الساعة الرابعة عصرًا إلىٰ الخرطوم.
وبدت كفتاةٍ تُسحَرُ الناظرين، وظهرت مثل عروس النيل تتزين لأجل محبوبها.
إنها المدينة الأجمل، والأهدأ رغم ازدحام بعض أماكنها، وبدت تشعرني بلهيب صيفها، وكأنها تستقبل محبيها والغائبين عن دفء أرضها بشمسها اللافحة المانحة القوة والجلد؛ لذا لم أتأفف من هديتها قط، وإنما توقعتها لأنها أرض الكرم والكرماء.
طُفتُ في أرجائها من الأسواق المميزة التي كنت أسكن قربها في منطقة بحري، حيث أوفى رفيق الرحلة بوعده وأسكنني مع أقارب له من الشباب المغترب لأجل الدراسة ( الجراية بالسوداني) والعمل والبحث عن لقمة العيش قريبًا من سوق سعد قشرة ( سعد غشرة)، وهو سوق للذهب القشرة والمنتجات المتنوعة والمحال بكافة أشكالها.
وفي المساء مع الصحبة، تجتمع بالأحبة عند ( سِتَّ الشَّاي) التي تصنع لك كوبًا من النسكافيه والأغرب أنك يجبُ أن تتناول معه الزلابيا الشهية التي تغوص في بحر من العسل.
أما عن جولتي الصباحية في شوارع الخرطوم الأبية، دائمة التبسم وتوهج شمسها المتمازج في بشرتهم المنسوجة من طمي النيل جذب انتباهي مطعما للوجبات السريعة، ووجدتُ في قائمة الطعام أنَّ سندوتش البرجر ثمنه ٣.٥٠ جنيه سوداني، فطلبت واحدا، وفوجئت أنَّ الخبز كبير ومملوء باللحم، عُدتُ أبحثُ عن عمل أثناء النهار وفي الليل إما على مقهى من المقاهي الإلكترونية أو مع الصحبة الطيبة.
صباح جديد يملؤه النور والخير من رب الوجود، استيقظت إثر نسمات هواء صيفية داعبت روحي، وكنت نائمًا فوق سرير معدني في أحد أحواش البيوت السودانية الواسعة، ومن عاداتي الصباحية أن أُفَرِشُ أسناني، ولكنني اكتشفتُ أنها عادة أصيلة عند أبناء النيلين، وبدأ شباب البيت يستيقظون كل يحمل فرشاته وتناولنا الإفطار سويا. وبعدها انطلق الشباب إلى عملهم كالطير التي تغدو ساعية لرزق ربها، فتعود بطانا.
وبدأتُ رحلتي اليومية في البحث عن عمل، وكنتُ ذا خبرة ودراية بمجال التسويق، لكن لم يوفقني الله في إيجاد فرصة عمل في ذلك المجال، وبدأتْ الأموال التي أحملها في النفاد،
ثُمَّ طرأت بعض الأحداث على الصعيد السياسي بين السودان وجنوب السودان حيث سمعتُ أن الأخيرة قامت بالاستيلاء على بئر بترول داخل الحدود السودانية، وعند اندلاع أي صراع بين دولتين تتأثر اقتصاديات تلك الدول أطراف النزاع، لذا بدت الأجواءُ تلوح بقرب انتهاء رحلتي، وقلتُ لنفسي: من الأفضل أن ينفد المال الذي أحمله وأنا على أرض مصر؛ لذا أخبرت أصدقائي الذين أقيم معهم أني نويت العودة، وكنتُ أود أن أظل بينهم، أنعَمُ بودهم وأنهلُ من طيبِ برِّهم، لكنها الأقدارُ تكتبُ خطواتنا.
أخبرتُ صديقي عبدالرحمن بذاك القرار، وقال لي: إن شئتِ اصبرْ حتى تجدَ عملًا، فأنت أخٌ لنا وضيفنا، لكنني شكرته من أعماق الفؤاد على ما قدمه لي هو وأقاربه الكرماء، ولفتَ انتباهُهُ أثناء حديثنا الأخير تَغيُّرِ لون بشرتي إلى اللون الأسمر، وتعلُّمِي لبعض كلمات اللهجة السودانية. فقال لي مبتسما ابتسامة صافية: لقد أصبحتَ (سوداني يا حسام)
فرددت عليه مازحا: طبعا يا زول، وتعالت ضحكاتنا.
وللرحلة بقية…

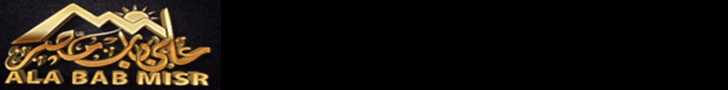

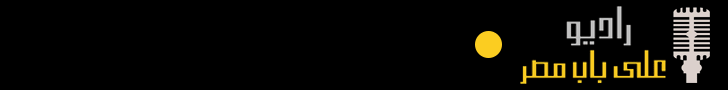

التعليقات مغلقة.