“اللعبة.. مراوحات العالم السَّردي” بين “الأنسنة” و”الميكنة” رؤية نقدية لحسام عقل
” قريبًا “
رواية ” اللعبة ” للأديب محمود حمدون
دار المفكر العربي القاهرة 2021
بخطوة وئيدة، بادية الرسوخ، يجتاز الروائي المتحقق “محمود حمدون” رقعة شديدة الفرادة من مشروعه القصصي الصَّاعد، حيث يراوح في تخليق عوالمه القصصية بين (الداخل) بخبيئته المسكونة بتدفقات اللاوعي وتدافعات الحلم (أو الكابوس)، وبين (الخارج) الموارى بالرؤى والأقطاب والصِّراعات، التي أشعلتها لحظة عربيِّة وعالمية، أقل ما يُقال فيها إنّها “مأزومة”.
جاء نص “اللعبة” مستوفيًا الاشتراطات الجمالية والفنِّية والبنيويَّة، التي نأنسها في الأعم، في “النوفيلا”، بتقطيرها وتكثيفها وطرائقها التقنيَّة الخاصة في تشكيل المشهد ورسم الشخوص وإنماء الأنسجة والخلايا السردية، طورًا طورًا. وكانت أطر “النوفيلا” وسماتها هي الأوفر ملاءمة، بمساحتها الوسطيّة، لهذه التجربة فيما أرى، وكان بمقدوره الامتداد بها وإطالة النَّفَس الكتابيِّ، لتستوي “رواية” ولكنه، لاعتبارات فنيَّة، لم يفعل.
ويمكن للرؤية النقدية، التي تتخلَّق على حاشية هذا النصِّ، أن تتفرع – تشعُّبًا- في عدة مسارات، قد تشارف، هاهنا، أربعة مسارات جذرية في مقاربة النصِّ وفهم عوالمه، واستكناه رسالته الفنيَّة والحضاريَّة.
فثمة مسار نقدي يفضي بنا إلى جسم السَّرد، تواشجاته الدالَّة مع لعبة التوقع المؤسَّسة على سبيل التكهُّنات والفروض.
وثمة مسار نقدي ثانٍ يتلامس، بالضرورة، مع عملية التشخيص (أو رسم الشخوص) في إطار قطبية “ثلاثية” تفضي بنا إلى “فؤاد” و(هيام) و(علي)، وخلفية مباطنة التشخيص، يشغلها (الجد) (الذي آثر الراوي تجهيل اسمه ليصبح محض معادلة خلفية مقطَّرة/ مفردة).
وثمة مسار نقدي ثالث يتحسَّب في تشعُّباته وامتداداته، لـ(الجملة الحوراية)، بأدوارها الفنيَّة المتغلغلة، في التحريك الدينامي المفترض لحركة الشخوص وصراعاتها، إيقادًا لجذوة الدراما، وإشعالًا لفعل السرد النامي الممتد.
وهنالك، في التصوُّر الأخير، مسار نقدي رابع، منوط به تقصِّي الموجات السردية المتحركة، بتوازن ملحوظ، بين (الخارج) و(الداخل)، بخلفيّاته المباطنة، حيث تلاحظ لدينا أنَّ المسارات والرؤى السَّرديَّة، التي انتثر سلكها بين العالمين: الداخلي والخارجي، قد خلصت، في خاتمة الأمر، للعالم (الداخلي) بكل حدوسه الصوفية والذاتية في إطار مفاجأة “رحيل عليٍّ” التي فجرها الراوي في النهاية، بصورة مباغتة، صادمة، دالَّة!
وقد أمكن هيكلة هذه العوالم السَّردية – بمعمارها الفسيفسائي الدَّقيق – مع صراعات اللحظة الحضارية، ضمن ما سماه علماء النصِّ “شروط الملاءمة” (وفق مصطلح ج. أوستين).
تشابكت وتناسجت الخيوط بقوة، بين تموُّجات الجسم السردي، أحداثًا ووقائع، وبين عملية التشخيص، في المجمل، حيث جمع المستويين لعبة مناورة (أفق التوقُّع) التي ألحَّ عليها “نقد استجابة القارئ”. وتدريجيًّا تحولت لعبة “مناورة أفق التوقُّع” إلى (كسر صريح معلن) لأفق التوقع – كما سماه “هانز روبرت باوس” – فلم يدر بخلدنا، نحن القراء، أن نرتطم في الخواتيم والانتهاءات النصيَّة، بلوحة (عليّ) مثبتة على الجدران، يقطعها (شريط أسود) بما يشي في الدلالة الضمنيَّة برحيله!
نثر لنا الراوي، في خطوة الاستهلال التمهيديَّة، حزمة دالَّة من الجمل/ المفتاحية، تحوم جميعها، على فكرة (اللعبة) المنقادة لقبضة صاحبها ذي الشكيمة، ثم لا يلبث الراوي أن يفتح ثلمة في جدار السَّرد، يصدر من خلاله شكًّا إلى القلوب، باحتمالية التمرُّد المعلن للعبة على صاحبها، الانتفاض الجسور ضد إرادته!
وفي انعطافة، قائمة على فكرة التوسعة الرمزية لأبعاد التيمة ومداها، يطرح الراوي إمكانيَّة أن تكون “اللعبة الحاسوبية، التي تتلاعب بالأحداث والأطراف، واسعة رحيبة بأكثر مما نتحسَّب أو نظن، فهي دائرة مترامية تنداح تدريجيًّا لتشمل الحياة بتمامها، حيث تضحى الحياة لعبة ماموثية ضخمة”، فما الحياة بجدِّها وقسوتها، سوى لعبة كبيرة..
قدح الراوي شرارة السرد في حاضنته فكرة “التجييل”، فتواثب بالرؤية بين جيلين متناقضين، كأشد ما يكون التناقض: “جيل الجدِّ”، بمسلَّماته ورؤاه، وجيل “الحفيد”، بحِسِّه التَثويري وفيض أطروحاته ذات المنحى الابتكاريِّ.
وبدا واضحًا – في صدر النصِّ وخاصرته – أنَّ “فؤاد” (مُصمم برامج الكمبيوتر)، يعاني من تغلغل أدوار الجدِّ، الذي يبسط مظلَّة (عملاقية)، لا يدع معها للحفيد ثقبًا للاختيار أو الحركة شبه المستقلة، بدءًا من اختيار اسمه، وصولًا إلى مصادرة خياراته ورؤاه. ولعله ليس من الشطط أن نرى أنَّ سجالات الجد والحفيد هنا، ليست ببعيدة، في صراعاتها ومناوراتها الدَّالة، عن صراعات شبيهة – مع الفارق في الرؤى والمنطلقات – اشتممنا رائحتها بين “علوان فوّاز محتشمي” الحفيد، و”محتمشي زايد” الجد في الفريدة السردية المميزة “يوم قُتل الزعيم” لـ “نجيب محفوظ”. وإذا كان “محفوظ”، بدوره الريادي المتشعِّب، معبأً بهاجس “التجييل” المرتبط بتحوُّلات الانفتاح السَّبعينيِّ، فإن “حمدون”، متماهيًا مع المنطلقات (المحفوظية)، قد ناله أثارة من فكرة “التجييل” ذاتها، بعد أن غرس بذرتها، بصلابة، في فضاء التحوُّلات المرتبطة بالألفية الميلادية الثالثة، لاسيَّما ما اتصل منها، بالفضاء الافتراضي، وواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وتغلغل المكوِّن (الحاسوبي) في تيَّار الحياة اليومية.
وبشكل كنائيٍّ دالٍّ، بسط (الرَّاوي) أزمة تغلغل دور (الجدِّ)، وهيمنته (البطريركية) على هذا النحو، المترع بدلالته الفاجعة:
“.. عائلة صغيرة دون جذور أو فروع، كما نراها في العائلات الأخرى، كأنما نبتت فجأة، وقامت على كتف الجدِّ دون أحد سواه..”
ولا يبعد أن يكون هذا الإنعاش الواضح للسمة الجسدية في رسم الشخوص، مرتبطًا في الجوهر، بالدلالة الرمزيَّة، في التضخم (المعنوي) للجد، حضورًا ودورًا ونفاذًا:
“.. كان الجد طويلًا بإفراط غريب، حتى تراه يُقبل عليك من بعيد منحنيًا في سيره”..
وإذا كان الجيلان: الأكبر والأصغر، قد جمع بينهما بجامع التناقض والمنافاة، بل الصراع المعلن (الصريح)، فإن الجيل الأوسط (أعني الأبوين)، لم يتطرق الراوي إليه، أو يأتِ على ذكره إلاّ في سياق أزمة الاغتراب الشامل:
“تغرَّبا طويلًا وراء لقمة العيش، سنوات كثيرة باعدت بين “فؤاد” وأبويه، فعاش بكنف جدِّه لأبيه..”.
وقد أضاف الراوي إلى تدفقات الجمل الحوارية، الدائرة بين الشخوص، فكرة “الهاجس” الملحّ بحِسِّها الفانتازيِّ وأبعادها الغرائبيَّة، وعراقة ارتباطها الحميم بالمخاوف الداخلية ذات الرفيف النفسي المتصلة بـ “صوت الداخل”.
“.. هاجس يهزُّه بعنف، يجذبه من شعر رأسه، قائلًا بصوت خشن غليظ: يا فؤاد أنت لم تكن يومًا من الأيام إلا طرفًا بلعبة كبيرة تدور حولك أو بك..”.
ضَمِن السَّرد بضمير الغائب “Third Person” سَقفًا شبه موضوعيٍّ للعملية السَّردية، لكنَّ الراويَّ أضاف لهذا الفضاء الموضوعي، ملمحًا حلميًا رفَّافًا (يكاد يدنينا من النثر العرفاني!)، حين ابتدع فكرة (الطائف) الذي “يزور الشخوص ليلًا”، وهنا تتفتت الصَّلصلة الجرسيّة التي ارتبطت بجلبة (الخارج)، بهمس إيقاع داخليٍّ مبهم خفيٍّ، خلقته توترات (الداخل)، بأشباحه الراقصة المهاترة، وعوالمه اللَّاوعية الملغزة المتداخلة.
بدأت لحظة المراجعة والتحوُّل، من خلال التشذيب الفنيِّ، الذي خلق من خلاله الراوي مونولوجات داخلية مطوَّرة، فتناثرت أشكال (نجوى الذَّات) ضمن حوارات معمَّقة أدارها “فؤاد” مع ذاته:
“.. كيف تعرف أنك حيٌّ.. أنك لست عنصرًا داخل لعبة أكبر.. ثم كيف بلغت بك الثقة حدًّا أن تتصور أنك موجود.. لم لا يكون كل ذلك وهمًا، وأن الحقيقة غير ذلك بالمرة..”.
(وكان منطقيًّا من الوجهة الأسلوبية – التخلُّص من علامات الترقيم في المونولوج)، فتواصلت بؤر الأحداث الجزئية، في التجربة، مع بؤرة حدث أساسيَّة تمثَّلت، في واقعة مسح (قواعد البيانات) من أجهزة الكمبيوتر الرئيس بالشركة، التي يعمل بها “فؤاد” بما ألحق بقواعد البيانات وحسابات العملاء وأرصدة الشركة، ضررًا بالغًا، وحامت الاتهامات، قبل أن تتحدد بصورة نهائية، حول “فؤاد”، وهو ما عززه مدير الشركة حين جزم، في جملة حوارية مقتضبة، بتورُّط “فؤاد” وضلوعه في الأمر بحسم: “هو فؤاد لا ريب!”، وسيتلاحظ لدينا في استراتيجيات توزيع الجمل الحواريَّة، أنَّ الرواي لجأ في صدر النصِّ – وخاصرته إلى حد بعيد – إلى الجمل الحواريَّة المعزولة الدالَّة، مثل قول مديره في العمل، بمنحاه الجبري الحاسم: “.. مثلك ليس له مكان بيننا..”، وبذا وجد “فؤاد” ذاته مهروسًا – حد الاهتراء – بين شقي رحى: “الاستقالة” أو “إحالة الموضوع برمته للنيابة العامة”، ومن ثم كان الوصول الحتمي إلى منطقة البتر الكامل من السياق الوظيفي، ضمانًا لسلامته الشخصية لتستحكم العقدة الدرامية باستعصاء.
وهنا نتأكد أن السنوات الثماني، التي قضاها “فؤاد” في المجتمع الوظيفيِّ، لم تشفع له، وإن استمر معه خيط سرمديٌّ ممتد، جذَّره الراوي بتمكن وحسم وتمثل في احتفاظ “فؤاد” بقدراته المجلية على “تصميم الأبعاد متعددة المستويات” على نحو ارتبط بالاجادة التامة للغات “الذكاء الاصطناعي”.
ألقى الراوي بحزمة كثيفة من الأبنية المجازية، التي طرحت على الفضاء الأسلوبيِّ، ظلًّا مصاحبًا من (فكرة الميكنة)، التي تهيمن، بنسقها الرقميِّ، على مصائر الشخوص وممارساتها، حتى ما كان منها يوميًّا، فـ “فؤاد” مثالًا: “.. يومه دقيق كساعة سويسريَّة يبدأ في السابعة صباحًا..”
وقد تضافرت هذه الإطاعات، بصورة مكثَّفة لتصدِّر للمتلقِّي، انطباعًا جاثمًا بأزمة “الميكنة”، التي تطبع شريحة رحبة من حياتنا، اتساقًا مع ما سماه “توماس فريدمان” – أحد أهم منظِّري العولمة- “عصر القطيع الإليكتروني”.
وعند هذه الحافة المسنونة من حد الأزمة المدبَّب، تتأكد بؤرة الصِّراع في التجربة القصصية، فثمة قدر من المآلات الرقمية القائمة على الآلية والميكنة، ويمثله أجروميَّة تشكيل الشخوص “فؤاد” مصمم برامج الكمبيوتر ويوازيه أو يناصيه -في المقابل– قدر الحالة الإنسانية والرومانتيكية الموارة، ويمثلها في النسق الوظيفي البنيوي للتجربة “هيام” و”عليّ” (قبل رحيله).
ويشتبك القدران: الرقمي والإنساني بموازاة التَّنامي التدريجيِّ في أبنية السرد وصراعاته المتقاطعة وأجرومياته.
وعند هذا الطور من تنامي التجربة السَّردية، يتقاطع النصُّ مع شريحة دالَّة من “أدب الخيال العلميِّ”، وإن لم يكن النصُّ في المجمل نموذجًا لقصة الخيال العلمي، وتتمثل هذه الشريحة (الجزئيَّة) في استدعاء فكرة مطروقة عربيًّا (كما نجد عند نهاد شريف)، وعالميًّا (كما نلمح لدى “إيزاك أسيموف”)، أعني فكرة “الروبوت” الذي انتفض ناقمًا ضد مبتكره، تمرَّد عليه ليصنع مصيرًا، مستقلًّا عن قبضة مخترعه وصانعه!
وتحل هنا فكرة (اللعبة الرقمية الحاسوبيَّة)، التي نصبح جميعًا عرائس “ماريونيت” بين أناملها، محل فكرة (الروبوت) المتغلغلة في السرد الكلاسيكي، حيث يشرع “فؤاد”، بعد احتدام معركته مع إدارة الشركة، في “البدء بمشروع كبير، تصميم لعبة عالية المستوى، يستقل أطرافها بوعي شبه كامل، وبقدرة على القرار والحركة بعيدًا عن المصمِّم”!
واللعبة مستحكمة الحلقات، هنا، لا يقع ضحيتها، كفريسة سائغة، “عليّ” أو “هيام” وإنما يمكن أن يقع ضحيتها مؤسسات وشركات ومنظمات (إقليمية أو دولية)، ربما (دول) أضحت تعاني من التلاعب بالبيانات واختراق الأنظمة الرقمية! وعند هذه الرقعة المنماة من تطور التجربة، يقفز الراوي – بمداراته السَّردية – من (الخاص) إلى (العام)، بانخطافة لا تخلو من البراعة.
وقد تيقّنا أنّ لحظة وفاة “الجدِّ”، كانت منذورة – في مسارات السرد ومنعطفاته -، لتكون لحظة التحوُّل الشَّامل في حياة “فؤاد”، صناعةً لفرادة العوالم، تخليقًا مستقلًّا للمصائر (ومن الملحوظ أن “النوفيلا” تشتغل على التحوُّلات شأنها شأن الرواية).
وعندما بدا لنا أنَّ “فؤاد” قد تحرَّر، إلى الأبد، من مظلَّة الجد وشبحه الوصائي المنوط بدور “الرقابة”، لاح لنا – في الآن ذاته – أن العوالم التي استقل “فؤاد” بتخليقها في إطار فكرة (اللعبة)، قد سقطت في فخاخ التشفير الشامل، فأصبح لكل (حدث) أو (شخص)، “معادل رقمي” منضبط في إطار فضاء رقميٍّ ضخم يتصدره رقمان: “الصفر” و”الواحد”!
وباستبارنا الدقيق لخرائط تشكيل الشخوص في النصِّ، سيتلاحظ لدينا أنَّ “الموقعية القطبية” يشغلها – في منظومة الشخوص – “الحفيد” “فؤاد” و”الجدِّ” (مجهول الاسم)، قبل أن يعيد الراوي قلب الطاولة، وتغيير الوظائف والمواقع والحسابات المرافقة لحركة الصراع، حيث يتبدَّد “الجدُّ” من رقعة اللوحة بالتلاشي التام، لتخلو الموقعية القطبية، في خرائط الشخوص، لـ “فؤاد” – مصمم اللعبة – و”عليّ” (ضحيتها!)، مع فخ مصاحب لشخوص ارتقى بعضها لقالب “الشخصية الثانوية” المسطحة الستاتيكية، مثل “هيام” وارتقى بعضها الآخر لقالب الشخصية “الديكورية” مثل “البائع الجوال”.
ولم تكن عملية التشخيص، فيما أرى مشدودة إلى (التأطير الحسِّي) المعهود، بل أزاحها الراوي، في كثير من الأحايين، إلى مربع “التوهّم والظلّال”، فقد بدت “هيام” في بعض المشاهد، شبحًا يرفُّ من بعيد، دون تحديدات صارمة مؤطَّرة، وهو ما يعني – في نسق التشكيل الفنِّي – احتفار مساحة “تخييل” لاهبة، في التصوُّر والرؤى، تستبطن عمق اللاوعي، وتتغذى من أنساقه وأخيلته، خطوطه المائعة المتداخلة (ربما السيريالية!)
وإذا كان رسم الشخوص يبدأ، في الأعم، من لحظة حسِّية، كتصوير لـ”هيام” في مستهل ظهورها: “بيضاء شاحبة كلون الشمع، ينتشر بوجهها نمش خفيف، يضفي عليها جمالًا غامضًا..” فإن هذا الاستهلال (الحسِّي) الشاحب، لا يلبث في احتدامات التطوُّر الدراميِّ، لاحقًا، أن يشتبك بأفق التوهُّم، لتبدو “هيام”: “كشهاب سريع..” – بتعبير الراوي – وكأنها كتلة متَّقدة غامضة من الإضاءات الموحية، قبل أن تتمرَّد – في انتفاضة وقتية – على كونها “لعبة” تفتقر إلى الكينونة والحضور الغائر الملموس، حين تستدير صارخة في وجه “فؤاد”: “أكنت تتخذني لعبة بين يديك؟”.
وعند هذا الملحظ الفنيِّ، تلوح لنا براعة الراوي في امتطاء المعجم “Diction”، بالنظر إلى تعدد المستويات الرمزية، والتنوُّعات المعجمية لدالّة “اللعبة”.
لقد ألفى “فؤاد” نفسه، بعد حشد من الصراعات، محوطًا بأطر مسيَّجة من الاتهامات، ولم يسلم من اتهامات رفيقة العشق والرحلة “هيام”، بأنه أنتج “لعبة أـو برمجية، دون قصد محت قواعد بيانات الشركة”!
وسيتلاحظ لدينا أن هذه الاتهامات تجسِّد، في مستواها الرمزي الأعمق، غُصَّة في الحلوق لدى شريحة شعبية واسعة، تتهم “العلم” – ويمثله هنا “فؤاد” – ببرمجياته ورقميته وتطبيقاته التقنية المنضبطة، بأنه أصلح متنًا وأفسد في الآن ذاته متنًا آخر، ببروز آثار جانبية لم نعمل لها حسابًا!، ولا يخلو هذا الاتهام الانطباعي/ الشعبي، بطبيعة الحال، من “نوستالجيا” متدفقة تستعيد (الريف القديم)، ببكارتها ونقائها وحُسنها الطبيعي غير المجلوب بالنظرية والافتعال، وهنا تظهر – مجدَّدًا – صورة “الجدِّ” ورمزيَّته في لعبة التوازنات داخل بنية النصِّ.
لقد آثر “نجيب محفوظ” في: “أولاد حارتنا” – في الخلاصة المصفَّاة لرسالته – أن يجعل من “عرفة”، الذي يمثَّل في اللعبة الرمزية قوة العلم، الفارس المنتصر، بصورة حاسمة لا تعرف التلعثم، فجعله يطلق النار على “الجبلاوي” في دفع بالمعادلة إلى حوافِّها المتفجرة شديدة الوضوح، فيما فضَّل “حمدون” أن يجعل “من اللعبة الحاسوبية” العلمية هنا ذات وجهين، قائمين على التأول والافتراض وإطلاق التكهُّنات دون حسم!
وفي المتون السَّرديَّة الكلاسيكية، طرح المبدعون – في أدب الخيال العلميِّ – فكرة “الروبوت” المتمرِّد على صاحبه، فيما طرح “حمدون”، هنا، فكرة “اللعبة” التي “تكتفي بنفسها عن صانعها”، ثم تقصَّى الخيط – حتى نهايته- متتبِّعًا الآثار والتداعيات الناجمة عن هذا الانفلات الشامل، حتى ندفع باللعبة من خلال أزرار “الكمبيوتر”، ثم نفاجأ بأن اللعبة، من حيث لا ندري، هي التي تدفعنا وتشدُّنا إلى المصائر المجهولة، والفضاءات السديمية غير المحدَّدة! فلا ندري، في كثير من منعطفات السرد وثنيَّاته المجهولة، من الذي يدفع الآخر، ومن في الكلمة الأخيرة هو من يقرِّر المصائر، ويُشكِّل تحوُّلات المستقبل الفارقة!
وفي الثلث الأخير من النص نقل الراوي حركة الأحداث ومسارات التجربة، إلى مربع (التأمل الذهنيِّ)، محوِّمًا حول فكرة “تمرُّد الآلة”، فبدا السَّرد مشربًا بالمخاوف، مهتزًّا بعنف تحت وقع الأخطار المحدقة، التي تلتف بأذرعها المتخابثة لتحكم طوقها حول أعناقنا دون ترفُّق، بعد أن وثقنا بقدراتنا بأكثر مما ينبغي!
ويزيح الراوي طرفًا من الأستار، كاشفًا عن سؤال أونطولوجي نافذ، هل سيغدو العالم أكثر سعادة وأوفر اطمئنانًا، إذا أصبح ما حولنا، ومن حولنا “مجرد شفرات” بتعبير الراويِّ؟! وهل هذا التشفير الشامل للحجر والبشر والمعاني، من خلال ملفات وأقراص مدمجة، هو ضمانة السعادة و”اليوتيوبيا الجديدة”؟!
وينتقل الراوي، هنا بحشد من الحيل الماكرة والآليَّات الفنيَّة، من منطقة (ميكنة الشخوص) إلى مربع (ميكنة المفاهيم)، متسائلًا: هل يمكن أن يكون مفهوم (الحب) ذاته: “محض آلية مطمورة بالفرد”؟! ومن الملحوظ أن الجمل الحوارية اللاذعة، في مساحة الختام، لا تصك إجابات، بصورة دوجماطيقية متعجِّلة، قدر ما تشق فضاءً مضاعفًا لمزيد من التساؤلات التي لا تسمح لذاتها برفض العلم وتطبيقاته، تحت أية ذريعة، قدر ما تفتح مسربًا – أو مسارب – تأكيدًا على فكرة “الرقيب الأخلاقي”، الذي ينحاز لكرامة الفرد ووجوده وحيثيته، في وجه التحوُّلات الرقمية التي لا معدى عن قبولها، ولا مفر من تعبيد الطريق وتوطينه لحركتها المستقبلية، ذات المنحنى الحتمي.
وبقدر من فلسفة “الفلاشباك” – استرجاعًا لصورة “الجد” مرة أخرى – يتضح لنا المغزى الرمزيُّ الشامل من وجود “غرفة فؤاد” إلى جوار (غرفة جدِّه) في البداية، وكأن الراوي يقول لنا، من طرف خفيٍّ، إنه إذا تحتَّم أن تبتعد (غرفة الحفيد) عن (غرفة الجد)، بمسافة تَمَدين وتحضُّر وأمان، فإن هذا الابتعاد لا يتعيَّن أن يكون (قطيعة ابستمولوجية) شاملة، تبتر كل الخيوط، وتنهي كل صلة، وتعفِّي على كل أثر، ليبدأ “الحفيد” ملحمته الرقمية الجديدة من نقطة شاردة في الفضاء.
إن البرمجية أو “اللعبة” واقع حتميٌّ، قادم على الطريق، لا نرفضه ولا يخطر على بالنا أن نخاطر بإعاقته، أو عرقلته بطريقة خرقاء تعادي معنى “التنوير” وتُفقدنا ثمار التقدُّم المؤكَّدة، لكن سؤال “عليّ” يصك مسامعنا، قبيل النهاية وهو يهمس لذاته في أقوى مونولوجات النص وأدلِّها:
“.. أترى “فؤاد” استغلني منذ البداية، فجعلني فأرًا لتجاربه؟!..”، هنا تتأكد أدوار النخبة، في تحويل (الإنسان) إلى (مستفيد) من التقدُّم، يغترف من ثماره، ويرفل في نتائجه، وينعم بتطبيقاته العلمية، دون أن يتحوَّل إلى (فئران تجارب) مهينة، بتعبير “عليّ” في آخر انتفاضاته قبل الرحيل!
وقد كان التحوُّل بالغ الدلالة، ففي اللحظة التي تخايل فيها “فؤاد” كالطاووس بدلالة الانتصار الساحق: “.. فأخذ نفسًا عميقًا، كقائد انتصر في معركة مصيريّة..”، باغتنا الراوي بدفع مقود السرد إلى فضاء (كابوسي)، ذي طابع (كافكاويٍّ) شامل، تحوَّل في إطاره “فؤاد” إلى شبح محطم: “.. طالت ذقنه، اختلط سواد شعرها ببياضه..” يعبث ببراويز الجدران، ينفرد معزولًا في حجرته لا يلوي على شيء!، قبل أن يُخرج الراوي، كالساحر ذي الحيل من كيسه المثير صورة “عليّ” المعلَّقة على الجدران بشريط أسود.
وإذا كان المتلقِّي قد وجد ذاته ضحية عبث الراوي ومغامراته في “نوفيلا” “قصة تعسة” لأنطون تشيكوف Anton Chekhov، (1860-1904)، حين اكتشف أن الراوي قد باشر معه كل أساليب التضليل والمماكرة، وليِّ الحقائق، فإن المتلقّي في (اللعبة) قد عانى شيئًا من الانطباع المشابه، بعد أن تأكَّد أن شاشة الحاسوب وملفاته، قد تحمل تحوُّلات بركانية، في المصائر والمعارف والمآلات، لم نتحسَّب لكثير من نتائجها، من حقنا أن نسعد بمنجزاتها المؤكدة، التي اختصرت الوقت والجهد وألغت المسافات، ومن واجبنا، أن نفكِّر، بروح مسئول في تداعياتها ونتائجها الفرعية، التي تحمل في طيَّاتها كثيرًا من المفاجآت المباغتة، التي يمكن أن تخرج من الشقوق.

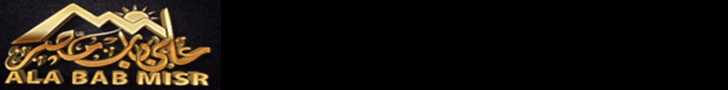

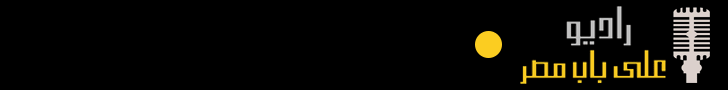

التعليقات مغلقة.