ثمرات الإيمان للعبد المؤمن وعلاقتها باشباع الجانب الروحي للإنسان
بقلم / محمــــد الدكــــرورى
نريد أن نعلم معنى الإيمان ، والفرق بينه وبين الإسلام ، وهل أنت مسلم أم مؤمن؟ ولماذا يُكتب في البطاقة الشخصية والمستندات العامة الديانة مسلم ، ولم يُكتب مؤمن؟ فالإسلام معناه ، هو الاستسلام والخضوع والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى، فهو الانقياد الظاهري ، وأما الإيمان فمعناه ، هو التصديق بالقلب ، فهو الانقياد الباطني ، فخص الإسلام بالأعمال الظاهرة ، والإيمان بالأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله .
فنحن نرى أن أعمال الإسلام كلها ظاهرة ، وتؤدى وتحس بإحدى الحواس الخمسة ، كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها ، وأما أعمال الإيمان فكلها أعمال اعتقادية قلبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل ، كالإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر بما فيه من حساب وصراط وميزان وجنة ونار وغير ذلك ، لذلك قيد الله الإيمان بأنه لا يكون إلا بالغيب.
فالعبد بنطقه الشهادتين يكون مسلمًا أمام الجميع، وأما دخول الإيمان قلبه فلا يعلم به إلا الله ، فقد يكون مسلمًا ومع ذلك هو منافق معلوم النفاق ، كعادة المنافقين في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، فنحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر ، وبهذا المبدأ كان يتعامل به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع المنافقين.
ونخلص من ذلك أن الإيمان لا يكون إلا الغيب ، والإسلام يكون بالاستسلام الظاهري، هذا إذا اجتمعا ، أما إذا افترقا فكلٌ منهما يحمل معنى الآخر ضمنًا، ولذلك يقول العلماء في الإسلام والإيمان ، إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
فكلاهما ينوب عن الآخر ويقوم مقامه إذا ذكر وحده، فإذا قيل: هذا الشخص مؤمن فمعناه أنه مسلم، وإذا قيل مسلم فمعناه أنه مؤمن، وهذا معنى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أي ، إذا ذكرا معًا فإن لكل منهما معناه الخاص، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنه يتضمن الآخر غير المذكور، وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى ، فبينهما عموم وخصوص .
فالإسلام أعم ، والإيمان أخص ، فكل مؤمن مسلم ولا عكس ، ومثله: الفقير والمسكين ، فإذا ذكر أحدهما يحمل معنى الآخر، فتقول، أقوم بتوزيع هذا المال على الفقراء، أو أقوم بتوزيع هذا المال على المساكين .
وكذلك يزداد الإيمان من حيث القول، فإن من ذكر الله عشر مرات، ليس كمن ذكر الله مئة مرة، فالثاني أزيد بكثير، وكذلك أيضًا من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص.
فلو صلينا الظهر مثلًا ، فإن الدرجة التي يحصل عليها كل واحد منا تختلف عن الآخر تمامًا، وهذا راجع إلى خشية العبد وتقواه لربه، والنسبة المئوية تختلف من شخصٍ لآخر، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، يصور ذلك فيقول: “إنَّ العبدَ لَيصلِّي الصَّلاةَ ما يُكتُبُ لَهُ منْها إلَّا عُشرُها، تُسعُها، ثمنُها، سُبعُها، سُدسُها، خمسُها، ربعُها، ثلثُها نصفُها” رواه أحمد.
والإيمان الحقيقي إذا لامس شغاف القلب ، وتمكن من مجامع النفس انعكست آثاره القوية على الروح والعقل ، وعلى الفرد والمجتمع ، فمن ثمراته أنه يورث العبد حسن الخلق ، لأن الإيمان والأمانة صنوان ، لا يفترقان ، حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : ” لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ” ، كما أن الإيمان والحياء قرينان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ” .
والإيمان والصدق متلازمان ، فعن صفوان بن سليم ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: ( نَعَمْ ) ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ: ( نَعَمْ ) ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ فَقَالَ: ( لَا) ، ولقد عرف بعضهم الإيمان بالصدق ، فقال : الإيمان الحقيقي هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك ، وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك ، فإن وجدت أخلاقا كريمة ، فهي نتاج إيمان صحيح .
فالمؤمن لا يتكلم إلا بالقول الطيب الذي يُصلح ولا يُفسد ، يبني ولا يهدم ، يُعمر ولا يُخرب ، لأن ديننا الحنيف دين الأخلاق ، والإصلاح ، والبناء ، والتعمير ، فمن زاد عليك في ذلك فقد زاد عليك في الدين ، ومن ثمرات الإيمان ، السكينة والطمأنينة ، فإذا تمكن الإيمان من النفس البشرية فإنها حينئذ تمتلئ بالسكينة واليقين والرضا ، فتسعد في الدنيا والآخرة ، والمؤمن الحقيقي يدرك يقينًا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وهذا ما يجعله يتقلب بين مقام الشكر حال السراء ، ومقام الصبر حال الضراء، فيطمئن قلبه بأن كل ما قضاه الله عز وجل هو خير له .
وأن الإيمان يعصم صاحبه من ارتكاب الموبقات، ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ” لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ” ، كما أن المؤمن الحقيقي ينزه نفسه عن كل ما يؤذي مشاعر الناس كالسخرية والاستهزاء وسوء الظن .
ومن ثمرات الإيمان هو التأييد والنصر من الله تعالى ، فالإيمان الصادق يجعل العبد في معية الله سبحانه وتعالى ، حيث يقول الحق سبحانه : ( وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ )، والمعية هنا تقتضي النصر والعون والتأييد ، وأما معيته الخاصة فهو مع المؤمنين بنصره وتأييده كما قال لموسى وهارون: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ، وهو مع المتقين، ومع المحسنين، ومع الصابرين، فمن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل .
وقال بعض السلف لأخيه: “إن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو؟”، وهذه هي المعية التي يدافع الله بها عن المؤمنين، وهي المعية التي كان الله بها مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الغار: ” يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ” ، لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ معنا ، وهي معية النصرة والتأييد، مؤنسة مطمئنة، مذهبة للخوف، والوجل، والرعب.
والمعية الخاصة هي التي يطمئن بها المؤمنون، ويزدادون عملاً بأن الله لا يتخلى عنهم، فكم فكت من أسير للهوى قد ضاع، وأيقظت من غافل قد التحف بلحاف الشهوة فماع، وكم من عاق لوالديه ردته عن معصيته، وكم من عابد لله بكى لما استشعر معيته، وكم من مسافر رافقته، وكم من الناس الذين هم مع ربهم والله معهم.
ومن ثمرات الإيمان هو محبة الله لعبده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض” .
ومعنى إذا أحب الله تعالى العبد هذا كما سبق فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن الله يُحِب كما أنه يُحَب، فالله يحب بعض الأعمال، كما أنه يحب بعض عباده محبة تليق بجلاله وعظمته، ليس كمحبة المخلوقين، “إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانًا فأحببه”، وما قال: إن الله أحب فلانًا، بل “إن الله يحب”، والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، إن الله يحب فلانًا فأحببه فلا تبقى محبة الله ، للعبد محبة تختص به بل يكون من نتيجة ذلك وأثره أن عظيم الملائكة وكبير الملائكة وهو جبريل ، يحبه بأمر الله عز وجل فصار الله يحبه، وأعظم الملائكة وهو جبريل يحبه .
فينادي في أهل السماء يعني: جبريل ينادي في أهل السماء وهم الملائكة إن الله يحب فلانًا، والسماء هنا جنس تشمل السموات السبع الطباق، كل أهل السموات “فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء”، وأهل السماء هنا هذه تدل على العموم كل أهل السماء ، لأن “أهل” أضيفت إلى معرفة فكان ذلك عامًّا كل الملائكة يحبونه ولا يُستثنى من هذا أحد.
ثم يوضع له القبول في الأرض يوضع له القبول أي: أن قلوب العباد تحبه، إذا رآه أحد أحبه كما قال الله ، وهو أحد التفاسير المشهورة في الآية، في قوله تعالى عن موسى ( وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ) فما رآه أحد إلا أحبه، فوضْعُ القبول للعبد في الأرض دليل على محبة الله عز وجل له، والمقصود بوضع القبول له عند أهل الإيمان، وإلا فإن أهل الكفر لا يحبونه، وفرعون لا يحب موسى قطعًا، والملأ من قوم فرعون ما كانوا يحبون موسى ، وإنما القبول عند أهل الإيمان.
وكل ثمرات الإيمان ، كل هذا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن ، وهى السعادة الحقيقية والراحة النفسية ، مما يجعله يشعر بأنه في جنة الدنيا من السعادة وراحة البال ، لأن له رب واحد هو الله جل وعز، ونبي واحد هو محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنهج واحد هو اتباع رضوان الله، وهدف واحد هو جنة عرضها السماوات والأرض.
ولنعلم جميعا أننا إذا إلتفتنا يمينًا وشمالًا فترى العيادات النفسية تمتلىء بالمرضى، وتستمع للشكاوى والهموم والغموم والأرق وقلة النوم والهواجس والكوابيس؛ فتعلم علم اليقين أن هذا كله بسبب الابتعاد عن الإيمان الحق بالله جل وعز، وبسبب الركون للدنيا والتعلق بها؛ فالماديات قد طغت على الجوانب الروحية، والإنسان بحاجة ماسة لإشباع الجانب الروحي، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الحق بالله جل وعز والتعلق به ومداومة ذكره، والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله جل وعز.
المهم أن كثيرًا من الخلق قد غفل عن دواء القلب، وعن راحة الصدر، وعن جنة الدنيا لهثًا وراء حطام الدنيا الفانية، فلا هو حقق ما يريد، ولا هو استراح من أول الطريق ، وإشباع الجانب الروحي لن يحصل إلا بالإيمان ، لأن الروح من عند الله، والجسد خلقه الله من تراب، فكلما أشبعت الجانب الروحي سمت نفسك وارتقت واطمأنت وارتفعت عن سَفَاسِف الأمور، وكلما أهملت هذا الجانب انحدرت نفسك إلى الطبيعة الحيوانية الشهوانية، وزاد ضِيقها وضَنَكها، وأظلمت الدنيا في عينيها.
مع تحيات إدارة جريدة على باب مصر

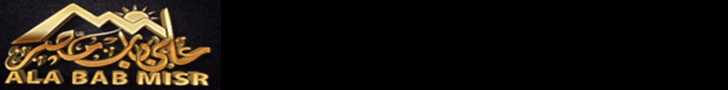

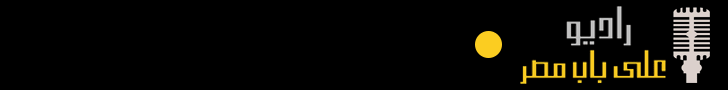

التعليقات مغلقة.