حين يكتب شحاتَة .بقلم . ربيع دهام
بندقيةٌ معلقةٌ على الحائط.
تحت البندقيةِ طاولةٌ صغيرةٌ، وأمام الطاولة كرسي عتيق
مصنوع من القشّ. فجأة تحرّكَ الكرسي. تحرّك لا لأن
الريح أخذت تعصف بالمكان، بل لأنه على تلك الكرسي
بالذات جلس شحاتَة.
شحاتة، ذاك الروائي المعروف، ذو الشخصية الغامضة الانطوائية.
يده اليمنى كانت تقبض على رزمة من الأوراق الرطبة.
وبحرصٍ شديد، راح يركن الأوراق على الطاولة، ويفردها.
ثم شرَع يتصفّحها، واحدة تلو الأخرى، باحثاً عن جنّات
يجري من فوقها البياض.
عن مساحات فارغه يملأها بكلمات روايته الجديدة.
استلّ من جيبه مسطرة بلاستيكية قديمة. وبالمسطرة، راح يقيس المسافات الخالية في كل صفحة. ثم عدّ الصفحات التي فيها تلك المسافات. وبعمليّة حسابية بسيطة، استنبط عدد الصفحات التي بإمكانه أن يكتب عليها.
سبع صفحات من قياس أ-4.
“اليوم سأكتب 7 صفحات”، قال في نفسه.
لكنه عاد واستدرك: ” بل 4 صفحات. حريٌّ على المرء الاقتصاد. هكذا لن يضطرني الأمر إلى الخروج من البيت كي أبحث لي عن صفحات بيضاء مرمية، أو فيها ما تيسرّ من بقايا بياضٍ”.
فمغادرة البيت، كما يعرف شحاتَة، تحتاج لطاقة
عقلية وجسدية. والطاقة العقلية كما الجسدية تحتاج لطعام. والطعام يحتاج لمال.
حمل شحاتة قلم الرصاص، الذي بالمناسبة، وإن يسمّونه “رصاص”، فإنه لا رصاص فيه، بل كربون.
وكان قلم الرصاص هذا، المُنهك المُرهق من كثر البري، أقصر من طول ظفر إبهام. بل لا أعرف كيف كان بمقدور القلم القزم هذا أن يلفظ هذا العدد الوفير من الحروف
على الأوراق.
حاول أن يكتب به. لم يستطع.
تنهّد شحاتة.
وبحذرٍ شديد، ركن القلم القزم على الطاولة.
لكنه، وهو الكاتب الفذ، يكاد رأسه أن لا ينضب أبداً من الأفكار.
سيوصل القلم لاحقاً بملقط غسيل، فتزداد قامته، أي القلم، طولاً.
أما الآن، ونحن أولاد الآن، كما يقول شحاتة، فقد استل قلم الحبر الوحيد الذي يمتلكه، والذي كان يخبئه للظروف الصعبة.
ركن القلم الأسود قرب ناظريه وغمغم:
“خبيء قلمك الأسود لصفحتك البيضاء”.
ثم نفخ على رأسه، وهزّه بيده، موجهاً مقدمته نحو الأرض.
وراح يحدق بالحبر.
كرج الحبر نحو الرأس. فهلل شحاتة فرحاً.
ثم حفّ الرأس بالورقة، فتقيأ القلم على أثر الهزِّ، حبراً.
القلمُ يكتب. ما زال على قيد الحياة. لم يُصب
بالذبحة الحبرية بعد. تحضّر شحاتَة. تهيّأ.
الجوُّ هادئ مسالمٌ، والشمس تفلش نورها أرجاء البيت.
شحاتة لا يكتب في ساعات الليل أبداً، بل في وضوح النهار.
ولم يكن هذا بسبب طقوسٍ كتابية يتبعها، مثلما لدى كل كاتب طقوسه.
بل لأنها، وبخلاف الطاقة الكهربائية، التي ليست متجددة، والتي تستدعي طرق باب بيتك كل آخر شهر، من قبل موظف يلوّح بفاتورة الموتِ، ويشهرها كحبل المشنقة أمام عينيك، فإن طاقة الضوء هي طاقة متجددة، لا تكلف الجيبة شيئاً. طبعاً إلا أذا كان المرء غير مدركٍ وانتصب تحت أشعة الشمس لساعات. ساعتئذ تضربك الشمس بضوئها وتسطحك. فيكون الطبيب، أو الصيدلي ، أو المستشفى، أو حفّار القبور، في تلك الحالة، هم “الرازقون”.
شرع شحاتة في اختيار شخصيتهُ الرئيسية في الرواية.
دوّن اسمه. عائلته. عمره. واختار مسكنه، وما يوجد في مسكنه من أثاث.
كان قد سأله أحد النقّاد يوماً:
“لماذا في رواياتك، أستاذ شحاتة، تكون شخصياتك كلها معدومة الحال. تقطن بيوتاً دائماً ما تكون خالية من الأثاث. أو تمشي لمقاصدها سيراً على الأقدام؟
أو إنها لا تذهب للتسوّق بتاتاً. لماذا لم نقرأ في
رواياتك، أستاذ شحاتة، عن أي شخصية، رئيسية أو ثانوية، تدعو شخصية أخرى إلى العشاء؟”.
وكان يجيبه شحاتة الذي، مثلما يقتصد في كل شيء، فإنه يقتصد في الكلام أيضاً : ” للكاتب حرية خلقِ الشخصيات، وللشخصيات حرية الصرف والتصرّف يا أخي”.
وفعلاً، كانت روايات شحاتة كلها هكذا.
شخصيات محورية وثانوية معدومة الحال والأحوال.
وفيما راح يظن القرّاء أن السبب وراء ذلك هو وقوف
شحاتة في صف الفقراء، وإحساسه بهم، ونُبل عواطفه الجياشة تجاههم. فإن حقيقة الأمر ليست كذلك إطلاقاً.
فشحاتة، ذاك الكاتب الفذ، بسبب بُخلِه الشديد، أو لنقل، من “حرصِه” الشديد، فهو حتى في رواياته، لا يقتني لشخصياته إلا أرخص الأشياء.
لا يحتمل. لا يطيق. بل ليس بمقدوره إعطاء شخصيته حرية اقتناء أغراض ثمينة.
يأكله الغثيان. يلتهمه الضغظ. تصيبه الجلطة.
حاول مرةً، لكن يده صارت ترتجف من الهمْ. واحترق في أوعيته الدمْ. ونضب خلاياه ورئتيه من الأوكسجين.
فصارت أنفاسه تخور، والعرق يكدّه. وضربات قلبه تقفز كالبهلوان، مثل الدولار. قفزة واحدة إلى قمة جبل كليمنجارو. ثم قفزة إلى السفوح المنخفضة.
خلق مرة، ودون انتباه، شخصية مبذرة. ولما استدرك الأمر، عاد وأخفاها.
وأقول “أخفاها” وليس “قتلها”.
لا لأن شحاتة طيب القلب ولا يحب العنف. بل لأن القتل يتطلب دفناً. والدفن يتطلب مالاً.
أليس للكاتب حرية الخلق؟ أليس للكاتب حرية القتل؟
نعم. وللكاتب حرية الإخفاء أيضاً.
وهكذا هي الحال في رواياته. بيتُ أبطاله ليس فيه أكثر من كرسي وطاولة. ولو كانت الشخصية تعيش العز والبذخ الشديد، فأريكة.
حتى أنه في إحدى رواياته الشهيرة، مشت إحدى شخصياته من صحراء المغرب، عبر صحراء سينا، إلى الربع الخالي.
مشت لا بسبب هواية أو عزيمة. أو لكسر أرقام كتاب غينيس.
بل لهدفٍ خفيٍّ يعرفه هو فقط. فقط الكاتب. فقط شحاتة.
بالإضافة إلى أنا. أنا الرواي.
الراوي الذي يكتب هذا المقال.
وفي أحد الأيام، حين كادت المهلة التي حددها له دار النشر ليسلم الرواية، أن تنقضي، حاول شحاتة انهاء الرواية وتسليمها، قبل الوقت المحدّد. لكنه اضطر مرغماً أن يتوقف. ألا يُكمِلها وينهيها.
لم يفعل ذلك بسبب تعبٍ، أو نضوب أفكار، أو قفلة كاتب، كما يقولون. بل لأن الشمس أحزمت حقائبها وقفلت تتجه إلى المغيب، ولا يريد هو، أي شحاتة، أن يضيء لمبة.
لماذا؟ صرتم تعرفون.
لأن اللمبة تحتاج لطاقة. والطاقة تحتاج لكهرباء.
والكهرباء تحتاج لمال. والمال يتربص به موظف أمام مدخل بابك هناك.
ماذا يشرب شحاتة حين يكتب؟
بعض الروائيين يشربون القهوة. وبعضهم الشاي. وبعضهم فقط الماء. أما شحاتة، فلم يكن ليشرب شيئاً.
ولم يعد في هذا الأمر غرابة.
أما البندقية المعلّقة على الحائط، تلك التي ذكرتُها في أول القصة، والتي قال عنها تشيخوف، ذاك القصّاص الشهير، في رسائله يوماً، وهو يعطي نصائحه في كتابة القصة:
” قم بإزالة الاشياء جميعها التي ليست لها صلة بالقصة.
فإن ذكرت في الفصل الأول أن هناك بندقيةً معلقةُ على الحائط، حقًا يجب ان تستعمل البندقية إما في الفصل الثاني أو الثالث. يجب ألا تبقى معلقةً هناك إذا لم يجري إطلاقها”.
أراني مضطراً لكسر نصيحته تلك. لعدم استعمال البندقية. لا لأنني لست مهتماً لكلام تشيخوف، الذي هو أعظم كاتب قصص في التاريخ، بل لأن الرصاص الذي فيها، إذا ما نضب، يحتاج لرصاصة جديدة تحل مكانها. والرصاصة الجديدة يحتاج اقتناؤها لمال.
والمالُ هو ما لا يُمكن أن يبذّره أبداً… أبداً شحاتة.

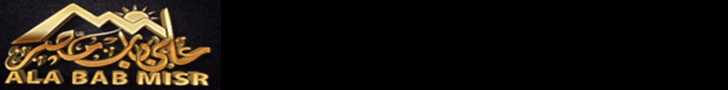

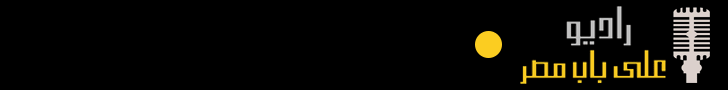

التعليقات مغلقة.