خطورة القلب الاسود
بقلم / محمــــد الدكــــرورى
لنعلم جميعا أن مرض الجسم ينتهي بالموت، لكن مرض القلب يبدأ بعد الموت، ومرض الجسم ولو كان عضالاً ينتهي بالموت، وقد يكون صاحبه في أعلى الجنات، وانتهى الأمر،
لكن مرض القلب يبدأ بعد الموت ويشقي صاحبه إلى أبد الآبدين، ولو كنا منطقيين لوجدنا أن أخطر أمراض الجسد أثره محدود في الحياة الدنيا، بينما أمراض القلب تشقي صاحبها إلى أبد الآبدين، فلذلك ينبغي أن ترتعد فرائصنا من أمراض القلب لأنه:
﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ .
لا شك أن القلوب تمرض كالأبدان، ومرض القلوب أنواع، فمنها مرض لا يتألم به صاحبه في الحال، كمرض الجهل، ومرض الشبهات والشهوات والشكوك، وهذا النوع هو أشد الأمراض ألمًا، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم، فهم أطباء هذا المرض، ولا شفاء منه إلا باتباع ما جاءوا به من الهدى.
والقلب له حياة وموت، ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن، والغالب في أمراض القلب أنها لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية، فالهم والغم والحزن من أمراض القلب، وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور والأنس.
وجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات، وأمراض الشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ولغيرها من الأسقام؛ ففيه من الآيات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشُّبَه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه ، وفيه إثبات التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد، وإثبات النبوات، وفي ذلك كله شفاء من الجهل، وهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه.
وأما شفاء القرآن لمرض الشهوات، فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة، بالترغيب والترهيب، والتزهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبًّا للرشد مبغضًا للغي، ويعود للفطرة التي فطره الله عليها، كما يعود البدن المريض إلى صحته.
وإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة، فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة، تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا معوّق ولا ممانع فنما البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة، فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة، والمواد الرديئة فزكا القلب ونما، وقوي واشتد.
وإن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة ، فالإنسان إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله، أكسبه ذلك تحريفًا للحق عن مواضعه، فإذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه ردَّه وكذّبه إن قدر على ذلك وإلا حرَّفه.
أما القلب الطاهر، فلكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته ، وأما القلب الذي لم يطهّره الله تعالى، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه، بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح.
وإن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى الذي يعلم ما في القلوب، ويعلم ما يصلح له منها وما لا يصلح، ومن لم يطهر الله قلبه فلا بدّ أن يناله الخزي في الدنيا، والعذاب في الآخرة، بحسب نجاسة القلب وخبثه. فالجنة دار الطيبين لا يدخلها خبيث، ولا من فيه شيء من الخبث.
فمن تطهر في الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة، ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير معوق؛ لأنه جاء ربه بقلب سليم، وعمل قويم ، ومن لم يتطهر في الدنيا، فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحالٍ، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة، ثم يخرج منها إلى الجنة بعد طهارته.
وكذلك المؤمنون إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذَّبُون وينقون، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة ، والذنوب والخطايا توجب للقلب ضعفًا، فيرتخي القلب، وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، والخطايا والذنوب للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولذلك كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب، واشتد ضعفه ومقاومته للباطل، والماء يغسل الخبث، ويطفئ النار، فالقلب والبدن بأشد الحاجة إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما
وقلوب البشر لها آفات وعلل، وأمرض وأسقام، والحسد من الأمراض العظيمة التي تصيب القلوب، ولا تداوي أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، والعلم النافع لمرض الحسد: هو أن يعرف الإنسان أن الحسد ضررٌ عليه في الدنيا والدين ، أما في الدين فيعني سخطك على قضاء الله تعالى، وهو تعبير عن كراهيتك نعمته التي قسمها بين عباده، وعدله الذي أقامه في ملكه بحكمته، فاستنكرت وكرهت وتبرمت من ما قضاه الله وقدّره واختاره لعبده ، وهذه جناية كبرى على التوحيد والإيمان والدين.
وأما كونه ضررًا عليك في الدنيا، فهو ألمك فيها، وعذابك بها، فالذين تحسدهم لا يخليهم الله من نعم يفيضها عليهم بسبب حسدك، فلا تزال تتألم بكل نعمة تراها، وتتعذب بكل بلية تصرف عنهم، فتبقى مغمومًا محرومًا، فحسدك نار تحرق بها نفسك دون أن تحرق بها الآخرين.
ومن أمراض القلوب حب الدنيا فكرًا وطلبًا وتمتعًا والإعراض عن الآخرة، ومن اتخذ الدنيا ربًّا اتخذته عبدًا، والعاقل من يرضى منها بالقليل مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدنيا بقليل الدين مع سلامة الدنيا، ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره .
وإن الدنيا والآخرة ضَرَّتان، فبقدر ما ترضي إحداهما تسخط الأخرى، وبقدر ما تعمر إحداهما تهدم الأخرى، وبقدر ما تقدم إحداهما تؤخر الأخرى ، وطالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا، حتى يقتله الشرب ، والدنيا سريعة الفناء، تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء، وأنت أيها العاقل اللبيب عليك أن تتخلى عند إحداهما، فأيهما ستبقي؟!!.
ومن أمراض القلب الحرص والطمع، وينتج عن الحرص والطمع البخل والشح، وهو من أمراض القلوب، فسبب البخل والشح الطمع والحرص وحب المال، وهذا مرض للقلب عظيم، عسير العلاج، إن المال وسيلة إلى مقصود صحيح، وقد يجعل منه آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة، فهو بحسب استخدامه يكون محمودًا أو مذمومًا.
ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل الله، وكان المال مسهلاً وآلة إليها، عظم الخطر فيما يزيد على قدر الكفاية من المال، فعلى العبد القناعة، فإن تشوف إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة، وتدنس لا محالة بالطمع وذل الحرص، وجرّه الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق، وارتكاب المنكرات الخارقة للمروءات، والوقوف بأبواب اللئام.
فإذا تيسر للعبد في الحال ما يكفيه، فلا يضطرب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل، واليقين بأن الرزق الذي قُدر له لا بدَّ أن يأتيه وإن لم يشتد حرصه، وأن يعرف ما في القناعة من عزّ الاستغناء، وما في الحرص والطمع من الذل.
ثم ينظر في أحوال الأنبياء والأولياء، ويخير نفسه بين أن يكون مقتديًا بأعز الخلق عند الله، أو مشابهًا لأراذل الناس، وعليه أن يفهم ما في جمع المال من الخطر؛ ففي حالة الفقر ينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص، وإن كان غنيًّا فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء وبذل المعروف، والتباعد عن الشح والبخل، فإن الجود من أخلاق الأنبياء.
فالصحيح قد يأتيه جرثوم، قوة مناعته كبيرة فيرده ويقضي عليه، لكن ضعيف المقاومة وضعيف المناعة أضعف الجراثيم يجعله مريضاً، يقعده في الفراش، كذلك مرض القلب، أي شيء يفتنه، أي شيء يصرفه عن الحق ويغريه بالمعصية، لأنه في الأصل مريض، البرد قد يصيب الصحيح فلا يتأثر به عنده مقاومة، ومن كان قلبه سليماً لا يتأثر بالمغريات، ولا بمظاهر القوة التي يراها عند الكفار، ولكن القلب المريض يضعفه أي شيء، فلذلك القلب المريض يزداد مرضاً.
وفى النهايه إن أردت أن تتقرب إلى الله لا تكفيك الاستقامة، لابد من عمل صالح ماذا بذلت؟ ماذا أعطيت لهؤلاء المسلمين؟ ماذا قدمت لعباد الله الصالحين؟ ماذا قدمت لخلق الله أجمعين؟ ماذا قدمت لغير البشر؟ هل عالجت قطة؟ هل أطعمت جائعاً؟ هل سقيت حيواناً يعاني من العطش؟ لقد غفر الله لامرأة رأت كلباً يأكل الثرى من العطش، هل لك عمل صالح؟ هل حملت بعض هموم المسلمين؟ هل أنفقت بعض مالك ووقتك وجهدك الذي لا تملك إلا غيره أحياناً؟ هل أنفقت من علمك وربيت أولادك؟ لابد من حركة نحو الله.

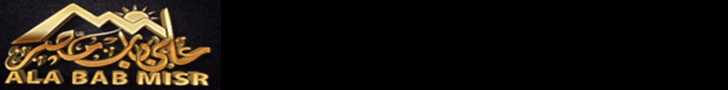

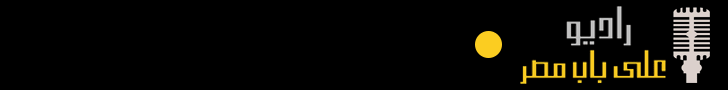

التعليقات مغلقة.