“درب الخواجة” بقلم محمد كمال سالم
أشرتُ بسبابتي لابنتي وزوجتي:
كنتُ أعمل في هذا الشارع وأنا صبي ، حيث لازلت أرتدي البنطال القصير (الشورت) في إجازاتي المدرسية الصيفية:
-انتظراني هنا دقيقة ألقي نظرة، لعلي أجد أحدا أعرفه.
عدت إليهما سريعا، فقد تغيرت الدنيا كثيرا.
على بُعد خطوات قليلة، كان المسجد الفاطمي هو الكائن الوحيد الذي ظل على حاله، لمحت شيخا طاعنًا في السن، يجلس على درجاته الرخامية البيضاء، التي تسبق الباب، يقرأ في مصحفه، أمعنت النظر إليه، أظن أني أعرفه، وقت قليل ويُؤذن للعصر، جرفني شوق هادر، وددت لو بقيت هنا لبعض الوقت.
قد كنا أتينا إلى هنا في رحلاتنا المكوكية للتجهيز لزواج ابنتي الكبرى، وهنا سوق كبير للنجف وأدوات الإنارة:
_ إذهبا أنتما، تفقدا ماتريدانه، حتى أُصلي العصر وألحق بكما، انتبها فقط لنفسيكما ولصوت التليفون حتى أجدكما.
كانت فرصة كي أتملص من صبرهما الطويل، ومن قدرتهما الهائلة على استخراج كل عيوب البضاعة المعروضة، ومن الزحام أيضا.
تخطيت السياج الحديدي العتيق المحيط بالمسجد، تأملته بحنين وشغف لأحجاره البيضاء الأثرية، عفنٌ رطب ينهشها، وتعرية وإهمال ظاهران للباب الخشبي المشغول بمهارة، كان ظل المسجد العظيم المترامي، يمنح المكان برودة لطيفة، وحماية من قيظ نهر الشارع والسوق، لم يتغير فيه الكثير على كل حال، رغم عقود طويلة منصرمة.
اقتربت من الشيخ في حذر، كان مكتنزا، منكبا على مصحفه، تكسو وجهه لحية بيضاء عظيمة، تكسبه بهاءً ووجلا، نُحل شعر رأسه التي غطاها بطاقية بيضاء حجازية، ترددتُ، خفتُ أن أقطع عليه خلوته، سأناديه بصوت خفيض، إذا لم ينتبه، فلن أكررها:
_ السلام عليكم عم سونه.
نظر إليّ من خلف نظارته: وعليكم السلام، حسونة يا رجُل، حسونة!!
ماعاد أحد يناديني هكذا الآن، ولم يعد يليق بشيخوختي، هل أنت من سكان الحي القديم؟!
_ لا، كنت أعمل وأنا طفل صغير في درب الخواجه، عند الحاج ورداني صديق أبي، لا أظن أنك تتذكرني.
خلع نظارته الطبية بيد مرتعشة، نظر إلي بعينين يكاد يكسوهما البياض، أغلق كتابه تاركا سبابته رهينة حين توقف، وأنا أهم بالجلوس إلى جواره:
كان يجلس عندك امام دكانتك للبقالة، هو وكل تجار وأسطوات الشارع، أصدر تنهيدة:
_رحم الله الجميع.
كانوا يأكلون من صُنع يدك ساندويتشات الجبن والتونة، والبيض بالبسطرمة، رائحتها مازالت تُزكم أنفي، كان مصروفي من أبي وقتها، لا يسعنُي أن أحظى بساندويتش واحد منهم، لكنك كنت كريما معي، كنت تجزل لي في عدد الحلوى بقرش تعريفة واحدة، ابتسمت أنا، وهو مازال يسمعني.
وجدته مصغيا فأكملت حديثي الذي يكتنفه الفضول:
دخلت الدربَ، لعلي أجد من أعرفه، أو يعرفني، أستعيد معه بعض الذكريات، فقد قضيت هنا سنوات كثيرة، عاصرت فيها حكايا شيقة وغريبة، لكنه أصبح مكانا مختلفا، ربما أصبح أكثرَ نظافة، البيوت تزينت بواجهات المحال والإضاءة، ولكنه أصبح أكثر زحاما، وأيضا خلعوا بلاط البازلت الأسود الإنجليزي العتيق، كان وقع عجلات العربات الكارو فوقه وصوت أرجل الخيل مزعجا، لكنه كان يطربني، رصفوه الآن بهذا الأسود الرخيص، فقد الحي عبقه المعهود، تكتنفه حدة السوق وقسوة التجارة، أصبح درب خواء بلا روح، أو ألفة كنت قد عهدتها ها هنا بين الناس، أذكر الدكاكين وأصحابها وكأنها حانوت واحد، الحاج محمود صالح، المعلم دكروري، الأستاذ لطفي المحامي، حتى هارون اليهودي وبناته الجميلات، وكيف أنهم اختفوا من الحي بعد الحرب، أذكر الفنانة حيات في مرورها وتبرجها، كانت تغازلني في خلاعة لا تناسب سني الصغيرة، كانت تضحك مني، تناديني بأغنية ( مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا) ثم تلدغني بوجنتي، وتصدح ضاحكة، تتبادل النكات مع الرجال، نظر الشيخ إليّ طويلا ثم: أظنها ماتت على خير في مدينة رسول الله.
_ صلى الله عليه وسلم.
سادت بيننا لحظة صمت، أنهيتها:
أذكر أيضا جوده السايس حين قذف صاروخا كبيرا ليلة رؤية هلال رمضان داخل دكانك، وكيف هربت أنت مزعورا تكاد أن تنبطح على وجهك، فضحك منك كل أهل الشارع (ضحكنا معا):
_ كنت سأقتله ليلتها، لولا محبتي إليه، فقد تعهدته منذ أن هبط الشارع صبيا غريبا، لا نعرف له حسب أو نسب، ثم كما جاء اختفى، كما الحياة، نعيشها بين غربتين.
أردفت:
كان الجميع يحبك، لحضورك البهي ولسانك اللطيف، يجلسون عندك في الليل تتسامرون، ثم تذهبون معا للمقهى الزجاجي، تلعبون الورق والنرد……..
ألم يبق منهم أحد؟
أشاح بمصحفه الذي في يمينه، ونظر إليه طويلا:
_ لم يبق لي إلا هذا، هو خير صديق الآن، هو من ظل حين غادر الجميع.
_ ودكانك؟
_ أصر ابني الكبير أن يحوله معرضا للنجف كسائر الحي، لم يعد لي هنا إلا المسجد، أأتنسُ فيه بصلاتي وتقربي، ثم أعود إلى بيتي وحيدا.
إرتفع أذان العصر، شعُرت أنه كان يأتنس بحديثي، يريد أن يستزيد، بادرته:
هل نقوم لنلحق الصلاة؟
_ لا بأس، طالما ترتدي الآن بنطالٌ طويلٌ.

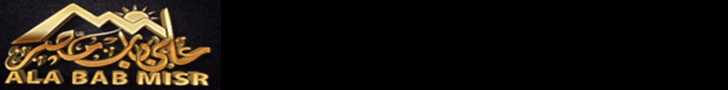

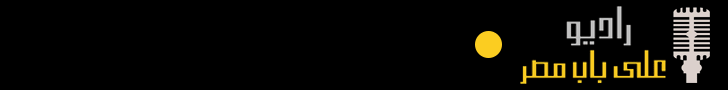

التعليقات مغلقة.