صورة بقلم حسام شلقامي
كانت المرة الأولى التي أغادر فيها قريتي، ساعيا لتحقيق ذلك الحلم الذي سيطر علي، أن أكون صحفيا كبيرا يشار إليه بالبنان، ممتطيا راحلة الحلم التي كانت صندوقا خلفيا لسيارة نقل، نحشر فيها مع البهائم بالسوية لا فرق بيننا، كنت حريصا على ألا يلوث البول والروث ثيابي.
على محطة قطار أسيوط: وصلت بي قدمي من موقف قريتنا، ما زالت ثيابي رغم عدم آدمية وسيلة النقل، مناسبة للخطوة الأولى.
جاءت جلستي في القطار بجوارها، تلك الفتاة التي سلبتني كل خيالاتي المتعلقة بمستقبلي، بمجرد نظرتي إلى عينيها، ذلك الجزء الوحيد من وجهها الذي تبينته من خلف نقابها، تأكدت ساعتها فقط مما كنت أظنه من غوايات أهل الشعر عندما تذكر أبياتهم العيون التي تسبي، فقد سبتني عيون تلك التي لا أعرف هل وجهها بجمال عينيها أم لا؟ لكن الأكيد أنني قد وقعت أسيرهما.
كان التوتر باديا عليها، وشت به نظرات عينيها القلقة، وحركات يديها المتوترة وتململها في مقعدها بجوار النافذة، تسرح مع الطريق لحظة، ثم سرعان ما تتحول نظراتها عنه مطاطأة رأسها ناظرة إلى لا شيء.
كان من الصعب في ظل عادات بلادنا، وخجلي الفطري الموروث…بالتأكيد هي مثلي أيضا…أن أبدأ حوارا معها، يهون على كلينا طول الطريق، ويخفف ولو قليلاً من حدة توترنا، أنا الآخر كنت أكثر توترا منها، يبدو أنها أيضا تجربتها الأولى مع مغادرة الأهل، لفترة طويلة، كنت أنتظر معجزة من السماء أن تبادرني هي بالحديث.
وحدثت المعجزة وفوجئت بها تسألني:
…كم تستغرق رحلة القطار من أسيوط إلى القاهرة؟
أجبتها منفعلا بسعادة غامرة:
…ست ساعات على الأقل
ثم عاد الصمت يلفنا من جديد.
لكنني لم أجعل لحظات صمتنا تطول، إذ أن مبادرتها بالحديث معي جرأتني على سؤالها:
..هل هي المرة الأولى التي تذهبين فيها إلى القاهرة؟
أجابتني بإيماءة من رأسها أن نعم.
واصلت حديثي معها متشجعا بعدم صدها لي:
…ولماذا تسافرين إلى العاصمة، هل لعمل أم لدراسة؟
أجابتني بخجل:
…أنا ذاهبة للدراسة، هي سنتي الجامعية الأولى في كلية الطب، سأقيم عند خالي الذي يعمل هناك، سينتظرني في محطة القطار، فأنا لا استطيع الوصول وحدي لعنوانه.
تغلبنا أنا وهي على خجلنا، وقطعنا الطريق كله نتحدث، أخبرتها بأحلامي الصحفية، واخبرتني بحلمها أن تفتح عيادة في بلدتها تعالج فيها فقراءها، لم نشعر بطول الطريق، وسرقنا الوقت، ووصلنا محطة الجيزة حيث ينتظرها خالها، محطتي كانت رمسيس، بالطبع لم استطع النزول معها، وجدتها تقف منتظرة وقد عاودها قلقها، تأخر خالها بعض الوقت، غير أنني اطمأننت لما رأيته قد وصل إليها، واصطحبها وغادرت المحطة وعيناي تتبعهما أحسست أن قلبي ايضا قد مضى معها، نظرت إلى مقعدها الخالي، وجدت صورة مقلوبة على الجانب الابيض منها، أمسكت بها وقلبي ينبض بعنف، كانت صورتها بغير نقاب، ترى هل سقطت منها عفوا، أم أنها تركتها لي؟ بقي ذلك السؤال بغير إجابة.
يا الله، ما كل هذا الجمال ما كل هذه البراءة؟
حقا عينيها كانت تدل على ذلك، لكنني لم اتوقع كل تلك الفتنة، التي أكملت السيطرة على كل مشاعري، وجعلتني أسبح معها في عوالم جميلة من السحر والخيال، ولكن يا للأسف، اكتشفت أنني رغم طول ساعات مناجاتنا، لم أسألها عن اسمها ولا اسم قريتها، أحببتها ووقعت أسيرا لهواها، لكن أين سالتقي بها بعد الآن؟
ظللت أياما أسير غرامي الذي أصبح مستحيلا؛ إن لم أعثر عليها، لم يستطع عملي كصحفي تحت التمرين أن ينتزعني من ربقة حبي وقيود هيامي، ترددت كثيرا على كليات الطب في القاهرة، ولكن لازمني عدم التوفيق أن تكتحل عيناي برؤياها من جديد، ظللت أهيم في شوارع أسيوط كلما عدت في أجازة، أبحث عن عينيها خلف كل نقاب، وضعت نفسي في مواقف سخيفة كثيرة، وقد ظنتني بعض من تلك النسوة متحرشا بهن.
مرت الأيام والشهور والسنون، وما زال أملي حيا في داخلي ورجائي أبدا لم ينقطع، أصبحت من مشاهير الصحفيين الذين يشار إليهم بالبنان كما تمنيت أصبح اسم حسين جلال كبيرا في بلاط صاحبة الجلالة، لكن ذلك لم يمح من داخلي حلمي الأكبر أن أعثر عليها يوما.
اشتهر عني أنني راهب الصحافة، الذي أبى أن تشاركها فيه زوجة وأولاد عرف عني أيضا، أنني شخص حاد متغطرس لا يقدم يد العون للصحفيين الشبان، نعم كنت كذلك، ساهم في صنع شخصيتي تلك ما تعرضت له خلال مسيرتي الصحفية الطويلة، لا تتخيلوا أن صنع اسم حسين جلال كأحد أباطرة الصحافة المصرية كان سهلا، فحتى صديق طفولة أبي الصحفي الشهير في أيام عملي الاولى والذي أرسلني إليه أبي رحمه الله واثقا في مساعدته لي، قد خذلني وخذل أبي، لا أبالغ إن قلت إنه بجانب تخليه عني قد حاول عرقلة مسيرتي الصحفية، عندما أخبرني أنني لا امتلك أية موهبة تشي حتى بمستقبل معقول، حاول حصري في وظيفة إدارية في إحدى المجلات المغمورة، وقال لي أن هذا اقصى ما يمكنه أن يقدمه إلي لأجل خاطر أبي، كان يمكن أن تحطمني كلماته تلك وكان يمكن أن يقتل حلمي في مهده، لولا أنني تمسكت بأهداب الأمل، وآليت على نفسي أن اتخطى حدود المستحيل وأكون يوما ما أكثر شهرة من ذلك الصديق الخائن، وقد كان وأصبح اسمي أكبر من اسمه كثيرا وتوارى هو شيئا فشيئا حتى اختفى تماما.
ساعد أيضا على اكتسابي تلك الصفات التي اشتهرت بها، حالة الحزن الدائمة التي لازمتني طيلة حياتي، أنني فقدت الحب الحقيقي الوحيد في حياتي، لا أنكر أنني بحثت عن حب آخر يعوضني ما فقدت، وأن لي بعض النزوات الأنثوية المتقطعة، لكنني أبدا لم أعثر على ما يعوضني فقدي الكبير، وظللت محروما عاطفيا ويبدو أنني سأظل إلى أخر العمر.
ذات يوم وأنا في مكتبي الضخم، رئيسا لمجلس إدارة إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى، سمعت جلبة في مكتب مديرة مكتبي، شاب يصر على مقابلتي، علا صوته كثيرا، علمت فيما بعد أن الذي جرأه على ذلك أنه بلدياتي من أسيوط، كان من عادتي، ألا أسمح لأمثال هؤلاء الطامحين بمقابلتي.
شئ ما في صوت هذا الشاب جعلني أخالف عادتي، وطلبت من مديرة مكتبي أن تسمح له بالدخول، وسط استغرابها وذهولها سمحت له بالدخول، أول ما لفت نظري في هذا الشاب الجريء غير وسامته، كانتا عينيه الساحرتين الواثقتين، ولا أدري كيف أصدرت من فوري، أوامري بتعيينه، في مؤستتي الكبرى صحفيا تحت التمرين، وسط استغراب وذهول كل من يعلم بذلك.
وبمساعدتي ترقى الشاب سريعا، وتم تثبيته صحفيا معنا في المؤسسة، وللحق كان الشاب مستحقا لما وصل إليه، فقد كان طموحا نشيطا مثابرا والأهم من كل ذلك أنه نال ثقتي سريعا.
ذات يوم حكمت ظروف العمل أن يزورني أحمد وهذا اسمه في بيتي والتقينا أنا وهو في مكتبي، بمجرد دخوله، وقف أحمد ذاهلا صامتا وهو ينظر خلفي، لم يطل الصمت فقد قطعته أنا وسألته:
…مالك يا أحمد؟
ظل أحمد شاردا برهة من الوقت، ثم سألني وهو ما زال سارحا:
…صورة من تلك التي تضعها خلفك يا أستاذ حسين؟
ذهلت من سؤال أحمد، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يسألني فيها أحدهم عن صاحبة تلك الصورة، لكنني أجبته:
…هي مجرد صورة لامرأة جميلة، أعجبتني في إحدى معارض اللوحات في باريس في إحدى زياراتي المتكررة لفرنسا فاشتريتها
فوجئت بأحمد، يقول لي:
…عفوا يا سيدي إنك تكذب، فهذه الصورة التي خلفك، هي صورة أمي رحمها الله في شبابها وهي لم تغادر مصر في حياتها أبدا.

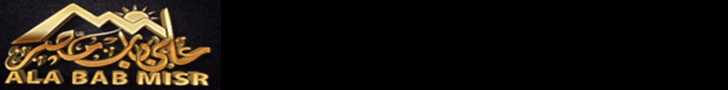

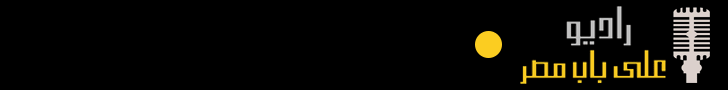

التعليقات مغلقة.