“عبلة والأستاذ” قصة… محمد فايز حجازي
سيدة تعدل مائة رجل.
لم يُسمع منها كلمة سوء قط.
تعرف الأصول ولا يفوتها الواجب.
تقف إلى جوار الجميع في الحزن قبل الفرح.
كريمة وما تملكه ليس لها.
لا تخذل من يقصدها. جُمل تناثرت على ألسن قاطني الحارة لسنوات كثيرة، هكذا كان الجميع يرى الست عبلة، وهكذا كانوا يرددون دائمًا، أصدقاؤها، جيرانها، وكل من تعامل معها من النساء والرجال، هكذا ظلت حبيسة هذه الرؤية، إطار وحيد وضعوها بداخله لا تبرحه، جامد لا مرونة فيه، نعم هو ذاك الإطار الذي يزينه مزيج عطر من سمو ونقاء وتضحية، وهي تستحقه ولا ريب، وهذا يبعث في نفسها سعادة لا نهائية، ولكنه ليس كل شيء، ليس كل شيء بالتأكيد.
مشاعر أخرى تعتمل في نفسها بلا انقطاع، أحاسيس أخرى ترنو إليها غير تلك التي تستشعرها في كلمات الناس وإطرائهم، أحاسيس فقدتها منذ زمان بعيد، مذ توفي عنها زوجها قبل تسع سنوات، مديح من نوع آخر، هي الآن في أمس الحاجة إليه، مديح أكثر أهمية مما تسمعه دائمًا! لاسيما في ليالي وحدتها الطويلة، التي دائمًا ما كانت تنتهي بدموع ساخنة تبلل جفون عينيها.
لم تعد ترى نظرات الإعجاب في عيون الرجال كما كانت تراها في السالف، وقت صباها وشبابها الأول، تلك النظرات التى تفهمها كل امرأة، وتسعد بها كل امرأة. ولكن ماذا عساها أن تفعل، إنها سنابك الحياة التي وطأتها، ويد الإهمال التي طالتها.
كانت عبلة في منتصف العقد الرابع من عمرها، بضة الجسم، معتدلة الطول، ذات بشرة سمراء محببة، سوداء العينين واسعتهما، لها نظرات صافية حزينة تنبيء عن طيبة فياضة، ربما لم تعد تكترث بمظهرها، أو بالأحرى لا تجد المال والوقت لأن تفعل، بعد أن غدت وحيدة تمامًا في الحياة، فلا زوج ولا أخ ولا قريب، إلا ابنها الوحيد وائل -أملها الباقي- الذي تجاوز العاشرة بقليل. عبلة من أولئك اللاتي تخالهن فور رؤيتك لهن إحدى أخواتك أو قريباتك، شوهدت تارة تبيع الخضروات في سوق السيدة زينب، وتارة تعمل في المستوصف الطبي في الميدان، وتارة أخرى تبيع الخبز في أكشاك المنطقة، حتى إذا ما انقضي اليوم، عادت إلى بيتها خائرة القوي، ترعى ابنها وتساعده على استذكار دروسه، كيف لا وهي الحاصلة على دبلوم التجارة، من مدرسة السيدة زينب التجارية للبنات،
وقتئذ كانت رشيقة مثل المانيكان، ترتدي الجيبة الكحلية النظيفة والبلوزة البيضاء الناصعة، ينسدل شعرها الأسود الفاحم إلى أسفل ظهرها في نعومة أخّاذة، وكان الشباب يتهافتون عليها، كل يمني نفسه بنظرة رضا من عينيها السوداوتين، في حين هي تسير في تؤدة ودلال.
كانت عبلة كثيرًا ما تستعيد ذكري تلك الأيام الرائعات، تستعيدها وهي تجلس ليلًا تطل من شباك غرفتها، على الوسعاية الرحبة أمامها، سارحة، يحلق عقلها في آفاق بعيدة، تمضي الساعات الطوال على صوت الست أم كلثوم، وهي تشدو أمل حياتي، أو أغدًا ألقاك، نعم أغدًا ألقاك قصيدة الهادي آدم، فقد كانت تهوي القصائد وتعرف مؤلفيها ومعانيها بمنتهي الدقة، ليس لأنها حاصلة على دبلوم تجارة، ولكن لأنها كانت تقرأ كثيرًا في شبابها الأول، كانت كثيرًا ما ترتاد سور السيدة زينب وسور الأزبكية لشراء الروايات الرومانسية، سلاسل روايات عبير وزهور، ذلك الجانب الذي لم يعد أحد يراه فيها، هي فقط من تستشعره، هو كائن بداخلها منذ صباها لا يغيب، حتى عندما تزوجت فلم تفعل إلا بعد قصة حب رقيقة، عاشتها مع زوجها الراحل، وهي لم تنسه قط فهو حبها الأول والأصدق، حب غال لا ينتهي، ودائمًا ما تستدعي أثناء تأملاتها ليلًا عذوبة عشرتهما وحبهما الكبير، وهكذا عاشت لسنوات طوال من أجل ابنها الصغير، مخلصة لذكرى حبيبها الراحل، ولكنها الطبيعة الانسانية وماجُبلت عليه المرأة من حب الإحساس بالأنوثة والتأثير، وهل يلومها على هذا أحد!
الآن ترتدي عباءتها السوداء، التى تبدو معها أكبر بأعوام كثيرة، فيناديها الأطفال بل والشباب الصغار أيضًا، بخالتي أم وائل، وهذا يؤسفها كثيرًا، ربما لا يرها أحد كما تتمنى، رجل واحد فقط في الحي يختلف عن الجميع، بدا لها أنه يراها بصورة غير تلك التي يراها الآخرون عليها، صورتها الحقيقة، صورة تعكس جمالها الصافي ونقاءها الداخلي، كيف لا وهو الأستاذ!
والأستاذ -كما يطلق عليه أهل المنطقة- كاتب وشاعر عرف بحسه الراقي وحسن خصاله، وطلاوة حديثه، يحب الجميع ويحبه الجميع، حتى أبي أيمن الرجل الفظ، صاحب المقهي في أول الشارع، يحب الأستاذ أيضًا، ربما توطدت أواصر علاقات الأستاذ مع الجميع، بعد أن رحلت زوجه قبل عامين، فأصبح البقال والكهربائي والسباك، يتوددون إليه يعرضون مساعداتهم، فطالت وقفاته معهم في غدوه ورواحه، إنها الوحدة التى قربت من كان بعيدًا.
كان الأستاذ في منتصف العقد السادس، طويل القامة، مهيب الخطى، وبرغم على ملامحه الجادة فإن براءة طفولية فياضة كانت تطل من نظرات عينيه، وتكسو لفتاته وإيماءاته.
تلاقت عيناهما غير مرة في الطريق، عبلة والأستاذ، تبادلا كلمات الود والترحاب، شيء ما بدا مشتركًا، هكذا كانت تفكر عبلة، حينها شُغلت عبلة كثيرًا، غمرتها الفكرة كأنها النسيم العليل، وكثيرًا ما كانت تتحدث إلى نفسها على أنغام الست في المساء.
وما الفارق بينه وبين الآخرين!
لا، هناك فارق كبير، هو شاعر مرهف الإحساس، يرى ما لايراه الآخرون.
ثم!
ألم تر نظراته الحانية، عندما تلتقي الأعين.
ربما، وماذا بعد!
حدثيه أكثر، تقربي إليه، هو خجل الشعراء ليس إلا.
وكيف أحدثه! وهل هناك ما هو مشترك بيننا.
إلى متى ستظلين حمقاء! أنت متذوقة للشعر، وتسمعين القصائد، اسأليه عن بعض المعاني، فهو شاعر. في تلك الأيام تعمدت عبلة مراقبة الطريق من نافذة منزلها، حتى إذا ما هلّ الأستاذ عند أول الشارع، هرعت سريعًا للقياه، فهو يمر في كل الأحوال من تحت بيتها، تارة تسأله عن معني القافية والروي والعروض، وكلها مصطلحات شعرية، فيشرح لها منبهرًا باطلاعها وقراءاتها، مبديًا إعجابه بفكرها وذوقها الراقي، حتى إذا ما انصرف وصعدت إلى بيتها، اعتنت بنفسها كثيرًا، اعتادت على حمامات الزيت لشعرها قبل الاستحمام، والوقوف طويلًا أمام المرآة، تداعب شعرها، وتتفحص جسدها تحت قميص النوم الضيق.
بدا لها أن الدنيا تقبل عليها من جديد، الأستاذ ولا شك معجب بها كيف لا! وهو فنان راقٍ لديه من الاحساس ما ليس لغيره من العموم، كثيرًا ما كانت تمني نفسها بالحياة مع الأستاذ، الحياة العذبة في صحبة الشعر والتهيج السامي، يسمعها أشعاره فتسبح معه في علياء السماء.
كانت تسمع الست ليلًا بأذن جديدة، وتدندن معها مقاطع بعينها، عشقت قصيدة أغدًا ألقاك أكثر، بخاصة ذلك المقطع الذي تردده على الدوام (وأهلت فرحة القرب به حين استجابا).
ذات ظهيرة ترددت أصوت صاخبة في الشارع وكلاكسات سيارة تتعجل أحدهم، عندما نظرت من نافذة بيتها، كان الأستاذ واقفًا بجوار سيارة نقل كبيرة، وبعض من شباب المنطقة يحملون الحقائب ويضعونها في السيارة، عندما سألت عبلة جارتها المطلة من النافذة المجاورة، قالت الجارة:
يقولون أن الأستاذ سينتقل للاقامة مع ابنه المهندس الشاب، عقبى لك يا حبيبتي. أما عبلة فقد خيل لها أن أقسى جبال الأرض قد جثمت فوق صدرها، وبدا لها أن أرض المنزل تميد تحت قدميها، كانت السيارة تبتعد وتبتعد، أما هي فقد نشجت باكية، عضت على شفتيها كي لا تصرخ ويسمعها أحد، انسابت الدموع غزيزة على وجنتيها.
في هذه الأثناء كان ابنها يلعب الكرة، في صالة المنزل في مرح وحماس.
(محمد فايز حجازي)

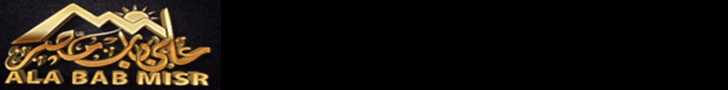

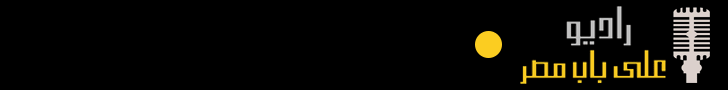

التعليقات مغلقة.