لغتنا العربية …إلى أينْ؟ ” مشكلات وحلول” إعداد د : آمنة مصطفى حسن مصطفى
لماذا الآن ؟
إذا ما عدنا إلى الوراء ، و بالتحديد إلى مطلع القرن الماضي ، و فتشنا في مكتباتنا المهملة – مع الأسف – عن تاريخٍ للعربية الفصيحة لوجدنا كماًّ من الأشعار و القصص و الروايات و المؤلفات على اختلاف أنواعها ، و المجلات و الصحف التي زخرت بشتى العلوم – بمعناها البحت – و التي كتبت بلغة عربية فصيحة …. و مع هذا اتهمت اللغة العربية في ذلك الوقت بأنها عقيمة و بأنها لا تساير العصر بالرغم من حالة البعث الهائلة التي عاشتها و ذلك الإنصهار الرائع الذي ظهرت آثاره في شتى الأجناس الأدبية ؛ إذ نقلت لنا حروفها روائع الأدب الغربي ترجمةً ومحاكاةً ، بل و ظهرت ألوان أدبية جديدة تماما كالقصص المسرحي و الشعر الحر مما يثبت أن العقم ليس في حروف اللغة بل هوفي حقيقة الأمر في يد من يمسك بهذه الحروف و لا يدرك حقيقتها الجوهرية و قيمتها المعنوية فشعورنا بها – و هذه حقيقة – ينعكس على أدائنا بها و استخدامنا لها وكلما آمنا بها أبدعنا ، و لست هنا أدَّعي إذ يشهدعلى قولي هذا رموز العصر من أمثال أمير الشعراء أحمد شوقي و حافظ إبراهيم والرصافي ونازك الملائكة و غيرهم من شعراء العربية المرموقين و رفاعة الطهطاوي و الشيخ محمد عبده و الدكتور طه حسين والعقاد والمازني غيرهم من أصحاب الأقلام الحرة في شتى المجالات على مستوى الوطن العربي آنذاك و ليس مصر فقط مما يدل على قدرة الشعوب إذا نهض الوعي لديها على الإبداع و إعادة الإحياء ذلك أن النبتة شديدة التجذر قد يجف بعض أوراقها و أغصانها إلا إن جذورها ثابتة إذا ما ارتوت اخضوضرت و أزهرت،فما بالنا بلغة القرآن الكريم التي تعهد المولى جل و علا بحفظها وفرَض على المسلمين في شتى بقاع الأرض – مهما كانت لغاتهم – أن يقرأوه بها ؟!
في الماضي كانت المحاولات الهدامة التي تدعو إلى التخلي عن اللغة العربية تلقى رواجا لدى القلة و ليس الكثرة و هم في غالب الأمر من العلمانيين و المنبهرين بثقافة الغرب و العاجزين عن سبر أغوار لغتهم و القدرة على التجديف بها في وجه الأمواج الضاربة الساعية لإسقاطها و التخلي عنها ….. فالأزمة هنا أزمة أشخاص و فئات إعلامية قليلة – ولهذه الفئة خطر كبير لو أساءت التوجيه -كجريدة (المقتطف ) والتي روجت في العام 1881م لكتابة العلوم باللغة العامية ودعت رجال الفكر والأدب لبحث اقتراحها ، ثم ظهر كتاب (لغة القاهرة )للقاضي ويلمور عام 1902م(1) والذي وضع فيه أسسا وقواعد للغتنا العامية !!!! وهنا تنبهت الصحف والمجلات التي ينتمي كتابها إلى فكر واعٍ إلى خطورة الدعوة ، فانتفضت في وجه هذه الدعوات الخبيثة والهدامة ،ولم يتوقف الأمر عند أصحاب الأقلام الشريفة بل ووقف إلى صفهم لفيف من أصحاب الفكر البناء أثروا الساحة اللغوية بمباحثهم على اختلاف اتجاهاتها ، ونبه شاعر النيل حافظ إبراهيم إلى الخطر المحدق الذي دعى إليه بعض رموز الإعلام المقروء من المنبهرين بالفكر الغربي الدخيل :
أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناة(2)
ولا يتسع المجال هنا للإحصاء بقدر ما أريد التمويه إلى أن اللغة في ذلك الوقت كانت لاتزال بخير، بدليل ما خلفه عباقرة التاريخ المعاصر من ثروات ثقافية تزخر بها المكتبة العربية وتتوارثها الأجيال لتتعلم منها وتتدارسها ، ولتؤكد على عودة العربية بقوة في ذلك الوقت ، وأنها ليست عقيمة لذاتها ،وأن حملة لوائها هم المسئولون قبل كل شيء عما قد يصيبها –ظاهريا – من ركود وخواء ثقافي، ذلك أن الإيمان الراسخ هو أساس الـنجاح؛ فلو آمنا بلغتنا وقدراتها الإبداعية لما انحدرنا بها إلى حافة الهاوية كما اليوم …… فنحن اليوم نعاني بشدة من أزمة حقيقية ليس على مستوى أشخاص أو جماعات دون أخر ،وإنما الأزمة أصبحت أزمة أمة بأسرها تعاني من كافة جوانب الضعف والمرض مما أدى إلى قصور شامل في كل شيء ؛ فنحن ببساطة شديدة تحولنا بإرادتنا وتكاسلنا واستنادنا إلى الحجج الواهية عن الاحتلال ومساوىء الاستغلال الأجنبي وغيره إلى مستهلكين حضاريين نشعر بنقص شديدة تجاه الآخر – لأننا أفقدنا أنفسنا الثقة بالنفس والتمسك بالأصول والمعتقد -للأسف الشديد -وتحول الكثيرون في مجتمعاتنا العربية عامة ومصر خاصة إلى مجرد لاهثين وراء المخترعات الغربية والتقليعات العجيبة الواهية ،وبات التشدق بألفاظهم ومصطلحاتهم التي يصدرونها لنا عبر الدراما ومختلف الأعمال المرئية علامة من علامات الرقي والتقدم ، وأصبح المتحدث ولو بجمل عربية فصيحة بسيطة من المعقدين والمتفلسفين والرجعيين!!!
ثم أضف إلى كل ماسبق أننا على وشك الوقوع في أعماق كارثة محققة تتمثل في نفور الأجيال الناشئة من لغتهم الأم والامتعاض من دراستها بتشجيع من آبائهم الذين يصرون بدورهم على ضرورة تعليم أبنائهم اللغات الأخرى؛ لأنها ذات مستقبل ومطلب رئيس لدى أسواق العمل العالمية ، ولأن الأجيال باتت تعاني من قصور واضح في التعبير بلغتهم فقد ركنوا إلى اختراع تركيبة غريبة لا ترقى لمستوى مصطلح اللغة مكونة من مجموعة من الحروف الأجنبية والأرقام التي ) بهدف التواصل بهاFranco Arab) يقابل كل واحد منها حرفا من حروفنا وأطلقواعليها ما يسمى بالفرانكوآراب
عبر شبكة الانترنت بمواقعها المختلفة ( الفبيس بوك – تويتر –مسنجر وغير ذلك) . كل ماسبق وأكثر يستحق منا الوقوف طويلا لا لتسجيل الأزمة والتفصيل والتحليل لأسبابها وعوامل تفشيها لدينا فقط ،بل و لفتح الباب على مصراعيه لتلقي الأفكار البناءة والحلول الفعلية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع ،سواء أكان على المدى البعيد أو المدى القريب ، ولقد سعدت كثيرا عندما أعلن اساتذتنا الأفاضل في آداب جامعة الإسكندرية عن مؤتمر خاص باللغة العربية لتناول كل ما يتعلق بها من مشكلات ومعضلات تقف في وجهها ،ولتدارك حالة الترهل المخيفة التي أصابتها بسبب تخاذل أبنائها المتكاسلين والمتساهلين بوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .
وعند بحثي في بعض المصادر من هنا وهناك لاحظت أن السواد الأعظم من أساتذتنا ومفكرينا قد فطنوا إلى الأزمة – كما سبق – منذ أمد بعيد ونبهوا إليها ، فهذا شوقي ضيف – وهو من هو – قد استنكر أن نكون الأمة التي تدرس لغات الأمم الأخرى في جامعاتها دون الاهتمام باللغة الأم وهويتحدث في كتاباته عن التجديد في النحو ، وهذا الدكتور طه حسين في مؤلفاته المعروفه – وبخاصة في الأدب الجاهلي – قد نبه إلى ضرورة التطوير التي يتناسب وظروف العصر ،أي ضرورة المواكبة والمعاصرة لأنلغتنا طيعة قابلة للاشتقاق والتطوير شريطة أن تجد المتحدث اللبق والماهر ، والدليل على هذا أن شعراءنا كأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم قد استخدموا اللغة بجزالتها وفخامتها لتصوير المخترعات الحديثة ولم يخفقوا في ذلك(3) مع ارتباطهم بتراثهم ،ثم تلاهم أجيال من الشعراء المطورين على مستوى الموضوعات والاتجاهات حتى وصلوا إلى التجديد الأكبر وأقصد به ( شعر التفعيلة ) ولم تبخل عليهم العربية فقد منحتهم الألفاظ التي يحتاجونها جزلة كانت أم سهلة لينة فأثمرت لنا شعرا رائقا لازلنا – الذواقة منا فقط – كلما قرأناه شعرنا برونقه وبهائه ، وخرج علينا المترجمون الأكفاء لينقلوا لنا آداب الغرب وثقافتهم بلغتنا الفصيحة – وليس العامية – فكانت كفؤا لذلك لأنهم ببساطة شديدة آمنوا بها وعاشوا معها فمنحتهم ما لا يمنح لغيرهم ( القدرة على الإبداع والتعبير بصدق ) ثم إذا انتقلنا إلى الصحف العربية في ذلك الوقت نجدها وقد قامت بدوركبير لنشر الثقافة (القديمة والحديثة ) ومختلف العلوم باللغة العربية الفصيحة – في معظم الاوقات – وكان شعراء ذلك الوقت يتبارون لنشر أشعارهم في هذه الصحف التي كان الشباب يتلقفونها فيما يشبه الذي ينتظر كنزا من الكنوز ليحصل عليه ، أما اليوم أصبحنا لا نجد مثل هذا في صحفنا اليومية ،ولا يستطيع أمثالي الاستماع إلى نشرة الأخبار بالعربية إلا ويجد نفسه عوضا عن التركيز فيما تحمله النشرة من أخبار يقوم بتصحيح الأخطاء الفادحة التي يقع فيها المذيع أو المذيعة. وعلى صعيد آخر باتت لغة التعامل اليومية في الشارع العربي تحتوي على مصطلحات أجنبية كثيفة ليس من باب التأثر والتأثير بقدر ماهي من باب التشدق والتأكيد على ( الثقافة ) و( الرقي ) بينما أصبح المتكلمون باللغة العربية في أبسط صورها ( متخلفون ) و(رجعيون ) وأصبح مذيعو البرامج العادية في التلفاز والمذياع يتشدقون بلغة عامية بحته مغلفة بمختلف الالفاظ الأجنبية من باب ما أسميه بـ ( الاستظهار الثقافي) وهذا يعكس بجلاء مدى الحالة المتردية التي وصل إليها الناس في مجتمعنا فكريا وثقافيا …..فالثقافة بمفهومها الحقيقي غير موجودة البتة في خريطة الفكر العربي مع الاسف الشديد.
من أين نبدأ؟
لكي نضع الحلول لمشكلة ما لا يكفي أن نحيط بجوانبها ،وأن نفصل لأسباب حدوثها وعوامل ظهورها، بل نحن بحاجة ماسة إلى وضع أيدينا على الأسباب العميقة والمتأصلة في مجتمعنا والتي تتمثل في عادات ورؤى خاطئة استمرت ووجدت لها رواجا لدى قطاع عريض من الناس وتسببت في تفشي الأزمة بشكل فادح يمكن لأي دارس مبتدىء أن يلاحظه بسهولة ،إذ أصبح الناس يزدرون المتحدث بلغة عربية فصيحة وينعتونه بصفات الغابرين سخرية واستهزاءً يعكسان مدى الجهل والجهالة في مجتمعاتنا ،ومدى اتساع الهوة بين حاضرنا وماضينا .
أولا : تعديل رؤيتنا الخاطئة لمصطلح الثقافة:
لحل الأزمة في نظري لابد أن نقوم بتعديل وتصحيح الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها مجتمعاتنا العربية منذ وقت طويل وعلى رأسها رؤيتنا لمفهوم مصطلح ( الثقافة ) لأن هذه الرؤية الخاطئة هي أحد الاسباب الرئيسة التي أوصلت اللغة إلى مرحلة التردي التي نعيشها الآن ، فالثقافة كلمة يسيء فهمها قطاع عريض في مجتمعاتنا العربية وبخاصة مصر ؛ إذ هم للأسف الشديد يكتفون بالحديث عنها كالببغاوات ويدعون امتلاكهم لمادتها ،بينما على صعيد التطبيق والتعايش الحضاري الحقيقي لا نجد أثرا للمصطلح بمعناه الحقيقي ، فكلمة (ثقف ) في قواميسنا العربية الرائعة تعني (شحذ السيف وتهذيبه )(4) وبمرور الوقت تبدل الاستعمال اللغوي وتطور إلى ما معناه جلاء ما يعلو العقول من الأصداء المعرفية ،وللأسف فإن هذا القطاع العريض لايجلو الأصداء فقط لينير بصيرته وإنما يمحو مع هذا الجلو الثقافي – الذي يعتقده – علاقته بلغته الأمويقتلع جذوره الحضارية والثقافية الأصيلة التي اكتسبها بحق انتسابه لأرض العرب اعتقادا – واهيا – منه أنه بهذا سيصبح شخصا متحضرا ومستنيرا يواكب عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي ،وكأننا في الماضي – نحن أمة العروبة والإسلام – لم نصنع مجدا حضاريا وعلميا هائلين في شتى المجالات !
في الماضي عندما انفتحت أمة العرب على الشعوب والحضارات الأخرى كانوا هم حملة النبراس الفكري والعلمي بفضل الدعوة الكريمة في القرآن الكريم : { اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم .}(سورة العلق) وقوله تعالى في موضع آخر : { وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}( من سورة الحجرات) وكان نتيجة التعارف الإنساني تمازج ثقافي هائل قام أجدادنا الكرام بنقله لنا فتعلموا لغة الآخر ليفهموه ويحاوروه فنتج عن هذا ظهور علماء أفذاذ تنبهوا لخطورة الاختلاط بالآخر والانصهار معه ،فنتج عن هذا الخوف والحذر عِلمي اللغة والكلام ، وأصبح عندنا رواة للشعر ورواة للحديث الشريف ورجال ثقات وآخرين مدلسينوواضعين لأصول القواعد العربية ….وهكذا . أي أن الله تعالى سخر لكتابه الكريم الذي فرض قراءته على كل مسلم ومسلمة في شتى بقاع الأرض باللغة العربية الفصحى أناسا يحفظون لغته وينقحونها ويطورونها ويتدارسون خباياها وأحوالها التركيبية على مر العصور التي سبقت نزول القرآن الكريم ،والتي تلت الثورة الحضارية الهائلة الناتجة من اختلاطهم بالآخر الفارسي أو الرومي أو التركي ……….إلخ وكانت جامعات العرب الشهيرة –إن جازت التسمية – في حواضر العلم والثقافة كبغداد حيث دار الحكمة ، والأندلس حيث حاضرة قرطبة الشهيرة في زمانها تمنح الإجازات العلمية ( الشهادات ) بعد أن يتعلم الوافد الأجنبي اللغة العربية ويتقنها ليتمكن من قراءة كتب المواد العلمية المكتوبة بالعربية ويتلقى العلم على يد الأساتذة الكبار والمتخصصين من علماء الأمة العربية والإسلامية في ذلك الوقت ، أي أننا – مع الحسرة والأسف الشديدين – كنا من يصدر العلوم والتكنولوجيا العصرية لذلك الوقت ،وكانوا يقرأون ويبحثون ويترجمون كتب الآخر ليتعلموا منه فيضيفوا أو يصححوا الأخطاء ،ويحضرني ما كتبه الجاحظ من تنبيهات ووصايا للمترجمين العرب في كتابه المعروف (الحيوان ) لأن هذا الكتاب يعكس بصدق شديد كل ما يمكن للباحث أن يقوله هنا – عن علاقة العربية بالثقافة – فهو يفصل في أكثر من موضع فيه لقيمة اللغة العربية وفضلها على اللغات الأخرى – وليس في هذا عنصرية أو إجحاف للغات الأخرى – لأنها ببساطة متناهية لغة عالمية لكونها لغة القرآن الكريم ومع هذا فهو يتحدث بلغات أخرى منحته ميزة الاطلاع على موروثات الأمم الأخرى فنقلها لنا بعد أن أضاف لها ،أو صحح لأصحابها – كما فعل مع آراء أرسطوطاليس مثلا- ونبه إلى الأخطاء العلمية التي قد نقع فيها إذا ما وقعنا فريسة للترجمة الخاطئة!! . كل هذا وأكثر كتبه رجل عظيم من رجالات القرن الثاني الهجري في زمان لم يكن الناس يتواصلون فيه بأكثر من الرسائل المكتوبة على رقع الجلد أوأوراق البردي المصرية ، وكانت وسائل المواصلات في زمانهم من الأنعام التي كانت تنقل البضائع والرسائل والكتب شديدة الثقل لأن ليست مطبوعة كما هو حال الكتب في ايامنا هذه ،وبالرغم من الصعوبات التي كانت تواجه نقل الكتب من مكان لآخر، بالإضافة إلى أسعارها الباهظة أحيانا لوكانت تحمل جديدا ،كان الجاحظ يفتش عنها في كل مكان ليشبع حالة النهم الفكري والعلمي التي كان يعيشها وأمثاله في ذلك الوقت ،وكان يبيت في دكاكين الوراقين ،وينتظر القادمين من الشعراء والرواة إلى سوق البصرة الشهير ( المربد) ليحصل منهم على معلومة جديدة في كل مرة ويتدارسون الشعر وغيره، أي أنه كان يقوم بعملية جلو فكريحقيقي لعقله وهذا بالضبط ما يجب أن نعود إليه . فما قام به الجاحظ وأمثاله في ذلك الوقت هو عملية جلو ثقافي حقيقي ؛ إذ لايكتفي بالقراءة أو الاستماع ،وإنما يقيس ما يقرأه بغيره من المعلومات فيأخذ ما يراه صوابا أو نافعا ويترك ما يشعر بتناقضه – كقصص البحارة والصيادين مثلا في إشاراته عنهم في الحيوان (5) – أو منافاته للعقل والمنطق ،وبطريقة أخرى هو لم يكن إمعة أو ببغاء بل كان مفكرا حقيقيا يعمل عقله في كل ما يقرأ ويسمع ويمعن النظر فيما يجربه ولا يساير أي صيحة جديدة من صيحات المجتمع بل يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره.
واليوم نحن أبناء الأجيال الحديثة انسلخنا تماما عن كل ما خلفه لنا الجاحظ وأمثاله من فكر وحضارة وثقافة حقيقية –وهولعمري ميراث هائل وضخم – وتركنا للآخر مهمة الاستفادة من هذا التراث الهائل فتعلم لغتنا بداية ليقرأما عندنا ويصنع به مجدا حديثا صنعه أجدادنا قبله منذ قرون، ويتعامل معه كما تعاملوا من قبله ،حيث أخذوا منه ما ينفع ويفيد –إن جاز التعبير – أما نحن فاكتفينا بحبس أنفسنا وتقنين مستوى الرؤية لدينا حتى باتت لا تتعدى بوتقة الماضي السحيق والتباهي به وبإنجازاته متناسين أو متجاهلين قول الشاعر:
كن ابن من شئت واكتسب أدباً يغنيك محموده عن النسب
فليس يغني الحسيب نسبته بلا لســان لـه ولا أدب
ليس الفتى من قال كان أبي ولكن الفتى من قال ها أنا ذا(6)
وقد نبه الدكتور طه حسين إلى خطورة التبعية الغير بناءة للماضي ،ونوه إلى إلى ضرورة التطور بما يساير العصر في مقدمة كتابه المعروف (في الأدب الجاهلي) ذلك أن لغتنا الرائقة بألفاظها والمرنة بقبولها لكثير من لغات الغير وأنصارها فيهاقادرة على المسايرة والمواكبة بكل جدارة،ولكن المشكلة تكمن فينا وليس فيها ، وفي تعصب البعض بشدة للبقاء حيث هو في مقابل آخر يريد الانسلاخ التام عن كل ما هو قديم وقيم ، لهذا ثرنا في ذلك الوقت وأحدث المتعصبون منا ضجة هائلة دون التروي والتدقيق في كنه المسألة ،ودون الانتباه إلى أننا أمة متوسطة في كل شيء ،فالمفترض أن نكون لا إلى هذا أو ذاك.
نعم نحن نعاني من مرض عضال أسميه ( الخواء الفكري والثقافي ) ،ولأننا نعاني منه بشدة قمنا بارتكاب خطأين فادحين :
الأول : نظرنا إلى ماضينا بكل مافيه من أصالة وحضارة حقيقية على أنه قديم وبالٍ ولايرقى لمستوى الحاضر الذي نعيشه بحجج أهمها أننا انقطعنا عن اللحاق بالركب بسبب احتلال الأمم الأخرى لنا ومحاولاتها لعزلنا عن الخارج الجديد ، ولهذا نحن نعاني من الخواء الفكري وبحاجة ماسة لملء الخانات الفارغة ( بإرادتنا العاجزة والعمياء).
الثاني: قمنا بالفعل لسد العجز – ولم نحاول فقط – بتكديس شتى أنواع المعارف والعلوم والافكار القديمة والحديثة في مكتباتنا العادية والالكترونية وتفاخرنا باقتنائنا لها ولم نتقدم خطوة أخرى بعد ذلك لأن هذا يتنافى وشعورنا بالنقص وبقلة قيمة ما نملك فهو ليس أكثر من حلية ندعي بها أننا مثقفون ومطلعون ( من باب الإزاحة الثقافية) .
وقد يثير البعض موضوع العزلة والانقطاع عن العالم بسبب توالى الأمم المحتلة لأراضينا العربية ،وأن هذا يعد أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت الناس ينزعون إلى الثقافات الغربية فينهلون منها ويسدون حاجاتهم للتطور والتقدم والتماشي مع غيرهم ….. هذا صحيح إلى حد ما ولكنه ليس بحجة دامغة لتبررالوضع الذي نحن فيه . صحيح أننا عشنا زمنا في ظل الاستعمار العسكري لكن مع الأسف نحن اليوم نعاني الويلات من الاستعمار الفكري الذي استجلبناه بجهلنا وضعفنا وعدم ثقتنا فيما هو كنز لنا ،واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير،في الوقت الذي تعتد فيه كثير من الشعوب والحضارات الأخرى بثقافاتها ولغتها الأم ولا تتنازل عن تعليمها للأجيال القادمة لتحافظ على ارتباطها بجذورها الراسخة في قلب التاريخ ،فهذه الصين – مثلا – تتعامل بحزم مع المواقع الإلكترونية الأشهر في العالم (جوجل ) بهدف حماية القيم والثقافة الصينية بل وقد اتهمت – كما هو معروف عبر الصحف والمجلات العالمية- جوجل بمحاولة نشر القيم والثقافة الأميريكية عبر موقعها وأن هذا يؤثر على فئة الشباب لديها(7) بينما نحن نتشدق وغيرها من الطرق الأخرى كالإنجليزية والألمانية ….إلخ .(The American Way)بكوننا نعلم أبناءنا بـكل فخر
وهذا وإن دل فلا يدل سوى عن عجز مطبق وشعور مخيف بالنقص ،ولا أنسى ما حييت –وأنا من معلمي اللغة العربية في إحدى المدارس القومية- أحد أولياء الأمور الغاضبين من كوني أتحدث إلى أبنائهم باللغة العربية الفصيحة ،وقد أخذت تتشدق بكونها ألحقت أبناءها ليتعلموا الطريقة الأميريكية وأنهم طوال الوقت يتحدثون في المنزل باللغة الانجليزية ،ويا ليتها نطقت الكلمة بشكل صحيح وإنما نطقتها بصوت( لكنة ) ينم عن جهل واضح باللغة الاجنبية وإنما هو من باب الإزاحة الثقافية وأن العربية لا ترقى الآن إلى هذا المستوى الثقافي العالمي!!
إذن فالثقافة بمفهومها الواسع والحقيقي هي شيء بعيد كل البعد عن العقلية العربية التي تصر على استيراد المعلومة من الخارج لا التأسيس لإيجادها ،وتصر على أنها عاشت في فترات متلاحقة من الظلام والجهل وأنها لن تقوى على المنافسة الفكرية والعلمية مع الآخر ،فهي عقلية متقهقرة متراخية وخانعة تتزيا بأزياء الغرب وتتناول طعامهم وتتحدث بلغتهم اعتقادا منها بأنها هكذا ستصبح في إطار المثقفين .
وجانب آخر من جوانب حياتنا الحضارية يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل التأسيس الثقافي في مجتمعنا ألا وهو العامية التي باتت تنافس الفصحى وتزاحمها حتى فيما تميزت به عبر قرون كالشعر والنثر والقصص …إلخ لدرجة أننا نجد الآن دواوين شعرية كثيرة ورائجة جدا في نفس الوقت باللهجة العامية ، وهذا معناه أن مثل هذه الاعمال بكل ما فيها من حسن وسيء ستصبح مصدرا من مصادر الترويج الثقافي في المجتمع ،وهذه مسألة خطيرة يجب على الرقابيين وأصحاب الفكر التوعوي والتعليمي الانتباه لها جيدا لأنها بالفعل باتت تؤثر بشكل عملي في عقليات كثير من أبناء الجيل الناشىء، وأصبح التشدق بألفاظ بعض الفئات ( البلطجية ) في المجتمع من باب الثقافة الرائجة والمتقبلة !!! وأصبح المؤلفون يضعون أغانيهم – بعد أن كانت تكتب بلغة رائقة هي أقرب ما يكون للفصحى السلسة – بهذه الألفاظ النابعة من أسوأ البيئات في المجتمع لتعبر عن مستوىً ثقافي متدنٍ إلى أقصى درجة.
فالمنتظر منا أن نعيد النظر في محتوانا الثقافي الحديث – إن كان لدينا ما يخصنا بالفعل – ونقوم بتنقيحه وتصفية الشوائبالعالقة به – وما أكثرها – ونقوم بإعادة إحياء للثقافة خاصتنا في إطار عصري حديث ، فاللغة التي عاشت ما يزيد على الـخمسة عشر قرنا قادرة تماما على النهوض بهذه المهمة شريطة النهوض الذاتي في أعماقنا بها والإيمان بقدراتها، وإلا كيف اصطفاها رب العباد لتكون لغة لكتابه ؟!!
والمهمة ليست بالسهلة ولا اليسيرة ولكن مع وضع الخطط وتكاتف كافة القطاعات المجتمعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يمكن أن نحقق أفضل النتائج ،ولو نظرنا من حولنا إلى غيرنا من الأمم كالهند – مثلا – لوجدناهم وقد مروا بأوقات عصيبة شبيهة بتلك التي مررنا بها ،ومع ذلك نجدهم اليوم وقد ارتقوا بلغاتهم – وهي تزيد على الألف- جنبا إلى جنب اللغات الأخرى ،وقد بدأوا يصدرون ثقافاتهم ويعتنون بها أيما اعتناء فنراهم يبثونها عبر الدراما التي كلف بها أبناء الجيل الحالي من شعوبنا العربية ، بينما نسخر نحن من رموزنا العلمية والدينية ونحط من شأنهمفي أعمالنا الدرامية المقدمة ! ونتحول إلى معول للهدم لا للبناء.
ثانياً: ضرورة العودة إلى القراءة :
نحن أمة (اقرأ) أصبحنا ببساطة شديدة لا نقرأ ، وإذا قرأنا نبحث عما هو مسف أو مكتوب بالعامية استسهالا لعدم إعمال العقل وإدراك المحتوى من باب الكسل الفكري ،وهروبا من عدم قدرتنا على التعامل بلغتنا الأم،ثم إذا ما نظرنا إلى صحف اليوم ومجلاته نجد المساحات المخصصة للأدب والثقافة الخاصة بالعربية تحديدا ضئيلة جدا في مقابل ما يكتب بالعامية ،وهذه مصيبة في نظري ، لأن الذي حمل لواء النهوض بالعربية في بدايات القرن الماضي كان هو الصحف والمجلات والكتب المطبوعة ،وكانت الصالونات الأدبية المعروفة تضم لفيفا ممن يستحقون لقب (المثقف الواعي ) ويتدارسون ما قرأوه في صحف تلك الأيام أويتبادلون الآراء في قصيدة من القصائد المنشورة ،وتطور الأمر فيما بعد لنجد إصدارات أدبية خاصة منها ما توقف ومنها ماهو مستمر حتى يومنا هذا ( كمجلة فصول في مصر مثلا ) وكان الناس يعرفون أسماء الشعراء والأدباء ويتناقلون بعضا من آرائهم ،بينما اليوم لا نجد مثل هذا لافي صحفنا ولا بين طبقات الشباب في المجتمع .
وقد يشير البعض إلى أننا في عصر السينما والتلفاز والبرامج الترفيهية وغير ذلك مما يستقطب الفئات الشابة والمراهقة ،وهذا صحيح جدا ،فما المانع لو استفدنا من هذه المخترعات لتطوير عقول أبنائنا بما ينفع ويجدي ،فنعيد بث الفكر والثقافة الأدبية عبر الصحف والمجلات ،وبث برامج التوعية عبر أثير الإذاعات والتلفاز بدلا من إظهار المثقفين بمظهر بالٍ وساخر في أفلامنا ومسلسلاتنا المقدمة بوعي أو بدون وعي؛ لأن هذا من شأنه ان يعكس حالة نفسية تزدري أمثال هؤلاء في أرض الواقع ، وقد أثبت التاريخ الحديث بما لا يدع مجالا للشك أهمية التكنولوجيا بشتى ألوانها ومواقع التواصل الاجتماعي في تعبئة الرأي العام وتوجيهه إلى الوجهة التي تريدها البرامج المبثوثة عبرها .
ويقع على عاتق القطاعات التعليمية في مصر جزء كبير في هذه المسئولية ،إذ يمكن إنشاء صالونات أدبية خاصة بالطلبة والتلاميذ في كل من الجامعة والمدرسة لتفعيل قيمة القراءة للقيام بدورها في بناء الشخصية العربية السوية ، وعلى أساتذتنا الكرام تقع مسئولية انتخاب المحتويات المناسبة لأعمار المشاركينمن أبنائنا وبث روح التنافس الفكري وترك مجال الحرية واسعا للتعبير عن آرائهم فيما قرأوه وفهموه ، كما يمكن عمل المسابقات المختلفة للتأليف الشعري ، القصصي أو المسرحي، وقد بدأت بالفعل مثل هذه الفعاليات في جامعة الإسكندرية حيث نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب مشكورا مسابقة للشعر بين الطلبة لهذا العام (2017م)، وهي بادرة طيبة جدا حبذا لو استمرت وتم تفعيلها في جميع الجامعات ،وكذلك يجب تفعيل دور المكتبة المدرسية وبث روح القراءة لدى التلاميذ من خلال إقامة المسابقات المكتبية التي تحدد محتوى معرفي يتناسب وأعمار المشاركين من التلاميذ ،ثم يطلب منهم قراءته وتلخيصه بأسلوبه الخاص ومنثَمَّ إبداء الرأي فيما تمت قراءته ،وتنتهي المسابقة بجوائز قيمة من القصص والكتب المطبوعة باللغة العربية الفصحى وليس العامية. فنحن بحاجة لأن نعيش بلغتنا ،أي أن نمارس حياتنا بها كأي أمة طبيعية خالية من الإعاقات الفكرية الصدرة ،فقد آن الأوان أن نخلع عباءة الانبهار بالغربي والتي ارتديناها طائعين – مع الأسف – مع بدايات النهضة التي استجلبها لنا الخديوي إسماعيل من أسرة محمد علي فانكببما على كل ماهو قادم ومستورد دون أن نميز الغث من الجيد ،كالأعمى يقوده الآخرون لا يدري أي الطرق المستقيم ؛لأنه ترك اعتماده الكلي على القائد!!
إن تنمية حب القراءة لدى الأجيال الناشئة من شأنه أن يضيق الهوة الواسعة بينهم وبين لغتهم وبالتالي ثقافتهم الأم ،ولكي نساعد على تطبيق هذا يجب أن تكون برامج الأطفال بالتحديد مقدمة باللغة العربية ،وعن تجربة حقيقية لأنني – كفرد عربي قبل أن أتخصص في اللغة – تعلمت اللغة على أصولها – كما يقولون – من خلال الاستماع إلى برامج الأطفال المدبلجة بالعربية الفصيحة في ذلك الوقت، والأمثلة كثيرة جدا (كبرنامج افتح يا سمسم ) الذي يعرض في دول الخليج بالفصحى منذ الثمانينات في القرن الماضي ، فهو في مصر يعرض بالعامية للأسف الشديد ،وكثير من برامج الأطفال ذات الأفكار البناءة إنما تقدم الآن بالعامية الخاصة بكل دولة مما يؤثر بشكل سلبي على مسامعالصغار إذ يستمرئون العامية وينفرون من الفصحى في أبسط صورها ،وهذا يقودنا إلى ضبط أهم الوسائل التي من شأنها الثأثير بشكل مطلق في جموع الجماهير العريضة : وسائل الإعلام
ثالثا : ضبط اللغة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الالكترونية:
اصطلح كثير من المفكرين والأدباء على تسمية مانستمع إليه اليوم في وسائل الإعلام بـ (العامية الفصحى ) خصوصا فيما يتعلق بنشرات الأخبار ؛ إذ المدقق فيما يستمع إليه يفاجأ بكم هائل من الأخطاء اللغوية المتعلقة بالضبط وسوء قراءة المقال الإخباري ،مما يؤكد على أن الخلفية التأسيسية لإعلاميي اليوم ليست كما كان أسلافهم في الماضي، فالمادة التي يقدمونها لنا مشوهة بمعنى الكلمة ،فكثيرون منا يشعرون بالأخطاء وهي تطن في آذانهم فنرى المذيعين وقد رفعوا المفعول به ونصبوا الفاعل…..إلخ ،وهذه طامة كبرى نبتعد عنها بإغلاق التلفاز أو تغيير القناة ، أما البرامج الأخرى فقد تحولت تماما إلى العامية وتم مزجها بكثير من الألفاظ الاجنبية – التي تنطق أيضا بشكل خاطىء – لأنهم ببساطة لا يقدرون على التحدث ولو بجملة واحدة فصيحة نظرا لضعف خلفيتهم عن اللغة الفصيحة ،ويمكن تدارك هذه الأزمة بتنظيم دورات تأهيلية في اللغة فيما يتعلق بالإعلاميين الحاليين ،أما الإعلاميون الجدد فقد آن الأوان أن نشترط إجادتهم للغة الفصيحة إجادة تامة لقاء تقديمهم للبرامج ،وهذه أبسط الأمور التي تليق بإعلام هادف يعبر عن ثقافة خاصة بأمتنا العربية وليس عن فكر مشوه وموجّه من خلال شعورنا النفسي بالنقص وتبعيتنا بإرادتنا العاجزة للآخر.
أما صاحبة الجلالة فقد وصل بها الأمر بعد تاريخ طويل ومشرف حملت فيه لواء العربية الفصيحة بصدق وساهمت في معالجة قضاياها خطوة بخطوة وشبرا بشبرإلى مستوى لا يرغب أحدنا في تقنينه أو وضع مصطلح لتوصيفه ، فالمتصفح لإحدى كبريات الجرائد العربية بصفة عامة لا يجد أثرا للفصحى ولا حتى لما يطلق عليه (لغة الصحافة ) وهي في أساسها فصيحة ولكنها تعتمد على أسلوب معين في الصياغة، وجلّ ما سيقابلنا ونحن نقرأ هو مجموعة هائلة من الألفاظ والمصطلحات الدخيلة ممزوجة مع كم ليس بالهين من ألفاظ العامية مضافا إليها أخطاء نحوية ولغوية صارخة تعكس الإهمال المتعلق بالمصحح اللغوي أو ما يطلق عليه في عالم الصحافة (المدقق اللغوي)وربما يعتمد هؤلاء اليوم على ما أشرنا إليه آنفا من أننا أصبحنا أمة لا تقرأ وإذا قرأنا لانعي أو ندرك القيم من الغث في قراءاتنا …
في الماضي كانت الصحافة تعتمد أساسا على أسلوب خاص متفرد أثبت بجدارة قدرة اللغة على التكيف والمرونة فلم تبخل على الصحفيين الذين هم في الأساس من الأدباء ومنحتهم ألفاظا وجملا ومصطلحات ،ولأن صحفيو الماضي كانوا من الأدباء فقد أفردوا صفحات عريضة للمساجلات الأدبية والمناقشات السياسية وأصبحت هذه الأمور هي الهدف الأول للصحافة ،فهي صحافة متعمقة هادفة ، بينما اليوم نحن نواجه بكمية هائلة من الصحف والتي تقوم على أساس صحافة اللقطة، وعلى أساس رواجها الذاتي بغض النظر عما يمكن أن تحمله من رسائل وأهداف ،وأدى هذا إلى الانحدار باللغة لتتناسب ومستوى اللقطات السريعة والأخبار الخاطفة ،وبالطبع فإن جمهور صحافة اللقطة لا يرقى لمستوى جمهور الماضي التابع لصحافة العمق والفكر البناء ، وكذلك فإن المساحات المخصصة للأدب فيها لم تعد كما كانت في الماضي بل اتسع المجال للشعر الشعبي والقصص الشعبي في مقابل تراجع مخيف للشعر الفصيح ،ويكفينا أن نفتش في أرشيفات صحفنا العريقة كالأهرام والمقطم والمقتطف ….لنقف على مستوى اللغة المكتوبة في ذلك الوقت، ولهذا نحن بحاجة لتدخل المسؤولين مع تكاتف الجماهير لتدارك الأزمة وذلك من خلال :
1- النهوض بمستوى الصحفيين وإقامة دورات تدريبية ترفع من مستوى اللغة التعبيرية لديهم ،
2- وضع رقابة حقيقية من قبل القائمين على عملية طبع الجريدة ؛إذ لابد من مرورها أولا عبر مدقق لغوي حقيقي لضبط الألفاظ والأسلوب بصفةعامة ،وأن يكون المدقق نفسه مؤهلا بالفعل لهذه المهمة.
3- ولأن الجرائد تعد من أهم الوسائل الإعلامية التي ساعدت على إحياء اللغة والتراث العربي ، بل وساهمت في نقل التطورات التي لحقت بموروثاتنا الأدبية، وكانت أول من ساهم في عرض الأشعار العربية الفصيحة ،ودشنت لظهور ألوان من الأدب الجديد كالقصة القصيرة والشعر الحر وشهدت ساحاتها معارك أدبية طاحنة على مختلف الأصعدة….. كل هذا وأكثر كان من نصيب الصحافة أن تسهم في نشره وتعرف الناس به ، لهذا يجب أن تعود الصحافة لتقوم بذات الدور وتترك المجال لأصحاب الفكر البناء والأقلام المتفردة ، وأن تشجع على تبني المواهب الأدبية الخلاقة .
:(Franco Arab) ظاهرة الفرانكو آراب(8) –
لا أحد يرفض التطور أو التقدم العلمي أبدا ،وهذا ما دعا إليه ديننا الحنيف في أكثر من موضع في الكتاب الكريم ،كقوله تعالى [ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ] ، ولهذا فإن استخدام التكنولوجيا بما يساعد في عمليات التواصل والاتصال والتبادل الثقافي (بحذر) والعلمي والتكنولوجي هو أمر طبيعي ومحمود ،وقد تختلف لغة التواصل من بلد لآخر لكنها تظل في النهاية لغة معروفة لها قواعدها الخاصة بها على مستوى الصوت والكتابة ، أما أن نوجد مزيجا غريبا من الأحرف والأرقام ونروج له من باب الاستسهال أحيانا ، والتماشي مع ماهو رائج أحيانا أخرى ، فهذه مشكلة خطيرة غير محمودة العواقب ، لأن متبنيها بكل بساطة يمحو ما تبقى له من ملامح هويته وانتمائه المتمثل في حروف لغته ،والأمر الأكثر خطورة هو إقبال الجيل الناشىء على استخدام هذه الطريقة التي لا ترقى لمستوى اللغة بحجة أنها سريعة وسهلة وخالية من التعقيدات ، ففي استطلاع للرأي شمل فئات عمرية مختلفة عن استخدام هذه الظاهرة كطريقة في التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعية كانت النتيجة موزعة بنسبة 40% يكتبون بالطريقتين ،أي اللغة العربية أو بطريقة الفرانكو آراب بحسب اللغة التي ضبطت بها لوحة الكتابة على أجهزتهم ،أي أنهم لايمانعون ولا يجدون ضيرا في ذلك!! بينما أكثر من 40% يستخدمون طريقة الفرانكوآراب لأنها سهلة وشبابية!! ولأن اللغة العربية ( مزعجة ) تستغرق وقتا للتعبير بها !! وأما النسبة الباقية فقد توزعت بين متخصصي اللغة من الجيل القديم وليس الحالي بالتأكيد ،وبين أناس ممن يمكن أن نقول أنهم يحتفظون بقيم العربية الفصيحة لأنهم حصلوا في الماضي على تأسيس جيد لها في مدارسنا ،ولهذا نجدهم لا يستسيغون التعامل أوالتواصل بهذه الطريقة.
و من النسب السابقة نستشف فداحة الموقف وخطورة التغاضي عنه ،وهي ظاهرة عامة في جموع الأقطار العربية ،أي أنها بحاجة لتدخل فوري على صعيد التوعيه وتوجيه فكر الشباب لما هو قادم ،فاللغة هي الهوية ووعاء الأمة الذي يحتضن ثقافتها وتراثها ويمثلهما خير تمثيل ،فإن ضاعت اللغة ضاعت الهوية وأصبحنا كالهوائم بلا جذور تثبتنا بالقاع كلما تلاطمتنا الأمواج ، وأخطر ما في الأمر أن الذي دعا لهذه الظاهرة الهدامة هم أبناء الامة العربية أنفسهم مما يعكس تردي مستوى انتمائهم للغتهم وعدم احتفائهم بها وإدراكهم لأهميتها الدينية والقومية لهم ، والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه هنا لماذا انحدر شبابنا إلى هذا المستوى من سوء تقدير لغته ونفوره منها ؟!!
إن طرح الحلول الفورية لمثل هذه المعضلة متعذر جدا لأنها هنا تتعلق بتراكمات تأسيسة منذ الصغر يكتسبها التلميذ أو التلميذة بمرور الوقت فتتأصل وتصبح جزءا من سلوكياته اليومية ، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان المؤسس على مستوى الأسرة مقتنعا بعقم لغته الأم وضرورة التخلي عنها لضمان مستقبل أبنائه!!!! لهذا يجب النظر لحل هذه الأزمة بصورة مستقبلية على المدى البعيد ،أما الوضع الحالي فهو بحاجة لنشر برامج توعوية بصورة ملحة لتدارك الأمر قدر المستطاع ، ثم القيام بتقديم برامج تدريبية تتيح لهم استخدام اللغة العربية بسهولة ويسر عبر لوحات الكتابة بأجهزتهم ؛ لأن الذي اعتاد الكتابة والتحدث طوال الوقت باللغة الثانية منذ نعومة أظافره يلاقي صعوبة بالغة في الكتابة بها عندما يكبر، على عكسنا تماما حيث تعلمنا في المدارس والمنزل أولا مبادىء الكتابة بلغتنا الأم فعبرنا بها وكتبنا حروفنا الأولى بها ،حتى إذا ما اشتد عودنا واتقناها تلقينا في مرحلة تالية لغتنا الثانية واتقناها بالفعل حتى أصبحنا نتحدث بها – عند حاجتنا لها وليس من باب التشدق – بطريقة أفضل من خريجي اللغات في أيامنا هذه!! فالمسألة مسألة تأسيس وخطط تعليمية منظمة قد يكون بعضها قديما ولكنه أثبت نجاحه في مقابل خطط اليوم الفاشلة في أغلبها،لأنها تعمل على محو الهوية دون أن تشعر بفرض تعليم اللغات الأخرى في سن مبكرة جنبا إلى جنب مع اللغة الأم ،خاصة وأن أعداء العريية وأصحاب الأفكار الهدامة قد تلقفوا هذه الظاهرة وحاولوا تيسير التعقيدات التي تحملها لأنها ليست لغة وليس مما يمكن توصيفه وقاموا بوضع بعض البرامج التي تسهل على المستهترين من شبابنا التعامل بها والاستغناء بها عن لغتهم كبرنامج (مارين ) الذي أطلقته شركة مايكروسوفت لترجمة ما أسموه بلغة الفرانكو ،وكذلك أطلقت جوجل خدمة (جوجل تعريب ) لنفس الغرض مما ينبىء بكارثة محققة( 9)تستدعي تدخلا شيبها بذلك الذي اتخذته الصين مثلا لحماية هويتها ومستقبل أمتها.
رابعا : ضرورة النهوض بالتربية والتعليم :
لطالما ارتبط مصطلح التربية بمصطلح التعليم حتى باتا توأمين متلاصقين ، فنحن بحاجة فعلية لتربية أبنائنا فكريا وتهيئتهم لاستيعاب موروثاتهم الثقافية التي تجاهلناها وتنكرنا لها ،والمتابع لأحوال التربية والتعليم على مستوى الوطن العربي عامة ومصر خاصة يشعر بفداحة الأمر، فالتلاميذ لايقبلون على تعلم لغتهم الأم بل وينفرون منها نفورا شديدا ،مم أصاب اللغة بشلل كبير، لأنها كما علمنا أدباؤنا أداة التعبير الأساسية،والوعاء الذي يحفظ لنا تراثنا وثقافتنا الخاصة بنا ، وعلينا أن نحسن استخدامها لنتمكن من التواصل بها فإذا أسأءنا هذا الاستخدام أصبحنا كالأعمى يتخبط بعصاه في غياهب الظلمات ، ولايمكن أن نحدد بدقة أين يكمن بيت القصيد ؟ لأن العملية التعليمية ترتكز على اكتمال عدة محاور يجب أن تتكاتف جميعا لتحقق المنشود منها ،وفي استطلاع للرأي عن وضع اللغة العربية الحالي في مدارسنا كانت الإجابة بالإجماع :أنه مزرٍ وبحاجة لتدارك، أما عن أسباب نفور التلاميذ من تعلم لغتهم الأم فقد تنوعت الإجابات لتتمحورجميعها حول التالي : ضعف مستوى المعلمين الجدد ، صعوبة المناهج وتكديس الكم على حساب الكيف ، الإعلام والأغاني والمواد الثقافية التي تقلل من قيمة العربية ، طرق التدريس المقترحة تدفع للنفور منها وعدم الاهتمام بتعليم مبادىء القراءة والكتابة قبل كل شيء،وهناك إجابة وحيدة متفردة ولكنها ملفتة مفادها أن الجميع مشتركون في هذه الأزمة بما فيهم الأسرة ،وهذا ما أذهب إليه أيضا؛ لأن الأسرة هي نواة المجتمع والمؤسس الحقيقي لكافة كياناته ،وعلى عاتقها تقع مسئولية تقديم أفراد أسوياء يعملون على رفعته والمحافظة على وجوده وليس العكس!
الغالبية العظمى إذن – في عينة الاستطلاع – وجهت الأنظار إلى خطورة التعامل بمناهج عقيمة – من جهتهم – أو غير مناسبة لمستويات الأجيال الحالية – وهم محقون – لأن ثمة هوة سحيقة بينهم وبين ماضيهم ، فمن الطبيعي عندما نبدأ بتعليمه أن نبدأ بما هو سهل وهين حتى إذا ما اطمأننا أضفنا لهم تدريجيا من ثقافتهم الأم ، ولكن هل سيستجيبون لتعلمها وفهمها والتعايش مع محتوياتها؟ لا اعتقد . لأن المسألة لاتتوقف عند تخفيف المناهج أو تيسير المحتوى المعرفي ، إننا بحاجة ماسة إلى تعاضد جهات متعددة – كما أشرت سابقا – لحل الأزمة ولابد أن نبدأ بأساس كل شىء –من جهتي – وهو الاسرة ؛ إذ لابد من توافر الثقافة الواعية لقيمة الموروث لدى الكيان الأسري وإلا فلا طائل من المحاولة لأن فاقد الشىء لايعطيه ، وهنا يأتي دور القيادات المجتمعية والمفكرين والأدباء لينظموا ندوات توعوية للآباء والأمهات لتوعيتهم ،وعلى وسائل الإعلام في الدول العربية أن تنهض بدورها المسئول لبث البرامج التثقيفية لمحو (أمية قيمة اللغة )وأن تحرص على التحدث من خلال برامجها باللغة الفصيحة ،لأن الصغار إذا ما اعتادوا سماع اللغة الفصيحة منذ صغرهم لن يعانوا عند تعلمهم إياها في مراحل التعليم الأساسي ويؤكد على هذا كثير من الإجابات التي حصلت عليها عند طرحي لهذاالسؤال في الاستبيان : هل تتحدث العربية بطلاقة ؟ ولماذا؟ …فكانت نسبة من يتحدثونها بطلاقة لأنهم حصلوا على تأسيس جيد ولأنهم كانوا يتعلمون تلاوة القرآن الكريم وحفظه منذ صغرهم تتعدى الـ50% وهؤلاء جميعا من متخصصي اللغة العربية على اختلاف مناصبهم ، بينما حوالي الـ20% تتعلق بكونهم كانوا يستمعون إلى برامج الأطفال باللغة العربية الفصيحة وكذلك بعض الأفلام العربية التاريخية القديمة – وهذا يؤكد على أهمية دور الإعلام والدرما في التوجيه – أما النسبة الباقية فهم يرون أنهم لايتحدثون العربية لأنها كانت مهملة لديهم في الصغر ولأنها صعبة كما تذكر بعض الإجابات ،كما أن هناك من رفض الإجابة لأنه لم يعرف ماذا يكتب!!
وفي إجماع تام – من خلال العينة – أكد جميع المشاركين بآرائهم على أن وضع اللغة العربية الحالي في المدارس بحاجة إلى إعادة نظر ،وأنها تعاني بشدة ويجب وضع حلول فورية لتدارك الوضع قبل فوات الأوان. وأفاد متخصصو اللغة أننا بحاجة قصوى إلى تغيير أو تطوير حقيقي للمناهج وأنها لم تعد تصلح ،وعند سؤالي عن الخطوة الأولى التي يمكن اتخاذها لو كان أحد المشاركين في موقع قيادي تعليمي لحل أزمة العربية كانت الإجابات بنسبة تتعدى الـ 90% تدعو إلى ضرورة تطوير المناهج الخاوية على عروشها -على حد تعبير أحدهم – مع ضرورة جعل اللغة العربية لغة أساسية لجميع المواد في المراحل الأولى من التعليم ، بينما دعا الباقون بالإضافة إلى ما سبق إلى ضرورة تعليم اللغة العربية فقط في المرحلة التأسية الأولى ، حتى إذا ما أتقنها التلاميذ قمنا بإدخال لغة ثانية ونحن مطمئنون إلى أنها لن تفسد على أبنائنا لغتهم الأم وقدرتهم على التعبيربها،وهذه دعوة صريحة إلى العودة لجزء من نظم الماضي.
ومن جهتي كمعلم وولي أمر في ذات الوقت أعتقد أن التعليم في المراحل الأولى بحاجة إلى التركيز على تعلم مبادىءالقراءة والكتابة قبل كل شيء ، بل ويجب أن يضع القائمون على وضع المناهج شروطا تمنع من ارتقاء التلميذ أو الطالب إلى المرحلة التالية قبل أن يمر باختبار خاص بالقراءة والكتابة ، ويجب أن يصبح للتعبير دور أساسي بعدتعلم مبادىء القراءة والكتابة ، لأننا عندما نطلب منهم أن يكتبوا ما يشعرون به أو ما يلاحظونه من خلال تدريب ميداني على سبيل المثال نكون قد قمنا بأمرين غاية في الأهمية الأول : أن يعتاد أبناؤنا منذ سن مبكرة على استخدام لغتهم الأم فقط كأداة للتعبير عن كل شيء وأن نرجىء استخدام اللغة الأخرى لمرحلة تالية ، والثاني : نكون قد ساعدناهم على بناء شخصياتهم بشكل طبيعي لأن التعبير يخرج مكنوناتنا ويتيح الفرص لتشكيل الهوية الخاصة بكل منا بأدوات طبيعية (اللغة والبيئة ) خالية من عيوب الانتماء لكيان آخر،لا يعترف بنا حتى وإن تعلمنا لغته وحفظنا ثقافته التي لم نشاهدها على أرض الواقع الفعلي!!
ويلفتني جدا ما ذهبت إليه بعض الآراء البناءة التي قدمها المشاركون والتي تدعو إلى عودة نظام الكتاتيب القديم ، لأنه بالفعل كان يساعد في التحاق الطلاب بالمدارس في الماضي بعد تأسيسهم بشكل سليم ،ولو فتشنا في خلفيات أساتذتنا الكبار ومفكرينا من أبناء العصر الحديث لوجدناهم تلقوا تعليمهم الأول في الكتاتيب ، ويكفينا بفخر أن نتذكر الأستاذ العقاد الذي بلغ مرحلة عالية قلما يضارعه فيها أحد مع أنه تلقى تعليمه في الكتاب ولم يتعدى الشهادة الابتدائية في ذلك الوقت ،والتي أعتقد أنها أفضل بكثير من شهادة البكالوريوس أو الليسانس لدى أحد خريجي هذه الأيام ،لأنه بفضل التأسيس السليم استطاع أن يعلم نفسه بنفسه رغم صعوبة الإمكانات وكثرة التحديات ، ولم تتوفرلديه المعلومات هكذا كما هي متاحة اليوم أمام أعيننا ،إلا أنه استمر في طريق البحث وطلب العلم بروح المجاهد الحقيقية ، فنحن بحاجة إلى تدريس طرق حياة هذه النماذج الثرة في تاريخنا لأبنائنا ليقتدوا بهم ويحاولوا السير على غرارها أكثر من تدريس ما قاموا بكتابته .
ويوجد اليوم ما يمكن أن نسميه نواة لعودة نظام الكتاتيب الناجح بالفعل وهو ما اصطلح الناس على تسميته في زماننا هذا بـ (المركز التعليمي ) والذي يقدم خدمات تعليمية مختلفة على اختلاف المواد التي يقدمها ، فالمانع لو قام المسؤولون في الجهات المعنية بتفعيل دور هذه المراكز والإشراف عليها وجعلها البداية لتدارك مايمكن إدراكه في فترات النشاط الصيفي مثلا ،فنقدم للتاميذ الصغار مادة تأسيسة جيدة بالإضافة إلى ضرورة تحفيظ القرآن الكريم وتعلم تلاوته وتجويده .
ونقطة هامة جدا بدون توفرها لايمكن لأي من المقترحات السابقة أن يجدي نفعا ألا وهي النهوض بمستوى المعلم المعرفي ،وضرورة تأهيله تربويا بشكل عملي من خلال دورات تدريبية فعلية على كافة المستويات بدءا من المدرسة وحتى مديريات التعليم ؛ إذ أصبحنا اليوم نعيش بناء على متطلبات الأنا الخاص بكل فرد ولا نركن أبدا إلى العمل الجماعي فنتبادل الخبرات ونحسن من أدائنا التدريسي وفقا لملاحظاتنا لبعضنا البعض . فاليوم أصبح المعلم الجيد يبخل على غيره بخبراته ويحتفظ بها لنفسه ، في حين أن الجيل الجديد من المعلمين لا يفقهون الكثير عن محتواهم المعرفي ولا يعرفون كيفية توصيل المعلومة إلى التلاميذ بطريقة مبسطة ومبتكرة ومحببة لا تبعث على النفور والشعور بالملل ، وكثير من هؤلاء المعلمين انتسبوا للمهنة من باب أن المجموع والتنسيق الخاص بهم في الجامعات قذف بهم في طريق تدريس اللغة العربية ، أي أنهم ممن يقال فيه (مرغم أخاك لا بطل ) ونحن نعلم تمام العلم أن فاقد الشيء لا يعطيه ، كما أن أداءه سيأتي بنتيجه سلبية حتما على المتلقين من الناشئين . وبناء على ما سبق يجب وضع بعض القوانين الصارمة لقبول طلاب الجامعات ؛ إذ يجب تصفيتهم ليتم قبول الفئة التي تثبت جدارتها بالفعل لحمل لواء الللغة ،فهي مهمة مقدسة في نظري يجب أن توكل إلى من يستحقونها فقط ،ممن يمكنهم التعامل بتلقائية بحته مع محتواهم المعرفي ،فالمعلم القديم بشخصيته الحازمة ومادته العلمية المتمكنة لم يكن بحاجة لما يسمى الآن بمشروع( القرائية ) والذي اعتقد أنه ظهر في الوقت المناسب لا لينقذ التلاميذ ولكن من أجل إنقاذ المعلمين الجدد الذين لا يعرفون حتى الفرق بين همزة القطع وألف الوصل ، ولا حتى كيف يضبطون أواخر الكلمات …..إلخ مما يشعر بفداحة الموقف .
ومشروع (القرائية ) يقوم على التركيز على مبادىء القراءة والكتابة خصوصا ( الصوتيات ) وهذا ما كان ينميه فينا أساتذتنا في الماضي من باب البديهة الخاصة بهم والتي توارثوها وتناقلوها عن معلميهم القدامى ،وفي رأيي : فإن هذا المشروع من شأنه أن يرفع من شأن الاثنين معا التلميذ الناشىء ،والمعلم الغير كفؤ والذي هو بحاجة إلى تكثيف جهودة لرفع مستواه ومستوى تلاميذه فيما بعد،كما أن هذا المشروع الجديد بحاجة إلى تنظيم ومتابعة جادة لأن الكثير من المدارس – وبخاصة مدارس اللغات –لا تعتد به وتكتفي بتدريس بعض مبادئه نظرا لأن اللغة العربية في نظر أصحابها ليست سوى مادة إضافية ،وأن الاهتمام الأكبر لتدريس اللغات الأجنبية الأخرى!!
– العربية واللغات الأخرى
وقد يعتقد البعض أن مثل هذا البحث يحارب اللغات الأخرى ويدعو إلى عدم تدريسها أو الاستفادة من الإحاطة بها ،وهذا رأي خاطىء تماما ، لأن طلب العلم لا يعرف لغة دون لغة مادامت الوسيلة لحصولنا على المعلومة ،وكذلك هي وسيلة التواصل مع الآخر ،وهي سلاح من لا سلاح له ….نعم فالمستشرقون هم أول من نقل إلى الغرب خبايا حضارتنا العربية والإسلامية بعد أن تعلموا لغتنا وأتقنوها ،ومع هذا لا نجدهم يصرون على تدريس لغتنا في مدارسهم ولا يشترطونها كوسيلة للحصول على وظيفة ما ولم يتخلوا أبدا عن لغاتهم الأم ، فهناك فرق كبير بين أن نتعلم لغة الآخر لنستفيد مما لديه وبين أن نتعلمها لتصبح بديلا لهويتنا وكل ما لدينا من تاريخ وثقافة .
وفي الماضي برع أجدادنا – خصوصا مع بدايات العصر العباسي – في تعلم لغة الآخر ونقل محتوى العلوم والثقافة لديه ،بل وعملوا على حفظ تراث الآخر والذي لايجد مقابلا له في بعض الأحيان سوى في المخطوطات العربية كتراث اليونان العتيق المتمثل في كتابات أرسطو مثلا ،ومع هذا شهد ذات العصر أوج التقدم العلمي والثقافي والحضاري باللغة العربية الفصحى ، أي أنهم لم يتخلوا عن موروثهم الثقافي بل تمسكوا به أيما تمسكوأضافوا له وأبدعوا وأسسوا لمختلف العلوم التي يتم تدريسها إلى اليوم بفضلهم ( كاللوغاريتمات مثلا نسبة للخوارزمي )، لأنهم وقتها كانوا يدركون القيمة الحقيقية لهذا الموروث بعكسنا تماما في هذه الأيام فقد قمنا بالتأسيس للمدارس التجريبية التي تقوم على أساس أن اللغة الأجنبية هي اللغة الأولى في هذه المدارس وهذا يمهد مع الأسف الشديد للتخلي تماما عن لغتنا الأم ، بل وقام بعض المسؤولين بإلغاء المدارس التجريبية العربية التي كانت تؤدي دورا رائدا- لمسناه بصدق في أبنائنا الذين تخرجوا منها – ليتم الإحلال التام للغات الأجنبية في مقابل العربية ! بل ويقضل الكثيرون اللغة الثانية لو خيروهم بينها وبين العربية كما ورد في الاستطلاع ،لأنها من جهتهم مطلب أساسي لأسواق العمل ، بينما اختارت قلة قليلة ممن يعون خطورة الموقف الذي يفرضه عليهم الواقع أن يجمعوا بين الاثنين شريطة أن يؤسسوا أبناءهم أولا ليعرفوا لغتهم الأم ثم يعلمونهم اللغة الثانية ،وهذا ما أذهب إليه ،وهذا بالفعل ما تلقيناه في الماضي فجاءت لغتنا سليمة ،بالإضافة إلى تعلمنا للغة أخرى أو أكثر .
– مستقبل العربية …. إلى أين ؟
يرى كل من شارك في الاستطلاع أن الأمل لا يزال موجودا؛ لأن اللغة العربية هي لغة قومية وعربية وعالمية ومقدسة ، وقد تعهد المولى سبحانه بحفظها ففرض على الجميع قراءة كتابه بها ، كما أن غالبية المشاركين بآرائهم يرون أنها صالحة لكل عصر وإن كان منهم من لا يحسن استخدامها والتواصل بها أو يرى أنها لغته الأم ولكن الواقع يفرض شيئا آخر ، وهذا يقودنا إلى إدراك حقيقة هامة وهي أننا نعرف ولكن نتجاهل ، وندرك الخطأ ولانتداركه ،ونقول ولكننا لا نفعّل هذا القول ونحوله إلى واقع عملي ، لهذا فإن مستقبل العربية يتوقف على تكاتف كل الجهات المعنية في آن واحد ،ولاأقصد هنا القياديين فقط أو التعليميين فقط ، بل أقصد نفسي أولا كإنسان عربي وولي أمر ومعلم …. إلخ وبمعنى آخر علينا أن نقوم جميعا بأدوارنا ذاتيا وأن لا نحتاج إلى رقابة من أحد لتفعيل هذه الأدوار ،وبقليل من الجهد والتنظيم وتفعيل الأدوار التعليمية كل في موقعه ورفع كفاءة المعلم ، وعقد الندوات والدورات التوعوية للأسرة من جهة وللشباب من جهة أخرى من خلال مراكز الشباب الموجودة بالفعل لدينا ،يمكن أن نحقق تقدما على صعيد عودة التعامل بلغتنا الام بسلاسة ويسر ،ويجب على الدول العربية أن تمنع التعامل على صفحاتها الرسمية كبدايةبغير اللغة الأم باستخدام حروفها العربية الخاصة بها ذلك أن جميع الأمم والشعوب يعتزون بلغاتهم وحضاراتهم وقد آن الأوان لنا نحن أيضا أن نطالب بذات الشيء ،فاللغة هي وجدان الشعوب ومخزن الحضارات لديها .(10)
– المراجع :
1- راجع مقالا بعنوان ( هدم اللغة العربية ) للدكتور : محمد محمد حسين
المضاف بتاريخ : 2/3/2008م – 23 /2 / 1429هــ في شبكة الألوكة اللغوية والأدبية
2- ديوان حافظ إبراهيم
ضبط وتصحيح وشرح أحمد أمين وآخرون ،المطبعة الأميرية بالقاهرة 1948م ، الطبعة الثانية
الجزء الأول ص253
3– اقرأ لشوقي في وصف الطائرة مثلا
4- لسان العرب لابن منظور ،باب الثاء (ثقف)
5- الجزء الرابع من الكتاب مليء بمثل هذه الإشارات .
6- هذه الأبيات يجفظها الكثيرون على أنها منسوبة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ،وهس بسبب حوار دار بين ثلاثة صغار ،كل منهم يفاضل نفسه على الآخر.
7- اقرأ في حماية الصين لمواقعها الإلكترونية مقالا بعنوان (الصين تشدد القيود والرقابة على استخدام الانترنت )
موقع ” تحت المجهر” الأحد تحريرا في :7/5/2017م
وكذلك : مقال بعنوان (الصين وجوجل :أزمة متعددة الأبعاد) موقع جريدة الأهرام تحريرا في : 19 /4 / 2010م
8– راجع مجموعة من المقالات الالكترونية التي تناقش ظاهرة الفرانكو ومنها :
“الفرانكوأرب” خلل ثقافي وأزمة هوية بقلم داليا حسني وهبة بشير
الأهرام اليومي : الأحد 25 /12 / 2016م
” الفرنكو آرب ” سرطان يغزو اللغة العربية بين أيدي مواطنيها بقلم :فتحية سعد
موقع راديو حريتنا : 11/ 12 /2015م
” الفرانكو آراب ” مخاطر وتحديات ،مدونات الجزيرة بتاريخ: 3/3 /2017م
وغيرها مما يشعرنا بأن هناك من انتبه إلى خطورة الظاهرة وضرورة التصدي لها للحد من مخاطرها
9– راجع مقالا بعنوان ( طاهرة الفرانكو تصيب اللغة العربية بالمسخ)
موقع جريدة الوفد الالكتروني تحريرا في : الثلاثاء 19/1 / 2016
10- راجع مقالا بعنوان (أزمة اللغة العربية ) موقع دعوة الحق ،تحريرا في :5/5/2017م

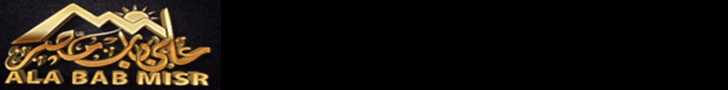

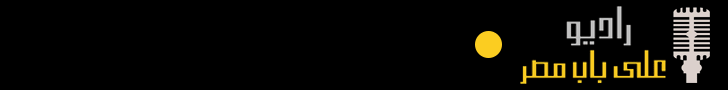
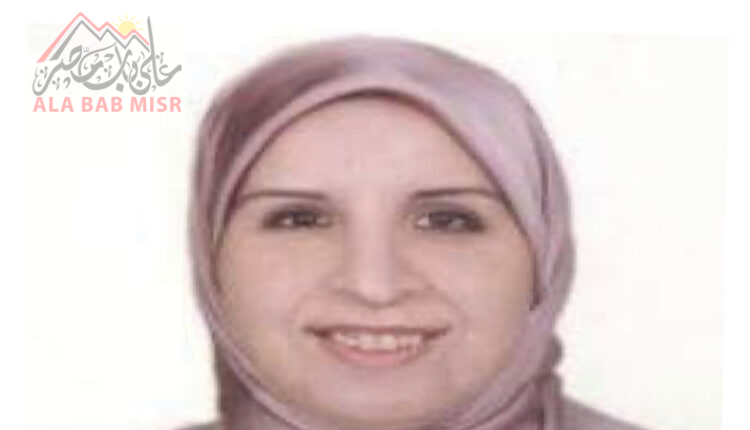
التعليقات مغلقة.