من سينقذ الأرض من أخر الزائرين “ملاحظة أولية “مخاطر التنافس التقني
يبدو إن”العربة سارت بغير ما كان يشتهي السائق! فهاهي النتائج مخيبة للآمال, وها نحن اليوم إذ نطل على الحداثة السعيدة من شرفات القرن الحادي والعشرين بعد أن أفلت انجم الفكر الماركسي والوجودي والبنيوي, تاركة الانسان الذي زعمت أنها حلت كل مشكلاته, نهبا لشتى أشكال التهديات والمخاوف والمآسي والمشكلات العويصة التي لا تلوح بالأفق القريب أي حلول سعيدة لها. وهذا ما انتهى اليه “دلسول” في كتاب “الافكار السياسية في القرن العشرين” 1994م, إذ اشار إلى إن جميع الكتابات منذ نهاية القرن الماضي حتى الربع الأخير من قرننا لم تنتجح في ايضاح الصورة المعاشة لاحوال حياة الانسان العقلية, بل كادت أن تبتسر كل ذلك بتقديم خارطة مشوهة بغايات مختلفة للحضارة التي سلكها الناس في زمانهم القديم والحديث والمعاصر ويعيد – السبب في ما أسماه بالانهيار الحضاري الراهن, الذي يكاد ينتهي بالإنسان الى مآزق إنسانية كبرى, وأزمات وجودية مستعصية لا تنتهي الى حلول سعيدة- الى طبيعة الأحداث والكوارث التي شهدها قرننا, حيث قال : “ما من شك أن تجمد الجو الروحي في وقائع فعلية على مستوى الأحداث التي انتهبت الانسان والعالم ممعنة فيهما قتلا وتمزيقا, هو الذي تسبب بالنتائج المدمرة التي نعانيها أو نخاف ان نعانيها في وقت قريب على شاشة الكون” تلك الفقرة التي تذكرتها الآن سبق وأن كتبتها في ختام رسالتي في الماجستير الوجود والماهية في فلسفة جان بول سارتر بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نسيم برقاوي. وقد حذر فلاسفة القرن الماضي من المآلات التي تسير اليها حضارة التقنية الحديثة. فهذا الوضعي المنطقي “برتراند رسل” على الرغم من شكه وتردده في تقدير اهمية الفلسفة ومضمونها, يعلن في النهاية إن هناك اسئلة عامة معينة لا يمكن الاجابة عليه في المختبر أو في الكتب المقدسة بل هي من نصيب الفلسفة كمعرفة شمولية ومن هذه الاسئلة:” هل الإنسان هو ما يبدو للفلكي, كومة صغيرة من الكربون والماء غير النقي يزحف عاجزا على كوكب صغير لا اهمية له ؟ ام هو ما يظهر لهاملت؟ هل هو – ربما كلاهما معا؟ هل هناك طريق نبيل للعيش وأخر وضيع ام أن طرق العشي كلها عابثة فحسب؟ وإذا كانت هناك طريقة نبيلة للعيش فعلا ما تقوم؟ وكيف نحققها؟ هل ينبغي أن يكون الخير ابديا لكي يستحق أن يقيم, ام انه جدير بالسعي اليه, حتى لو كان الكون يتحرك بعناد نحو الموت؟
تجدر الاشارة الى ان هذه اللغة اللاهثة, اليائسة, هي التي كانت سائدة في فضاء الفكر الأوروبي , إبان فترة ما بين الحربين حينما كان السؤال الذي أقلق اعظم مفكري وعلماء أوروبا حينذاك هو : هل يستطيع الانسان العلمي البقاء؟ وما هي الشروط التي يمكن تحقيقها إذا ما اراد البشر الاستمرار في العيش زمنا طويلا؟ هكذا لخص “برتراند رسل” المشكلة في كتابه “هل للإنسان مستقبل” 1969م إذ أوضح ” انه فيما يتعلق بالشروط الجسدية لايلوح ان ثمة سببا كافياً يمنع الحياة بما في ذلك الحياة الإنسانية أن الا تستمر ملايين السنين. وأن الخطر يأتي ليس من وسط الإنسان البيولوجي وإنما من ذاته واضاف .. لقد عاش الانسان في وضع يسوده الجهل والتوحش, فهل يستطيع الاستمرار في البقاء الآن بعد ان فقد درجة الجهل المفيدة؟)
واضح ان عصرنا الراهن وقد استبد به الخوف والذهول لم يتمكن من الاجابة على تلك الاسئلة المتعلقة بكينونة الموجود, حياته، صحته، قدراته، حريته، تاريخه، مصيره, ولم تستطع الحرية كما اريد لها أن تكون فضيلة معيار انطولوجي للحياة الكريمة على كوكب الأرض. وما هي حرية الأفراد والدولة في عالم مكبل بفيروس كورونا كوفيد-١٩ ومهدد بصارخ مجنون يحلق فوق رأسه؟
ان فكرة الحرية التي تفرض نفسها بما تمارسه من إغراء , لا ريب انها فكرة ساذجة, رغم ما تنطوي عليه من صواب بمعنى من المعاني. ان هيدجر الوجودي قد وصل الى حالة من اليأس في أواخر أيامه حيث لم يخف عجزه عن تصور أي حلول لإنقاذ الإنسانية المعاصرة إذ كتب “لا شيء غير اله ينقذنا من جحيم الوجود اللامفكر “عالم” التقنية” ومع ان خوف الإنسان الأوروبي من الحرب النووية قد استؤصلت شأفته اليوم بمعنى من المعاني, فان مصادر القلق والخوف ما تزال قائمة في مظاهر عديدة, الخوف من التلوث البيئي, الخوف من ان يؤدي هذا التمركز, للعالم في مدينة كونية واحدة, وهذا الحضور للعالم المنقول بسرعة الموجهات الكهرطيسية الى نوع من الانحباس والاستلاب للشخص الإنساني في العالم المتحول الى شبه مقصورة هاتف.. وهذا ما اسماه “فيريليو” بـ “تلوث المسافات ” وسيناريو تدمير الذات, اما المحلل النفسي “دانييل سيبوني” رغم ما يبديه من تفاؤل بالقرن الواحد والعشرين بما سيحمله من قفزة نوعية وتحول في علاقة الانسان بالعالم واعادة تأويله, بما يبعث على تجدد الدهشة لا القلق فقد انتهى إلى القول: ” إن كان هناك ثمة خطر يهدد الإنسان في المستقبل, فهو نفس الخطر الذي واجهه الإنسان الذي بني في الماضي برج بابل, أي خطر بناء صرح توتاليتاري ثم أنتظار الخلاص بعد ذلك, فالالم رفيق درب دائم للإنسان في مواجهته مع ذاته ومواجهته مع الاخرين, والحياة هي غريزة تفكيك مثلما هي غريزة بناء” لا ريب أن الدرس البليغ الذي مهر بميسمه العميق فلسفة القرن العشرين – سيما الوجودية – هو أن التفاؤل والتشاؤم موقفان لا يشرفا الفكر الأصيل ففي عالم يشوبه الخير والشر وفي شرط إنساني لاينكر فيه تأثير الحتمية كما لا تنكر فيه وثبة الحرية فمن السذاجة والخبل القول بأن التاريخ يسير نحو المستقبل لأن ذلك يعني جهل مكر التاريخ وبطشه الفاجع وطبيعته العصية, كما أن المؤقف المتشائم الذي يرى ان كل شيء اخفاق وفشل وعبث وان كل شيء يسير الى الزوال, هو تجديف يسيء الى الفرح والجمال والنبل وعظمة الانسان وطاقاته الخلاقة وهي تزدهر في العالم وتبرره وتكسب الحياة معنى وأمل حتى من وجهة نظر وضعية تفاؤلية محضة.
إذ ان الانسان ليس لديه الدربة الكافية على استعمال القسوة وعلى احتمال الشقاء فحسب, بل اثبت التاريخ الإنساني أيضا ان في مكنة الطاقة البشرية ان تبدع عالما متألقاً بالجمال والمجد الرفيع.
نعم يمكن الإنسان ذلك إذ كانت الشروط الاجتماعية والتاريخية للحياة منهجية عقلانية إنسانية وليست تلك القائمة على ايديولوجيا الربح والمصلحة المادية والاستهلاك السريع, ولكنها لا تعير الانسان وحريته وقيمه الروحية والمعنوية أي وزن يذكر, (الانسان ذو بعد واحد) إذ ان جماع عبقرية هذا النمط من العلاقات يتمثل في ابتداع الوسائل ومراكمتها بصورة جنونية دون معنى أو غاية, اللهم غاية الأداتية والاستهلاك الاني, كما عبر “هابرماز” في كتابه “العلم والتقنية كايديولوجيا”
وهذا ما أكده عالم البيولوجيا الشهير “جاك تستار”حيث يرى, إن الكرة الارضية ستتفجر تحت وطأة التلوث, فيما إذا قررت الكائنات البشرية المتزايدة في آسيا وافريقيا إن تعيش في المستوى نفسه من الحياة التي يعيشها اليوم الامريكيون, ولكن بما انه ما منطق, غير منطق القوة العارية يستطيع أن يمنع آهل الجنوب من التطلع الى تقليد أهل الشمال في مستوى حياتهم فانه لا يبقى من حل أخر سوى ان يخفف اهل الشمال من مستوى حياتهم ويتنازلون طوعا عن أنانيتهم” وهكذا تطلعت الصين إلى تقليد أمريكا في بناء محطة فضائية صينية في فضاء الكرة الأرضية المباح لمن يستطيع الوصل اليه. وهذا هو الصراع الجوهري في العالم المعاصر بين قوى الهيمنة العالمية الراهنة إذ كتب المفكر الصيني (لاوسي) على خلاف سابقيه الأمريكيين : “بالنسبة لنا نحن الصينيين فالظاهرة التي يسميها الغربيون (بالعولمة) أو (الكونية) لا تعني شيء غير الأهمية المتنامية لآسيا في التجارة العالمية وبالمحصلة تؤكد وضعها المركزي في العلاقات الدولية .فنحن نشهد اليوم عودة لآسيا ، وللصين بصفة خاصة وبنظرة عامة نجد أن تنمية الاقتصادات الآسيوية أقوى من حالة التقدم الدولي على الرغم من بعض التراجع في عام (1996) فإن المعدل السنوي لنمو الأقليم الآسيوي هو 7.4 بالمئة أي أكثر من ضعف معدل نمو المتوسط العالمي الذي يدور حول نسبة 2,7 في المئة . ومن هنا يتوقع أن الدول الآسيوية مجتمعة تتجاوز أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية معاً في السنوات العشرين القادمة
بهذه اللغة الحازمة الصارمة يستهل لاوسي مقالة المعنون (نعم للعولمة …. لا للغربنة) والمنشور في المجلة الثقافية العالمية . (ص60) ثم ما لبث أن شن هجوماً عنيفاً على الطريقة التي تمثل بها الولايات المتحدة الأمريكية العالم حيث قال: ” أن تمثيلنا للعالم مختلف جوهرياً عن النظرة الأمريكية ، ويبدو لنا أن أمريكا تنظر للعالم كمجموعة من السيادات المهذبة ، يفصلها البحر أو الجبال التي يصعب عبورها بسيادة مهذبة كسيادتهم … أما نحن الصينيون على العكس الأمريكيون ، نعتقد أن العالم سهل كبير تحارب أمريكا لفرض تفوقها عليهِ ، وهي في فرضها لهذا التفوق تسعى لسلب الآخرين منه ، ويشير إلى طبيعة تلك الاختلافات الجوهرية بين الثقافة الصينية وبين الثقافة الأمريكية و فيما يخص الدولة والفرد والمجتمع والحرية والعدالة …
ففحين أنه في الفكر الغربي تعمل الدولة على حماية حقوق الفرد في الحياة والحرية والملكية ، فبالنسبة لنا نحن أحفاد كونفوشيوس يبدو مفهوماً كهذا مدعاه للدهشة ناهيك عن كونه غير قابل للإدراك .
والفرد في الصين يعد دائماً جزا من مجموع ، وتعد المصلحة الفردية تابعة للمصلحة الاجتماعية. واضح أن (لاوسي) لا يعبر عن وجهة نظر مجردة ، بل يكشف عن حقيقة فرق قائم بالفعل ، وحينما تتحدث الصين ينبغي للعالم أن ينصت ، وينبغي على أمريكا بالذات أن ترهف السمع ، فالصين لا ترى في العولمة هيمنة النمط الأمريكي ، بل ترى فيها تعزيز قوة الصين وآسيا على الصعيد العالمي ، هنا تدخل العولمة محك المواجهة الحقيقية وتواجه عثرات يستحيل تجاوزها أبداً في المستقبل القريب .وفي خاتمة خطابه يؤكد (لاوسي) لو أن العولمة لها مضمون (جيوبوليتكي) كوني فأن عليها أن تقوم بالضبط على ما يأتي( فتح الصين على العالم ، والعالم على الصين ، وأي شيء خلاف ذلك سنكون مضطرين للتعامل معه كنبرة دعائية فجه ، تختفي خلفها رغبة الغرب في إخضاع بقية الكوكب.كما ينبغي على الأمريكيين أن يدافعوا على المصالح التجارية بشكل صريح بدلاً من الأختباء وراء ستار من الدخان الأخلاقي المستعار في حديثهم عن الديمقراطية ، وحقوق الإنسان ” ربما وصلت الرسالة الصينة إلى الإدارة الأمريكية متأخرة وهذا ما تشي عنه كلمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن البارحة في إجابته ماذا بوسع أمريكا فعله في مواجة خطر الصاروخ الصيني المنفلت من عقاله؟ إذ قال: ” إنه لا توجد خطة في الوقت الحالي لدى بلاده لإسقاط بقايا صاروخ صيني تائه من المتوقع أن يدخل مرة أخرى الغلاف الجوي نهاية هذا الأسبوع واضاف بلغة شبه ساخرة من خيبة التقنية الصينة أن على من يريد الصعود إلى الفضاء أن يتأكد من سلامة ادواته وقدراته على السيطرة عليها” هكذا إذن دخلنا قرن الاختيارات الصعبة بالنسبة لأهل الشمال والجنوب فالكوكب الأرضي صار لأول مرة في تاريخ الكون في مهب العاصفة. وذلك هو ما يبقي باب الأمل مفتوحا فالانسان مسير لا بظروفه وحدها بل كذلك بوعيه, والقرن الحادي والعشرين سيكون قرن الوعي العقلاني الإنساني أو لن يكون!
والحال كذلك فان الاخطار التي حذر منها فلاسفة القرن الماضي ما تزال قائمة اليوم؛ اخطار الاستلاب والتشيؤ والتنازل عن الحرية في العالم الممتثل, وهيمنة التقنية والقيم الاستهلاكية البرجوازية التي تهدد الانسان في كل مكان , فعندما يفهم الكون على انه ببساطة مسرح الحياة البشرية وميدان تجاوز وانتصار الانسان واستقلاله واعطائه المعنى وامتلاكه, فان ذلك يعطي دفعة قوية لتلك الاتجاهات المؤسفة التي اصبحت الآن مشكلة رئيسية في حياة سكان الأرض , مشكلة التلوث البيئي والأوبئة والآثار الجانبية غير المتوقعة للثورة التقنية المتسارعة, وما شابه ذلك, بحيث اصبحت حياة الانسان مهددة بكارثة بيئية.
والواقع ان المشكلات الجديدة التي تواجه الانسان اليوم تتطلب فلسفة تقوم على اساس عريض.. فلسفة تضع في قلب اهتماماتها, بالاضافة الى الانسان الأرض أولًا والكائنات “الموجودة الاخرى الخارجية, والاهتمام بها لذاتها باعتبارها الارض والفضاء التي يعيش وسطها الانسان (الثروات الطبيعية والثورة الحيوانية والنباتية..الخ. وتلك هي القضية التي شغلت ارنولد توينبي في أيامه الأخيرة، إذ لم تكن قضية الحضارة الغربية وانهيارها فحسب، بل كان يفكر في مستقبل البشرية ومصير الإنسانية على هذا الكوكب المسكون، إذ كتب يقول “إن البشرية تأخذ بخناقها أزمة خانقة لا تقل في شرها عن الحربين العالميتين. والمستقبل مزعج. ان البشرية تستطيع ان تستمر على العيش على هذا المجال الحيوي مائتي مليون سنة أخرى، إذا لم يؤد عمل الإنسان الى تدمير المجال الحيوي، … وليس ثمة من سابق لهذه القوة التي تسلط بها الإنسان على المجال الحيوي على النحو الذي تم خلال القرنين من 1763الى1973. وفي هذه الأحوال المذهلة ثمة نبوءة واحدة يمكن ان يقدمها الواحد وهو متأكد منها ان الإنسان وهو أبن الأرض. لن يعيش بعد جريمة قتل الأم (الأرض) أن هو اقترفها فالعقاب هو القضاء على ذاته.
تلك المخاوف الكبرى هي التي شكلت مدارات الفكرة الفلسفي المعاصر
إذ ان التشاؤمية الثقافية والتشاؤمية التاريخية تتوحد في سبعينات القرن العشرين في نزعة تشاؤمية أشد خطراً هي التشاؤمية البيئية، التي أخذت تنفذ الى معظم الدوائر الأكاديمية والثقافية الاوراميريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على أساس الافتراض بان التلوث وسباق التسلح وغزو الفضاء واستغلال المصادر والتدمير المستمر للبيئة الأرضية، كلها مشكلات أوروبية ومن علامات المرحلة النهائية للغرب الحديث كما يقول أحد نشطاء حركة الأرض أولا إذ كتب: هذا هو المجتمع الصناعي يختنق أخيراً وبهدوء على كومة روثة ونفاياته… الحضارة تتغوط في التاريخ”
أن الصرخة التي أطلقها توينبي قبل وفاته محذراً من خطر التلوث البيئي الذي قد يفضي الى تدمير الإنسان والبيئة الحيوية بكل أشكال الحياة على الأرض سرعان ما تحولت إلى صيغة إيديولوجية تشاؤمية عند عدد من الدارسين أمثال (ادوارد آبي) – ناسك الصحراء- الذي كتب في عام 1988 “يأتي البشر ويذهبون، تنشأ المدن وتسقط، حضارات كاملة تظهر وتختفي، وتبقى الأرض بعد أن تتغير قليلاً… الإنسان حلم والفكر وهم… وحده الصخر هو الحقيقي, الصخر والشمس هو الذي سيبقى” كانت رؤيا نهاية العالم والنظام الأخضر الجديد، تنفذ الى صميم المؤسسة الثقافية الغربية إذ نجدها لدى عدد من النقاد مثل (لويس ممفورد) وكتابه أسطورة الآلة (وجاك ايلول) في (المجتمع التكنولوجي)، وبول ايرلش (القنبلة السكانية) 1968 الذي يردد أفكار (توينبي): “نحن القوة الكبرى الأكثر تأثيراً ونفوذا، نحن أغنى دولة في العالم، وفي الوقت نفسه نحن مجرد بلد واحد في كوكب آخذ في الانكماش… لابد من إيجاد وسائل لكي يدرك الشعب الأمريكي الخطر الداهم الذي يهدد أسلوبه في الحياة أو بالاحرى يتهدد حياته ذاتها”.
وهكذا صارت نظرية التحدي والاستجابة معكوسة إذ أن التشاؤمية التكنولوجية في حركة البيئة, قلبت العلاقة بين المجتمع والبيئة كما حددها توبيني في دراسته للتاريخ, حينما كانت البيئة تتحدى الإنسان وتستحثه لإنجاز الحضارات. الآن الإنسان هو التحدي الأخطر على البيئة والرجل الأبيض هو القادم الأخير لتدمير البوابات, والبوبات التي يدمرها هي بوبات الجنة, الكاتب (إدوارد آبي) تنبأ في كتابه “أخبار طيبة” عام 1980 بأن (الدولة الصناعية التقنية سوف تختفي من على وجه الأرض خلال خمسين عاماً, وسوف يحل محلها انتصار الحب والحياة والثورة” كان (آبي) شديد الرفض للحضارة الصناعية, ففي زيارته إلى “مانهاتن الجنوبية عام 1956 يصف المشهد المثير (فخامة باردة جامدة كالقبور: مشهد مرعب لا أنساني أقرب إلى وادي الموت والجماجم مما هو إلى موطن إنساني للسكن” بلغة توينبي انقلبت عملية التحدي والاستجابة بطناً لظهر فالمجتمع الإنساني هو الذي يمثل تهديداً للطبيعة, وأن الطبيعة بوثبتها الحيوية, هي التي تقدم الاستجابة الممكنة اليوم؛ جائحة فيروس كورونا اللامرئي و الفيضانات الأعاصير الاستوائية, ارتفاع درجة حرارة الأرض وانفلات الصواريخ عن السيطرة بدت وكأن الطبيعة تثأر لنفسها ألان من الإنسان وحضارته الصناعية. هل بلغت الحضارة العلمية نبوءة فوكو التي أكد بها النهاية الوشيكة للإنسان كما ينتهي وجه مرسوم على رمال شاطئ البحر!
وفي هذا السياق يمكن لنا أن نفهم المعاني البعيدة لحركة البيئة الراديكالية التي رفضت فكرة أن للبشر حقوقاً أعلى من حقوق أي نوع آخر من كائنات هذا الكوكب. ولما كانت الحضارة الإنسانية تفترض العكس, فأنها تشكل جريمة مستمر ضد حقوق الأرض.
حركة حقوق الأرض توصلت إلى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي ليس له جذور في الأرض… بكونه نوعاً بيولوجياً هو القادم الأخير, غير المرغوب فيه. وجوده الشاذ, في رأي بعض المنظرين, ربما يوقف التطور البيولوجي الطبيعي للأنواع ويرى (جارى شنايدر) أن التاريخ الإنساني هو تاريخ نهب وتخريب لهذا الكوكب الثمين الجميل” وترى (جودي باربي) “أن الأرض ستقوم وتنتقم وتطاردنا من فوقها”
تلك الرؤية التي صدمتني حينما قرأتها قبل عشرين عاما بدأت الآن اتفهم مقاصدها الجديرة بالقيمة والأهمية والاعتبار.
وهي رؤية نابعة من قلق حقيقي على مصير الأرض التي هي أم الحياة كلها ولا يحق لا كائنا من كان العبث بها وتسخيرها لمصالحة العابرة المدمرة. رؤية جماعة الأرض أولا أكدت أن الإنسان هذا الزائر الغريب الأخير هو الذي يستحق الموت قبل أن يدمر الكوكب، الإنسان نفسه وليس المجتمع الحديث فقط هو الذي سينقرض بهدوء في النهاية, تدميره المحموم لبيئته, نهبه الكوكب الأرضي, كل ذلك سوف ينتهي, وسوف تتوقف الثرثرة الجوفاء عن الحضارة الكلمة الأخيرة هي كلمة د.هـ. لورانس الذي كتب يقول: (نظر “بيركن” إلى الأرض في المساء وهو يفكر: حسن إذا تم تدمير البشرية….. إذا هلك جنسنا كما حدث لـ”سدوم” وبقي هذا المساء الجميل, بالأرض النيرة والأشجار الخضراء…. فأن ذلك يكفيني… فلتمض البشرية…. حان وقتها لم تعد الإنسانية تجسد ما لا يسبر غوره… الإنسانية كتابة ميتة…. دع الإنسانية تختفي بأسرع ما يمكن”
وإذا كانت التشاؤمية الاركيولوجية قد بلغت هذا الحد من التطرف واليأس, من جدوى الإنسان والحضارة, فأن تشاؤمية توينبي التاريخية والبيئية أبقت باب الأمل مفتوحاً أمام الإنسان الذي عليه أن يواجه التحدي الأصعب, إذ يرى توينبي أن الإنسان هو واحد من سكان هذا المجال الحيوي الذي يغلف الأرض. وهو واحد من هذه المخلوقات الحية التي هي أبناء الأم-الأرض. لكنه يتميز منها بأن له روحاً. وهو بذلك على اتصال مع حقيقة روحية التي هي ليست من هذا العالم. ولذا يتوجب على الإنسان أن يتجه نحوها في علاقاته وخياراته. منها المحبة ففي عصر الثورة الصناعية يجب أن يوسع نطاق المحبة البشرية بحيث تشمل جميع العناصر التي يتكون منها المجال الحيوي الحي منها الذي لا حياة فيه.
فهل تغتال الشهوة التقنية الأرض- الأم أو أن الإنسان سينقذها أنه يستطيع أن يغتالها باستعمال قوته التكنولوجية المتزايدة, والخيار الآخر هو أن الإنسان يستطيع إنقاذها بالتغلب على الطموح العدواني الانتحاري هذا هو السؤال الملح الآن؟

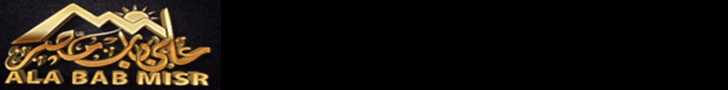

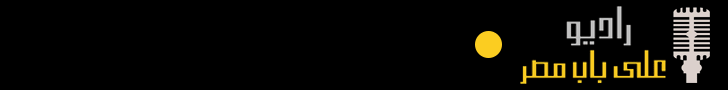

التعليقات مغلقة.