أصداء الظلال بقلم مهاب حسين مصطفى
لا أستطيع التكهن بعددهم، لكني أكاد أن أجزم بأنهم لايقلون عن أربعة أو خمسة!.
أشعر بثقل خطاهم، لفح أنفاسهم الحرّة.. فلا أملك سوى الإختباء!.
قلبت خزانة رأسي، ونقبّت في حوادث الماضي، بلا جدوى.
أخبرني بواب المنزل بأنهم يبيتون أسفل مصباح الشارع المطفأ طوال الليل، حتى يهل الصباح.
وعندما عنفته لتقاعسه عن توبيخهم وطردهم، رد في خشونة:
- افعلها أنت؟.
وأخذت أخمن..
هل هم أعوان أخي، الذي لم يتوانَ عن ابلاغي استياءه من أفكاري ومعتقداتي المخالفة لنواميس حياته؟.
وقفز وعيّده في مخيلتي:
- غيّر من نفسك وإلا تركتك نهباً لهم.
فصرخت-حينذاك- في وجهه: - لن ينصلح حال هذا الماخور إلا بهدمه.
أم يكون صاحب العقار، الذي لازال يهدد بإيذائي، إن لم أتنازل عن الشقة طواعية.
وفي إحدى الصباحات الباكرة.. وأنا أتابع نشاطي الأدبي في جريدة الحقيقة، رأيت رهطاً في أخر القاعة، يتخافتون سرا ورؤوسهم متلاصقة، وحين التفتوا لي بغتة، وجب قلبي، واعترتني الدهشة، فأشرت نحوهم:
- هم.. نعم.. هم..
وانتفضت هارباً.
ولكن.. كيف اخترقوا حواجز الأمن، بإجراءاته المشددة؟.
المؤامرة أكبر من تصوري الساذج، ومن قدرتي الواهنة على التصدي لانتشارهم الدؤوب.
لفظتني حافلة إلى مقهى بالسيدة زينب. تجرعت الشاي كعادتي. أمصصت أنفاس المعسل في شراهة، وزفرت غبار الهلع والخوف.
حدجني النادل بنظرة ذات مغزى، فالتفت نحو طرف عينيه المدبب. رأيتهم يندسون في الزحام، ساعة الذروة، ثم يهلون في موجات متتابعة، يتنكرون في أردية شتى، عمال نظافة، طلبة مدارس، موظفين، باعة، عساكر مرور…
دفعت الحساب في عجالة، وترجلّت مذعوراً، أتعثر في ظلي!.
لم يبق لي مكاناً..
دقق الضابط في بتوجس، قائلاً:
- أوصافهم تنطبق على الجميع!!.
بتوسل: - نجاتي على المحك.
رد ببرود: - يتعقبونك منذ زمن، هل أذوك؟!.
- وهل أنتظر…
وهو يغلق دفتره: - عموما، سنقوم بواجبنا.
أتأمل صورة الأجداد فوق الجدار المشروخ، على بصيص ضوء متسرب من خصاص شيش النافذة المغلق.
يشرق وجه أبي، وهو يتبوأ مقعده بين أرفف مكتبته الزاخرة بعلوم الفقه والفلسفة والتاريخ والسّير، بلحيته الكثة المشذبة بعناية، محذراً:
- ياولدي.. لاعدد لهم ولاحصر، يظهرون في جدب الأزمنة، يتخفّون ويتمازجون، حتى يُأذن لهم، فيبتدأون عملهم بكل صرامة وقسوة، حتى تدين لهم أنحاء المعمورة بالولاء!.
- هل هم من أبناء جلّدتنا يا أبي؟.
أحنى رأسه في صمت. رقبت شروخ المنزل.. تزداد اتساعاً، فتحيرت: - “من سيقع أولاً، نحن أم المنزل؟”.
قال الضابط في حزم:
- لا أحد يتعقبك.
- لكن…
- استشر طبيباً، ولاضير في ذلك.
- والبلاغ؟.
- حُفظ لعدم الجدية!.
- “كل أفراد الأمن بعرباتهم وأسلحتهم وذخائرهم، الخوذات والدروع، والكمائن، كل المخبرين السريين، لن يقدروا على حمايتك، إن أردنا إصابتك بسوء!!”.
صاح بها مجذوب، فتعقبته، وهو يتسربل في جلبابه الرث، لكن سرعان مااندثر كالوهم بين عباب الخلق المتدفق.
ٱه..
رأسي يكاد ينشق نصفين.. يتجاذبان ويتقاتلان بشدة، فيتعالى في داخلي نعيق البوم والغربان.
أتناول العقاقير المهدئة، لأتعافى:
- “في الأغلب، هي خيالات تنبعث من نفس قتلها الجمود والرتابة، والفزع من كل شيء”.
هكذا شخّص الطبيب حالتي. - هل سأُشفى؟.
- الأمر مرهوناً بإرادتك.
في هذا اليوم…
لاحقوني منذ هبوطي..
بدأوا في التكاثر، كأنما يجاهرون بدعواهم. تعلقت بحافله لأصل لمقر عملي.
سرعان ما أحاطوا مكتبي، وسدوا منافذ الخروج. ملامحهم بدأت في التوحش، وطنين مخيف يصدر عنهم..
هل قد حان الوقت؟.
ناورت وهربت من سلم الطوارئ، تخمش العتمة وجهي، بان عرجي، فكدت أنكفأ!.
لُذت بالمسجد، ملجأي الأخير..
أنصت للتلاوة في خشوع، علها تمس شغاف قلبي، فأبرأ من عللي. راعني لكّنتها الغريبة، المُحرفة!.
فانتبهت..
كانوا يحتلون الصفوف الأولى، بلحاهم الكثة. لمحوني.. سرعان ما فردوا عباءاتهم القاتمة، وكادوا يطبقون علي أنفاسي، لولا أن عاجلتهم باللكز والفرار!.
-“يحاولون الايقاع بي”،
-” لكن هيهات”،
أيقنت بأن المؤامرة تتسع.. الطبيب، الضابط، حتى إمام الجامع.. الجميع بلا استثناء!.
جُبت الشوارع كالمجنون، أبحثُ عن غوث.
حتى أنهكني التجوال، فارتكنت إلى حديقة قديمة، اقتعدت أريكة، لألتقط أنفاسي اللاهثة.
أحكم الليل سدوله..
حاصرتني دوائرهم. أزيز حاد مخيف اجتاحني، ونفذ في مسامي بتؤدة وإصرار.
هيئاتهم آخذة في التحول بسرعة مخيفة، وأسرابهم لاتكف عن التتابع.
أدركت بأني هالك لا محالة.
غمرني فيض جارف، كأنه نور ونار معاً.. وشيشٌ طغى على حواسي، شوش أفكاري، فمزقت هوياتي كلها، وتلوت وراءهم في خشوع، تراتيلاً لا أفقهها.. حتى غلبني النعاس..
لم أدر كم مضى من الوقت؟.
منذ أن رحلوا…
لكني.. للآن، لازلتُ أردد القسم!.
تمت

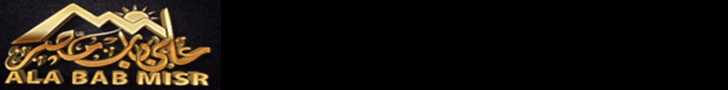

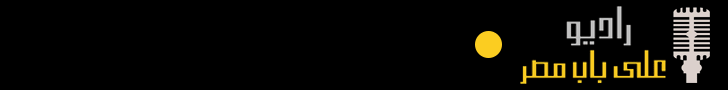

التعليقات مغلقة.