اجتماع السهرة La veillée
ترجمها من الفرنسية.عاشور زكى وهبة
قصة قصيرة للأديب الفرنسي جى دى موباسان Guy de Maupassant
1
كانت قد ماتت في هدوء دون ألم كأي امرأة لا غبار عليها، ساكنةً على ظهرها في الفراش، عيناها مُغمضتان، هادئة الملامح، وكان شعرها الأبيض الطويل مُنسّقًا بعناية كما لو كانت خارجة للتو من الحمام قبل عشر دقائق من وفاتها.
كما كان المرء يحسّ من مُحَيّا الموت الشاحب بالغ الخشوع والراحة والخضوع بمدى عذوبة الروح التي كانت تسكن هذا الجسد المُسجّى على فراش الموت، وبمدى الوجود دون اضطرابات ولا قلاقل الذي كانت تحياه هذه الأم الرؤوم، وبحسن العاقبة والخاتمة دون صدمات ولا مُنغّصات لمثل هذه الحكيمة العفيفة.
يجثو بخضوع بجوار فراشها الابن القاضي صاحب المبادئ الصارمة، كما كانت الابنة (مارجريت)_ التي تُدعى في الرهبنة بالأخت (أولالي)_تبكي بحرقة وولهٍ.
كانت الفقيدة قد سلّحتهما منذ نعومة أظفارهما بأخلاق حميدة لا تلين، وعلّمتهما أصول الدين دون تهادن، وأشربتهما حبّ الواجب دون تواطؤ ولا محاباة.
أصبح الابن قاضيًّا يُلوّح دومًا بسيف القانون، وكان يضرب بيد من حديد دون رحمة ولا هوادة المُستضعَفين والعاجزين.
أمّا الابنة فقد استغرقت بالكامل في الفضيلة التي نقّتها في هذه العائلة الحازمة، فاقترنت بالرّبّ نافرةً من كلّ الرجال.
لم يكونا قد تعرّفا قط على والدهما، ولم يعرفا عنه إلا أنه كان يرهق أمّهما البائسة، دون علم بأية تفاصيل أخرى.
كانت الراهبة تُقَبّلُ بجنون يد الفقيدة المتدليّة كيدٍ عاجيّة، وهي تشبه صورة كبيرة للمسيح الراقد على الفراش.
وعلى الجانب الأخر من الجسد المُمدّد كانت اليد الثانية تبدو قابضة على غطاء السرير الموسوم بهذه الحركة الشاردة التي نُطلِقُ عليها « تجعيدة المحتضرين»، وكان الفرش محتفظًا بمثل هذه التموجات الدقيقة للنسيج كذكرى الحركات الأخيرة التي تسبق السكون الأبديّ.
أنهضتْ طرقاتٌ خفيفة على الباب الرأسين المُنتحبتين، ودخل القسُّ الذي كان يبدو عليه أنه تناول عشاءه للتوّ؛ فقد كان أحمر الوجه لاهثًا من أثر بداية عملية الهضم، وكان قد خلط بقوة قهوته بالكونياك لكي يقاومَ تعب الليالي الماضية، ونَصَبَ ليلة السهرة التي كانت تبدأ.
كان القسُّ يبدو حزينًا بمثل هذا الحزن الكهنوتي الزائف؛ لأن الموت مورد رزق له.
رسم إشارة الصليب مُقتربًا بهذه الحركة المُحتَرِفة قائلًا:
وبَعدُ يا صغيرَىَّ البائسين! لقد جئت لأساعدكما على تجاوز هذه الساعة العصيبة.
لكن الأخت (أولالي) نهضت فجأة قائلة:
شكرًا يا أبانا! نرغبُ أنا وأخي المكوث سويًّا بجانبها. إذ أن هذه هي اللحظات الأخيرة لنا لرؤيتها، ونريد أن نتلاقى ثلاثتنا كما كُنّا في السابق حينما كُنّا.. كُنّا صغارًا، وكانت أُمّ.. أُمُنَا.. البا.. البائسة…
ولم تستطع أن تُكمل جملتها من فرط انهمار الدموع من مقلتيها، ومن شدّة ضيق أنفاسها من أثر الأسى.
أذعن الكاهنُ ساكنًا مُتفكِّرًا في فراشه، فركع ورسم شارة الصليب قائلًا:
كما تريدان يا ابنَىَّ!
صلّى ثمّ نهض وخرج بهدوءٍ مُغَمْغِمًا:
لقد كانت قدّيسة.
مكثوا سويًّا المتوفاة وابناها، في حين كانت ساعة دقّاقة مخفيّة تطلق رنينها الخافت الرتيب في الظلام، وكانت روائح الحشائش والغياض اللينة تتغلغل إلى الداخل عبر النافذة مع ضوء القمر الذابل.
ولم يكن هناك من صوت قادم من القرية إلا العلامات الموسيقيّة الطائرة لنقيق الضفادع، وأحيانًا عرير حشرة ليليّة تلجُ كقذيفة مُصطدِمةً بالجدار.
خلاف ذلك كان يحيط بالفقيدة سلام مطلق وحنين سماويّ على وشك أن يُحلّقَ بروحها، ويتضوّعَ منها خارجًا ليُهدِيء الطبيعة ذاتها.
في هذه الأثناء كان القاضي ما يزال جاثيًّا بخضوع على ركبتيه، وكانت رأسه تغوص في أنسجة الفراش، وشرع يصرخ بصوت مُمزَّق ناءٍ مُنجذِب من خلال الفرش والأغطية:
أماه… أماه… أماه!
أمّا الأخت فقد انقضّت على أرضية الغرفة صادمة جبهتها العصبيّة بخشبها، وكانت تئن بتشنج مُرتجّ كمن أصابها نوبة صرع مُنتحبةً:
يسوع.. يسوع.. أماه… يا يسوع المسيح!
وكان الاثنان يزعزعهما إعصار من الالم لاهثين مُتحشرجين.
ثمّ هدأت النوبة شيئًا فشيئًا، وشرع الابن يبكي بطريقة أكثر ليونة كخمود الريح المُمطِرة التي تتبع العواصف على بحر مضطرب.
2
ثمّ بعد مدّة طويلة، نهضا ثانيّةً، وشرعا ينظران مليًّا إلى الجثة العزيزة، وكانت الذكريات.. هذه الذكريات البعيدة – بالغة العذوبة بالأمس، شديدة العذاب اليوم – تهطل من عقليهما بأدق تفاصيلها المنسيّة.. هذه التفاصيل الدقيقة الودودة المألوفة التي تبعث إلى الحياة هذه المخلوقة الفانيّة.
كانا يسترجعان ويستذكران الأحداث والكلمات والبسمات ونغمات الصوت المميزة لتلك التي لن تحدثهما فيما بعد.
كانت تتراءى لهما سعيدة وهادئة، ويتذكّران العبارات التي كانت تتفوه بها أمامهما، حتى حركة اليد الهينة التي كانت أحيانًا تقوم بها لكسر الرتابة حينما تُطلق مقولة ذات أهمية.
لقد كانا يحبانها كما لو لم يكونا يعشقانها قط، وتفهما بالقياس لخيبة أملهما كم سيفتقدانها للأبد.
لقد كانت لهما خير داعم، وأفضل مرشد طيلة شبابهما، وطوال الجانب السعيد لوجودهما الذي يتلاشى بفقدانها.
فهي التي تربطهما بالحياة.. هي الأم الحنون والبدن البديع الذي يربطهما بأسلافهما الذين لم يعدا يملكانهما. فقد أصبحا وحيدين منقطعين، ولم يعد بإمكانهما أبدًا النظر للخلف.
ثم قالت الراهبة لأخيها:
إنك تعرف كم كانت أُمُّنا تقرأ رسائلها القديمة.. إنها هنا كلّها داخل هذا الدُّرج الخاصّ بها.
هل إذا قرأناها بدورنا، هل نعيد إحياء كلّ دنياها الفانيّة هذه الليلة بالقرب منها؟!
إنها مثل طريق آلام المسيح، كالتعارف بيننا وبين والدتها، وبين أجدادنا المجهولين من خلال رسائلهم إليها، كما كانت تحدثنا عنهم دائمًا..
هل تتذكّر ذلك؟
وجدا في الدرج عشر رزم صغيرة ذات ورق أصفر، مربوطة بعناية ومرتّبة الواحدة تلو الأخرى. ألقيا على الفراش هذه البقايا التراثيّة العبقة برائحة الأم.
انتقيا إحدى الرسائل مكتوبا عليها كلمة «الأب»، فتحاها وقرآها.
لقد كانت هذه الرسائل الشعرية بالغة القدم التي يمكن العثور عليها في المكاتب العائلية العتيقة، تلك الرسائل التي نتنسّمُ فيها عبق القرن الماضي.
كانت الرسالة الأولى تبدأ ب «عزيزتي»، والتالية ب «طفلتي الصغيرة الجميلة»، ثم في غيرها «ابنتي الغالية». وفجأة شرعت الراهبة في القراءة بصوت مرتفع، وتعيد تلاوة تاريخ الفقيدة، وكل ذكرياتها العذبة الرقيقة.
وكان القاضي يضع مرفقه على الفراش مُنصتًا لأخته، وعيناه على أُمّه، وكانت السعادة تبدو على الجسد الثابت بلا حراك.
ثمّ توقّفت الأخت «أولالي» فجأة عن القراءة لتقول:
ينبغي أن نضع هذه الرسائل في مقبرتها، نصنع بها وشاحًا لها عوضًا عن الكفن، وندفنها داخل هذا المكان.
ثمّ أخذت رزمة أخرى من الرسائل لم يكن مكتوبًا عليها كلمة تكشف عن مصدرها، وبدأت قراءتها بصوت عالٍ:
« معبودتي! أعشقكِ عشقًا أفقدني صوابي. منذ الأمس أعاني مثل هالكٍ محترقٍ بذكراكِ.. أحسُّ بشفتيكِ على شفتَىَّ.. أشعرُ بعينيكِ في عينَىَّ، وجسدي يفترش جسدَكِ.. أحبكِ.. أحبكِ! لقد أصبحتُ مجنونًا بكِ.
ها هي ذراعاى مفتوحتان! ها أنا ذا ألهثُ، وقد طغت علىّ رغبة جامحة لاحتضنكِ ثانيّةً؛ إذ أن كلّ ذرة من جسمي تناديكِ، وترغبُ فيكِ، وما زال فمي يحتفظ برضاب قبلاتكِ…»
انتصب القاضي، وتوقّفت الراهبة، فانتزع منها الرسالة باحثًا عن التوقيع.. فلم يجد شيئًا أسفل هذه الكلمات إلا «الذي يعشقكِ» يليه الاسم «هنري».
لقد كان والدهما يُدعى «رينيه»، إنها لم تكن منه إذن!
عندئذ فتّشَ الابن بيدٍ مُتعجّلةٍ داخل رزمة الرسائل، ووجد واحدة قرأ منها:
« لم أعد قادرًا على الاستغناء عن أحضانكِ».
وقف القاضي عابسًا كحاله في دار القضاء، وتطلّعَ إلى الفقيدة الباردة، وقفت الراهبة كتمثال، وبقية من دموع لم تزل في جانب عينيها، تنظر مليّا إلى أخيها ترتقبه.
حينئذٍ عبرَ الغرفة بخطًى وئيدة حتى وصل إلى النافذة، وبنظر شارد أخذ يفكر في ظلمة الليل.
حينما عاد كانت عينا أخته الأخت « أولالي» قد جفّتا، وما زالت تقفُ بجوار الفراش خافضةً رأسها.
اقترب القاضي وحشرَ بحميّة الرسائل التي كان يعيدُ قذفها دون نظام داخل الدرج، ثمّ أغلقَ ستائر الفراش.
وحينما طلع الصباح جاعلًا ضوء الشموع الساهرة على المنضدة شاحبًا، غادر الابن ببطءٍ مقعده، ودون أن يلتفت مرّةً واحدةً إلى الأمّ التي فصلها عنهما بالستائر مذمومةً مُدانةً قال بتمهّلٍ:
هيَّا لنخرجَ الآن يا أختي!
تمّت الترجمة بعون الله وتوفيقه
الخميس 2023/8/23

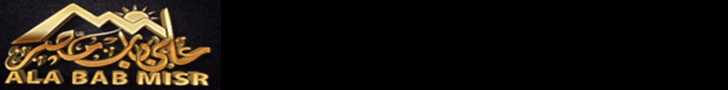

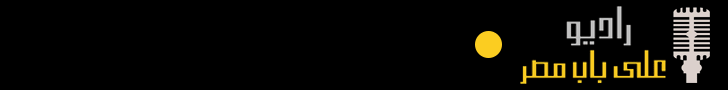

التعليقات مغلقة.